في زمن "الجمهورية العربية المتحدة" (الوحدة بين مصر وسوريا)، قرر الشاب "البعثي" اللجوء إلى لبنان، مستأنفاً بعثيته من غير قمع ولا مطاردة، مكتسباً العيش بأمان. وفي مدينة مثل بيروت أواخر الخمسينات، راح الشاب السوري والعروبي يمارس عمله ما بين الصحافة والتدريس، ويمضي يومياته في مناخات ثقافية مزدهرة بالسجالات الفكرية والأيديولوجية على أرصفة مقاهيها وفي منتدياتها وأمسياتها.
وعلى الرغم من عدم انتباهه للتناقض بين إيمانه العروبي وضديته في الوقت نفسه لـ"إنجاز" العروبة الأهم في القرن العشرين، أي الوحدة السورية – المصرية، وتفضيله للإقامة ولنمط الحياة في بلد كان بأدبيات البعث والناصرية عميلاً للاستعمار ومستلباً من الغرب وبؤرة للجواسيس ومركزاً للتآمر على الأمة وكياناً مصطنعاً.. إلخ، فقد انتبه أن "الحرية" الشخصية كما الحريات العامة، كانت عاملاً حاسماً في هجرة بلده، وتفضيله لبنان مكاناً يحلو فيه العيش و"النضال" في آن معاً.
مع عودة البعث إلى السلطة، عام 1963، استعاد الشاب حقه ببلده، بالذهاب إليه من دون خوف، واسترجع حماسته الحزبية. لكن، ما حققه في بيروت من تأسيس أسرة وسيرة مهنية ووظيفية ومكانة اجتماعية، جعله منتمياً إليها من دون القدرة على هجرها والانتقال إلى دمشق. كانت تلك فترة شعورٍ تملَّكه برحابة وجوده بلا عائق في دولتين ومدينتين.
أفضت تجربته البيروتية إلى انحيازه ليسار البعث، في لحظة صراع الأجنحة داخل الحزب. صراع عنيف انعكس اضطراباً مستمراً في سوريا، ما شجعه أكثر على البقاء في بيروت، إلى حين لحظة انقلاب عام 1968، وغلبة الجناح اليساري من البعث واستلامه للحكم. إذ اندفع صاحبنا للانخراط في مؤسسات السلطة الجديدة والتعاون معها. وذهبت به الحماسة حين اقترن هذا التحول السياسي في سوريا بتبني النظام الجديد لـ"المقاومة الفلسطينية" واحتضانها وتسليحها، فتطوع مفوضاً سياسياً في قوات "الصاعقة" التي تقاتل هناك عند مثلث الحدود السورية – الفلسطينية – اللبنانية، وبالتحديد في منطقة العرقوب اللبنانية على سفوح جبل الشيخ.
ذات ليلة باردة من تشرين الثاني عام 1970، وقع انقلاب "الحركة التصحيحية" بقيادة حافظ الأسد. وانتهت في لحظتها حقبة "بعث اليسار المغامر". وخلال أيام سيتم استدعاء هذا المفوض السياسي "الفدائي" إلى دمشق، ويوضع في الزنزانة. في الاعتقال سيكون لديه متسع من الوقت للتفكير في التناقض بين إيمانه بـ"حرية، وحدة، اشتراكية" و"الأمة العربية الواحدة" من جهة، والرغبة الحارقة في العودة إلى ذاك الكيان المصطنع المسمى لبنان، بوصفه على الأقل حضن الأسرة الدافئ، والشعور بالأمان والطمأنينة.
كان "العرض الذي لا يمكن رفضه" واحداً من خيارين، إما رئاسة تحرير صحيفة الثورة أو التعفن في الزنزانة
بسبب بعثيته العتيقة، سيمنحه حافظ الأسد، عرضاً سوريالياً في ظاهره، لكنه يجسد العقلية التي ستظل حاكمة لسوريا حتى اليوم. كان "العرض الذي لا يمكن رفضه" واحداً من خيارين، إما رئاسة تحرير صحيفة الثورة أو التعفن في الزنزانة. ولأن جوابه كان أنه سيستقيل من السياسة والحزب ليعود إلى بيته البيروتي، عاد إلى المعتقل. هناك ستصله معلومة من صديقه الحزبي الذي بات وزيراً للداخلية: سيقتلونك في الزنزانة ويأخذون جثتك إلى "العرقوب"، ثم من هناك يحملون جثمانك "شهيداً من أجل فلسطين" قضى في مواجهة العدو الصهيوني، وينظمون لك أبهى جنازة استعراضية في بيروت.
ساعده الوزير الصديق في الخروج من المعتقل والهروب إلى بيروت في اللحظة الأخيرة.
بالطبع، لم يتزعزع إيمانه "البعثي" – اليساري، ولم يشكك بعد تجربته المريرة مع "الحركة التصحيحية" في صواب القضية والشعار والعقيدة، فالتحق بصفوف منظمة التحرير الفلسطينية، مثقفاً وصحافياً ومناضلاً متمرساً في العمل التنظيمي والسياسي داخل دوائر نخبة القيادات الفلسطينية. طبعاً، بالإضافة إلى معايشته وتمتعه بالواقع المتجسد في الحياة اللبنانية الصاخبة والليبرالية الطابع والكوزموبوليتية آنذاك، من دون ترجمة هذه المعايشة وهذا التمتع إلى معنى سياسي أو إلى سؤال سياسي بالأحرى.
في العام 1976، دخل جيش حافظ الأسد إلى لبنان بعد معارك ضارية مع منظمة التحرير الفلسطينية و"الحركة الوطنية" اللبنانية. فاضطر صاحبنا إلى الفرار من أمام طلائع المخابرات السورية الداخلة إلى بيروت، متوجهاً إلى بغداد، قانعاً نفسه أن حزب البعث "الأصلي" هو هناك في العراق.
وبداهة، كان ترحيب نظام حسن البكر و"نائبه" صدام حسين بـ"الرفيق السوري المنشق". وكانت الحفاوة به والتقدير البالغ، وتأمين الإقامة اللائقة، ومُنح وظيفة مرموقة كمدير لإذاعة مخصصة لسوريا ومعارضة بشدة للأسد. إذاعة لا تتوقف عن مهاجمة البعث المنحرف الحاكم في دمشق. ولم تنقضِ سنة على إقامته البغدادية، حتى سها في مسامراته وسهراته (ظاناً نفسه في بيروت) وراح في أحاديثه يقول ما يجول في خاطره بكل أريحية وطمأنينة. وكانت كلفة هذا السهو في اليوم التالي، أن زارته مفرزة من المخابرات العراقية وجرته إلى "التحقيق". وكاد أن يُرمى في الزنزانة لولا وساطات من أعلى القيادات كصديقه طارق عزيز وآخرين.
فيما بعد سيروي لي واحدة من أغرب المفارقات: "في دمشق كنت بعثياً سجيناً بالزنزانة رقم 5، وفي بغداد كنت بعثياً سجيناً في الزنزانة رقم 5 أيضاً. هذا ما أقنعني أن "البعث" هو نفسه أينما كان".
سينتهز في أواخر العام 1977 أجواء المصالحة بين الأسد وعرفات، ليرتب تسلله خلسة من بغداد عبر تركيا واليونان ليعود إلى بيروت، بضمانة منظمة التحرير الفلسطينية وحمايتها. لكن مكوثه في بيروت بحقبة الفوضى المسلحة ستتشابك فيها امتيازات حرية التعبير مع انعدام الأمن العام. وسيرى ما اقترفته العروبة وحركاتها وتنظيماتها القومية واليسارية بهذه المدينة. وسيبدأ حينها بالابتعاد عن العمل السياسي والاكتفاء بممارسة مهنته الصحافية.
عام 1980، سيتلقى بعد خطوات قليلة من خروجه من منزل رصاصة في الرأس... وينجو بإعجوبة من الموت، بعد رحلة علاج واستشفاء في فرنسا.
بعد الاجتياح الإسرائيلي، سيرافق القيادة الفلسطينية إلى تونس، تاركاً أسرته في بيروت، قبل أن تبدأ منظمة التحرير بإنشاء مؤسسات إعلامية في قبرص، التي سيأتي إليها متحمساً في أواسط الثمانينات، لقربها من لبنان ومن عائلته.
هناك على الشواطئ القبرصية، بدأت شيخوخته ومراجعته الهادئة للسيرة وللأفكار والسياسة. وبدأ ممارسة "تقاعده" من النضال والأحزاب
هناك على الشواطئ القبرصية، بدأت شيخوخته ومراجعته الهادئة للسيرة وللأفكار والسياسة. وبدأ ممارسة "تقاعده" من النضال والأحزاب، مشدوداً لفكرة الحياة الطبيعية في بلد طبيعي. وسيعمل على ترتيب عودته إلى منزله البيروتي في لحظة انتهاء الحرب عام 1990.. باعثاً عبر معارفه وأصدقائه إلى سلطة الأمر الواقع في لبنان (المخابرات السورية) برغبته في تطبيع حاله كرجل لا شأن له بالسياسة ولا بالبعث ولا بأي نشاط "مزعج"، وتلقى تطمينات كافية لعودته.
بُعيد استقراره في منزله، سأتعرف عليه، حين قال لي بحسرة تساوي عمراً كاملاً تلك الجملة: "لقد فكرنا بكل شيء.. إلا بتفصيل صغير هو الديموقراطية".
بعد أشهر قليلة، سيزوره في بيته ضابط من المخابرات السورية المقيمين في مقرهم الشهير ببيروت، "البوريفاج"، طالباً منه رد الزيارة في ذاك المقر. وهناك سيكون فنجان القهوة بطعم الخوف والرعب، رغم حسن الضيافة والتهذيب. أدرك أنهم يبلغونه أنه تحت مراقبتهم وسلطتهم.. ومزاجهم. وكان حديثهم خليطاً من توقير "بعثيته العريقة" وتخوين سيرته الانشقاقية. وأدرك أن عليه كي يبقى في لبنان أولاً، وكي يزور بلده الأم، سوريا، ولقاء ما تبقى فيها من عائلته وأخوته، أن يمر إلى عنجر، مقر قائد المخابرات السورية في لبنان غازي كنعان، كنوع من تقديم براءة الذمة.
في عنجر، كان الاستقبال المهذب: "أنت استاذنا.. سوريا بلدك". بدت هذه الجملة التي رددوها عليها مراراً، وكأنها جواز سفر إلى دمشق، التي سيذهب إليها بشوق عميق وحار. ينام هناك ليلته الأولى في بيت قريبه. ثم ستأتي إليه مفرزة المخابرات وتعتقله، ليدور من فرع مخابراتي إلى آخر، طوال 40 يوماً من التحقيقات والنوم (أو بالأحرى ما يشبه النوم) في زنزانات البرد تحت الأرض، حيث لا يتوقف صراخ التعذيب والمشاهد الجهنمية للمعذبين، وحيث الهواء المعدوم، المختنق بأشنع الروائح..
عندما عاد مفرجاً عنه، كان قد شاخ عشرة أعوام دفعة واحدة. نظرات سائغة وصمت كئيب وسهو في الفراغ ودمعات فجائية محرجة، ناظراً إلى حفيده الوليد بأسى لا حدود له. بعد أسبوع سيتدهور صحياً ويكتشف أنه بات مريضاً في القلب. وشيئاً شيئاً سينطفئ حتى الموت.
تلك سيرة مختصرة لا لفرد، لكن لأجيال ابتلعها الوحش الذي صنعوه سهواً وغفلة عن ذاك "التفصيل الصغير.. المسمى ديموقراطية".


 حكومة سعد الحريري لإنقاذ حزب الله أولاً
حكومة سعد الحريري لإنقاذ حزب الله أولاً حرائق لبنان وسوريا.. أو "صناعة" الكوارث
حرائق لبنان وسوريا.. أو "صناعة" الكوارث  إطلاق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية.. لا عزاء لحزب الله
إطلاق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية.. لا عزاء لحزب الله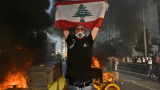 "جهنم" لبنان لم يبدأ بعد
"جهنم" لبنان لم يبدأ بعد حزب الله منتصراً على لبنان.. وفرنسا
حزب الله منتصراً على لبنان.. وفرنسا