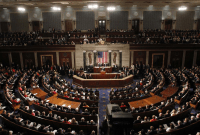بعد سنوات طويلة من المراوغة والإحساس بالذنب، قررت الدول العربية أن تكسر عزلتها على النظام السوري، حيث أعلن وزراء الخارجية العرب في مطلع هذا الشهر عودة سوريا للجامعة العربية بعد تعليق عضويتها منذ عام 2011، عندما تحول نظام بشار الأسد إلى نظام منبوذ على الصعيد الإقليمي بسبب قمعه الوحشي للانتفاضة الشعبية في سوريا، والتي حصدت أرواح أكثر من نصف مليون إنسان وشردت 13 مليوناً آخرين، بيد أن حالة العزلة انتهت اليوم.
يمثل هذا القرار ذروة الجدل الذي اعتمد أسلوب اللف والدوران بين حكومات الدول العربية حول طريقة التعامل مع المأساة السورية، إلا أن هذا القرار يحمل بين طياته مشكلات أكبر من الحلول التي يقدمها، إذ حتى المسؤولون العرب الذين يؤيدون عملية التطبيع الدبلوماسي التدريجية مع النظام السوري يشعرون بالقلق حيال الطريقة التي تفتقر إلى التنظيم والتنسيق والتي تمت بموجبها تلك العملية، كما أنهم يتوجسون من نتائجها.
سمحت عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية للأسد بالسفر إلى السعودية لحضور القمة العربية في 19 أيار، فأبدى ظهوره ملمحاً من عيوب التهافت الذي نراه اليوم على التطبيع معه، إذ بدا مرتاحاً ومنتصراً خلال زيارته، وصافح مبتسماً أهم الزعماء العرب، وشجب في خطابه الهيمنة الغربية ودعا لحماية الهوية العربية، من دون أن يتطرق للحديث عن مأساة سوريا وعن الظروف التي يقاسيها شعبه، كما لم يتحدث عن المشكلات التي تقلق الدول العربية التي استقبلته، وأهمها تحول سوريا إلى أكبر دولة مصدرة للمخدرات في المنطقة، وتوانيها عن إعادة اللاجئين، والحرية التي تتمتع بها الميليشيات المدعومة إيرانياً والعاملة في الأراضي السورية.
في الوقت الذي يرجح فيه البعض ظهور تحسن بالنسبة لإدخال المساعدات والظروف الاقتصادية في أجزاء من سوريا، لن تسرع عملية التأهيل العربية للأسد إلا بظهور نزعات خطيرة في المنطقة، إذ سيستعين النظام بالتأييد العربي له حتى يدعم استراتيجيته الوحشية بهدف ترسيخ سلطته. ثم إن التطبيع يهدد أيضاً موقف الجماعات الكردية في شمال شرقي سوريا ويمكن أن يسرع من الانسحاب الأميركي، وبالتالي عودة تنظيم الدولة إلى المنطقة.
كما يقدم التطبيع معه مبرراً للسياسيين الشعبويين في المنطقة لتصعيد تهجمهم على اللاجئين السوريين، حتى في الوقت الذي لا يقدم فيه الأسد شيئاً يذكر لتسهيل عودة اللاجئين إلى سوريا، أضف إلى ذلك تشجيع إيران وروسيا للتطبيع، بما أنه يمثل أمامهما فرصة لتستردا ما أنفقتاه لدعم الأسد وترسيخ نفوذه في قلب العالم العربي.
انقسام البيت العربي
استفاد الأسد من المشهد السياسي المنقسم في الشرق الأوسط، والذي سمح لكثير من أعدائه بأن يتوحدوا خلف استراتيجية عسكرية أو دبلوماسية جامعة ضده، إذ منذ عام 2018، أطلقت دول عديدة مبادرات لإعادة سوريا إلى الحضن العربي، إلا أن أحداً لم يلتفت لتلك الجهود نظراً للانقسامات الداخلية في البيت العربي وللمعارضة الغربية التي قوبلت بها. ولكن في مطلع هذا العام، حصدت هذه العملية زخماً كبيراً بسبب تغير سياسة السعودية. وهكذا ضمنت الانقسامات داخل العالم العربي عودة النظام السوري القريبة إلى الجامعة العربية، إذ سرعان ما تخلت الحكومات عن مواقفها المتحفظة السابقة في خضم التهافت لابتزاز خصومها في المنطقة من خلال تبني عملية إعادة تأهيل الأسد.
في عام 2018، أصبحت دولة الإمارات أول دولة عربية تعتنق فكرة إعادة تأهيل الأسد دبلوماسياً، ومما دفعها إلى اتخاذ هذا النهج تجاه ديكتاتور سوريا هو رغبتها باحتواء تركيا، واستيعاب أقرب حلفاء الأسد، أي روسيا، ووضع نهاية حاسمة لحقبة الانتفاضات الشعبية. وعلى الرغم من الدعم الذي حظيت به تلك الجهود من قبل عُمان والبحرين والعراق والجزائر بما أنها سعت للإعلان عن عودة سوريا إلى القمة العربية التي استضافتها في عام 2022، عجزت الإمارات عن حشد بقية الدول العربية خلف نهجها الذي أتى بلا شروط.
كان الأردن أيضاً من أوائل المناصرين للتقارب مع الأسد، فقد خشيت عمّان من تكرار سيناريو التدخل الروسي الوحشي بين عامي 2015 و2016 بالشمال السوري في الجنوب أيضاً، مما قد يتسبب بظهور موجة لجوء تصل إلى حدودها، كما خافت من عواقب عدم التدخل الغربي، فقد رغبت واشنطن بإنهاء دعمها للثوار السوريين في الجنوب السوري والتركيز على محاربتها لتنظيم الدولة في المنطقة الشرقية بسوريا وفي العراق. ولذلك، وافقت عمان على عودة قوات النظام للجنوب السوري بضمانة روسية على أمل أن تعمل موسكو على تغيير سلوك الأسد مع ضمان شيء من الاستقرار في المنطقة.
ولكن سرعان ما أدركت عمان ما خسرته من جراء هذه المقامرة، حيث نكث النظام بوعوده بالنسبة للمصالحة مع فصائل المعارضة المحلية، ولم تُحدث الضمانات الأمنية الروسية فرقاً كبيراً، كما أن حجم التجارة القانونية بين البلدين بقي ضئيلاً، إذ عوضاً عن ذلك، أصبح الاستقرار في الجنوب السوري شبه معدوم، كما تحول لمنطقة خصصت لتجارة المخدرات التي تدر ملايين الدولارات على النظام من الخارج، وملاذاً آمناً لتنظيم الدولة والخلايا المتطرفة، ومسرح عمليات للميليشيات المتحالفة مع إيران. ونتيجة للاتفاق المبرم مع دمشق في عام 2018، أصبح الأردن أكثر عرضة لعواقب النزاع السوري، وأشد تشكيكاً بقدرة الأسد ورغبته بالتسوية، وأشد حذراً وخوفاً من استعداء شركائه الغربيين.
بالنتيجة، وضعت عمان مخططاً لعملية دبلوماسية متعددة الأطراف تتم بالتدريج، ربطت من خلالها تحسن العلاقات مع سوريا بتنازلات مؤكدة يقدمها النظام، ولاقى هذا المخطط هوى في مصر والغرب، لكنه لم يحقق شيئاً يذكر، لأن ما أعاق الأردن عن تنفيذه هو عدم التنسيق بين الحلفاء العرب، إذ لم توافق الإمارات على ما أصر عليه الأردن بالنسبة لوضع شروط مقابل التطبيع مع الأسد، كما لم تقبل السعودية التي عارضت وقتها كل أشكال التطبيع، بأن تقوم دولة أخرى برسم سياساتها، وهذا ما سحب البساط من تحت عمان وحرمها من النفوذ الذي كان بوسعها أن تحققه، وبعدما رأى الأسد كل هذه الانقسامات بين الدول العربية، لم يعد يجد أي مبرر لأخذ المقترح الأردني على محمل الجد.
المحور الدبلوماسي السعودي
تطلب الأمر من السعودية أن تغير موقفها تماماً حتى تسير الأمور على مايرام، إذ قبل بضعة أشهر، كانت السعودية ضد التطبيع بشكل مطلق، وذلك لأن لها تاريخا مؤلما ومذلا من المساومة مع نظام الأسد، ولهذا اعتقدت بأن التطبيع مع سوريا قد يرقى إلى اعتراف بنجاح إيران، حليفة الأسد وعدوة السعودية. إذ خلال الحرب السورية، وجه الأسد إهانات متكررة للقيادة السعودية واتهمها بأنها وراء ظهور تنظيم الدولة، وهذا ما أثار حفيظة الرياض واستياءها إلى أبعد الحدود.
قد لا يكنُّ قادة السعودية أي محبة للأسد، إلا أن عوامل أخرى دفعتهم لإعادة دمج النظام السوري في المنطقة، فقد قام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإعادة رسم السياسة الخارجية للمملكة، وسعى لعزل خطط التنمية الاقتصادية الكبرى عن حالة عدم الاستقرار في المنطقة. وهذا ما دفعه لاتخاذ القرار القاضي بالحد من التنافس مع تركيا وإيران، والتقليل من حجم التدخل السعودي في مناطق النزاع، وبما أن أمله قد خاب بالولايات المتحدة فقد صار يعتبرها طرفاً كاذباً لا يمكن الوثوق به، ولهذا أخذ يعمل على الحد من التدخل الأمني الأميركي في دول الخليج. إذ بدلاً من الاعتماد على واشنطن، صار يسعى للتعاون مع الصين وروسيا في مجالات تتصل بمصلحة مشتركة، ألا وهي سياسة الطاقة.
بالنسبة لولي العهد، تعتبر سوريا مصدر قلق ورثه عن أسلافه، وحالة تصرفه عن الاهتمام بأجندته الساعية لخلق تغيير في بلده، لذا فإنه عبر انفصاله عن السياسة السعودية السابقة تجاه سوريا يدين الأجيال السابقة من القادة السعوديين الذين استثمروا في الشؤون الإقليمية كثيراً من دون أن يحققوا شيئاً. ثم إن المعارضة السورية منيت بخيبات عسكرية وأصبحت عاجزة سياسياً، فلمَ يجب عليه أن يهتم لأمرها؟ وهكذا، تحولت القمة العربية التي عقدت في 19 أيار الجاري إلى منصة تستعرض من خلالها القيادة السعودية السياسة العربية، لذا فإن عودة سوريا إلى الجامعة تعتبر ثمرة دبلوماسية باتت قطوفها دانية.
كان زلزال شباط الذي فتك بالآلاف من الناس في شمال غربي سوريا وفي تركيا فرصة لإحداث هذا التحول الدبلوماسي، إذ خلال الأزمة، قدمت الرياض لمناطق تخضع لسيطرة النظام مساعدات إنسانية ضرورية، وهذا ما قدمته السعودية كذريعة للتعامل مع الأسد مباشرة. كما لعبت عملية تخفيف العقوبات الغربية لتسهيل وصول الإغاثة الإنسانية إلى سوريا دوراً بالنسبة للرياض، كونها قدمت فرصة لقادة السعودية حتى يسلطوا الضوء على الطريق المسدود الذي وصلت إليه السياسة الغربية.
التهافت على التطبيع
ما إن قررت السعودية تطبيع علاقاتها مع الأسد، حتى حاولت الأردن ومصر ثنيها عن ذلك خلال عدة اجتماعات، ووقفت معهما الكويت في ذلك، كونها لا ترغب بإثارة حفيظة الولايات المتحدة، أهم حليف لها، إلى جانب مناهضة القوى الكويتية في الداخل للأسد، ومعارضة قطر للتطبيع معه، بما أنه مايزال شخصية منبوذة بنظرهم، إذ ترى تلك الدول بأن الأسد ينظر إلى عودته للجامعة العربية بلا شروط كنوع من التنازل الذي تقدمه له الدول العربية.
بيد أن كل هذه الاختلافات أثبتت بأنها غير قابلة للتجاوز، ويعود أهم سبب في ذلك إلى أن كل تلك الدول لديها أولويات أخرى، إذ تتعرض مصر لأزمة اقتصادية خطيرة وتعيش مرحلة من التوتر مع دول الخليج، وتواجه الأردن تحديات اقتصادية هي الأخرى، كما صار قلقها أكبر بعد التطورات التي حدثت في إسرائيل، حيث وصلت حكومة ائتلافية من اليمين المتشدد إلى السلطة، كما حدثت تطورات في البنك الدولي، إلى جانب احتمال قيام انتفاضة جديدة.
ثم إن كلاً من مصر والأردن لا تطيقان معاداة السعودية والإمارات، وليست قطر على استعداد للمخاطرة بمصالحتها مع السعودية بعد مخاصمة كل منهما للأخرى ما بين عامي 2017-2021، ولهذا تصر هي الأخرى بطريقة منطقية على عدم إجبارها على إحياء علاقاتها مع النظام السوري في حال عودته للجامعة العربية التي تعتبر مؤسسة هامشية.
إلا أن المباركة السعودية أجبرت الدول العربية -حتى الرافضة للتطبيع منها- على الوقوف صفاً واحداً في هذه القضية، إذ زعم المسؤولون السعوديون في بداية الأمر بأنه سيتبعون نهجاً حذراً ومتدرجاً، يشبه النهج الذي وضعه الأردن، إلا أن تلك العملية جرت بسرعة كبيرة، إذ سرعان ما تحول الإعلان عن فتح القنصلية السعودية في دمشق إلى إعادة للعلاقات الدبلوماسية بشكل كامل، ويشمل ذلك فتح السفارة السعودية في العاصمة السورية. ولذلك لم يشتمل البيان السعودي أو الإماراتي المتعلق بسوريا على أي اعتراف بقرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي يعتبر عملاً إطارياً لحل النزاع في سوريا.
أوروبا لن تحرك ساكناً لوقف التطبيع مع الأسد
شعرت الدول الخليجية بأن ما فعلته مبرر بعد رد الفعل الواهن الذي أبداه الغرب تجاه التطبيع مع الأسد، إذ لم يتطرق أهم المسؤولين الغربيين لذكر سوريا في أي تصريح صدر مؤخراً، ونادراً ما ترد سوريا في أي اجتماع لمسؤول غربي مع قادة الشرق الأوسط، ولذلك صاغت وزارة الخارجية الأميركية معارضتها لتلك الخطوة بعبارات ألطف حيث جاء في أحد تصريحاتها: كانت الولايات المتحدة تفضل أن تبقى سوريا منبوذة سياسياً، لكنها لم تطالب بذلك.
وهذا الرد الفاتر أكد على وجود نظرة سوداوية في المنطقة تجاه السياسة الغربية المتعلقة بسوريا، إذ بالنسبة لدول الخليج، أصبحت هذه الاستراتيجية عنواناً لفشل الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، بفرض خطه الأحمر على استخدام الأسد للسلاح الكيماوي في عام 2013 وعلى نجاح التدخل الروسي في إنقاذ النظام في عام 2016، أما ما أتى بعد ذلك من فشل دبلوماسي تلاه انسحاب جزئي للقوات الأميركية على يد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في عام 2019 فلم يزد الطين إلا بلة. ولهذا أصبحت الدول العربية اليوم تعتبر عدم الرد الأميركي على الهجمات المتصاعدة التي تشنها الميليشيات المتحالفة مع إيران في كل من العراق وسوريا نذير شؤم، إذ في حال سحبت الحكومات الغربية يدها من المشهد، فسيكون ذلك مبررا وجيها للتعامل مع نظام الأسد بحسب تفكير العرب.
لا يرجح أحد للحكومات الغربية أن تحرك ساكناً لوقف عملية إعادة التأهيل العربية للأسد، إذ لا يرغب القادة الغربيون بفعل أي شيء مع قضية استهلكت وقت أسلافهم، ولابد لها أن تشتت انتباههم عن الحرب الدائرة في أوكرانيا، كما يمكن أن تعقد العلاقات مع الأنظمة الملكية الخليجية الثرية. ناهيك عن تحول العقوبات الغربية على نظام الأسد والمعونات الإنسانية المخصصة للشعب السوري إلى بديل عن السياسة رغم ضآلتها، وخير دليل على ذلك تراجع مرتبة المبعوثين الغربيين إلى سوريا أو إلغاء هذا المنصب كلية.
دليل العمل الدبلوماسي الأسدي
لم يبد الأسد أي ندم أو رحابة صدر تجاه المسؤولين العرب الذين التقوه في دمشق أو في العواصم الخليجية، إذ برأيه لا يتعين عليه أن يندم أو أن يفكر بما ارتكبه من فظائع، بل إنه يتوقع من الدول العربية أن تعتذر عما اقترفته من ذنب عندما وقفت ضده. ولحسن حظه أن ذكريات المذابح التي ارتكبها نظامه ومنها استخدام الأسلحة الكيماوية والحصار الوحشي لمدن مثل حلب وغيرها، وقتل المدنيين دونما تمييز، قد بدأت تمحى من الذاكرة، كما أخذت الموانع الأخلاقية ضد قطع التعامل مع النظام السوري تختفي.
نجح الأسد في الانتقال من موضع الضعيف إلى موقف المنتصر، كما نجحت استراتيجيته القائمة على التريث والانتظار بصبر حتى تتغير وجهة الرياح في المنطقة والعالم، تماماً كما نجحت في السابق. ولهذا فهو يعتبر التنازلات دليل ضعف، ويسعى لإفراغ العمليات التي تقوم بها أطراف عديدة من محتواها، وينظر للعلاقات الدبلوماسية على أنها أداة تتيح له اللف والدوران إلى ما لا نهاية في سعيه لتجنب اتخاذ أي قرار.
في ذورة عزلته، وجد الأسد سلواه في التاريخ، إذ قبل 15 عاما كان يجلس منتصراً تحت قبة قصر الإيليزيه في باريس عندما حل ضيف شرف على الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وحضر معه العرض العسكري للباستيل في فرنسا، إذ في ذلك الحين كان قد خرج من فترة عزلة دبلوماسية سببها تورطه باغتيال شخصيات سياسية لبنانية، كما لم يعترض أحد على إنشائه لمفاعل نووي سري، أو على دعمه للجهاديين السنة في العراق، أو على تعامله مع إيران في تسليح حزب الله. كان خير أصدقائه وقتها أمير قطر والرئيس التركي، كما استضاف شخصيات رفيعة أميركية بينهم نانسي بيلوسي وجون كيري في دمشق، وعلى الرغم من انتقاد الملك السعودي عبد الله للأسد وحزب الله وتوجيه أصابع الاتهام لهما في قضية رفيق الحريري، قام هذا الرجل بمصالحة الأسد على أعلى المستويات، وحتى بعد ذلك، استثمر الأسد بالتهافت على دمشق دونما تنسيق أو تنظيم ليزيد مكاسبه السياسية والمالية، من دون أن يتنازل عن شيء بالمقابل.
سوريا ستبقى فقيرة ومدمرة من دون إعادة الإعمار
يسعى الأسد لتطبيق الصيغة نفسها التي خدمته كثيراً في الماضي، إذ إن اللاجئين والكبتاغون والإرهاب برأيه ما هي إلا عناصر بوسعه أن يستثمر فيها، كونها تمده بقدر ثابت من النفوذ السياسي والمالي في الوقت الذي يزوره فيه متوسلون ليطلبوا منه المساعدة في حل مشكلة هو الذي أوجدها، وسبق له أن حاول ترجمة تقرب العرب منه إلى مكاسب جيوسياسية ومالية، حيث طلب من الدول العربية هو ووزير خارجيته في اجتماعات مع نظرائهما، أن تضغط على الحكومات الغربية لتخفف العقوبات على سوريا. وبالطريقة ذاتها، استعان بالمشاركة العربية ليضغط على تركيا لتلتزم أمام الملأ بانسحابها من شمال غربي سوريا، كما طلب الأسد ووزراؤه أموالاً من شخصيات سياسية عربية، حيث ذكروا أنهم لن يتمكنوا من إعادة اللاجئين أو وقف تصدير الكبتاغون دون أموال تضخ لهم.
لا يمكن لأحد أن يفكر بأن إهدار الحكومات العربية لرأسمالها السياسي الثمين وهي تضغط على العواصم الغربية بشأن العقوبات. فجشع النظام، وصعوبة إجراء أي عمل تجاري في الداخل السوري، وحالة البلد الذي مزقته الحرب ستمنع وصول أي تمويل لإعادة الإعمار على نطاق واسع، وفي حال تقديم التمويل، سيدخل بعضه ضمن عجلة الاقتصاد السوري، إلا أن أغلبه سيجد طريقه إلى جيوب بطانة النظام أو سيستخدم لتمويل أفرع الأمن الوحشية.
بيد أن التطبيع لابد أن يخلف آثاراً عملية بطرق أخرى، إذ في البداية ستحسن الزيادة في تبادل النخب صورة سوريا في إعلام المنطقة برمتها، ويرجح للتعاون الأمني بين وكالات الاستخبارات أن يتوسع بسرعة، كما سيزيد قلق السوريين المقيمين في دول الخليج، والذين سعوا جاهدين لعدم معاداة السلطات السورية، ولهذا سيحاولون ألا يغضبوا النظام بأي شكل. وفي الوقت الذي سيسهل فيه النظام مرور المساعدات الإنسانية الخليجية، سيصر على توزيعها كيفما يشاء بدلاً من الاعتماد على معايير دولية، وسيبدأ العمل ببعض مشاريع الإنعاش المبكر، إلا أن التمويل المخصص لعملية إعادة إعمار شاملة سيبقى أمراً بعيد المنال، إذ في ظل غياب عمل إطاري شامل ومتكامل من أجل إعادة الإعمار، ستبقى سوريا مدمرة وفقيرة، وسيواصل السوريون سعيهم لطلب اللجوء في أي بلد آخر.
ثمن التهاون
قد تغري البعض فكرة الترحيب بإعادة تأهيل سوريا لكونها فكرة يمكن أن تنفذ بكلفة بسيطة ومقبولة تقوم على خفض التوتر السياسي في عموم الشرق الأوسط، فقد كثر من أصبحوا يرون بأن الحرب في سوريا حرب عصية على أي حل، أما بالنسبة لغالبية الدول الغربية، فيبدو خيار إفراغ سوريا لصالح شركائها الإقليميين خياراً جذاباً.
إلا أن عملية إعادة تأهيل الأسد عربياً تشرعن نزعات خطرة في عموم المنطقة وتسرع ظهورها، فقد جددت الميليشيات الكردية المحصورة في شمال شرقي سوريا بين تركيا والأسد من تقاربها الدبلوماسي مع النظام. أما التوجه نحو التطبيع العربي فقد زاد من المخاوف إزاء استمرار العمل بالسياسة الغربية الحالية، وفي حال تلاشت الرغبة الأميركية بإبقاء وجود عسكري لها في المنطقة، فستكون النتيجة عودة تنظيم الدولة للظهور. وفي الوقت ذاته، وتحديداً في شمال غربي سوريا، يبدو وقف إطلاق النار الذي وضع قيد التنفيذ منذ عام 2020 اتفاقاً هشاً وسط المخاوف التي ترى بأن التطبيع الإقليمي يمكن أن يدفع النظام لشن هجمات عسكرية من جديد.
بالنسبة لأكثر من خمسة ملايين لاجئ سوري في تركيا وفي لبنان والأردن، فإن التطبيع لن يقربهم قيد أنملة من العودة الآمنة لوطنهم ولبيوتهم التي استحالت إلى ركام بسبب الحرب، إلا أن ذلك سهل الأمور على السياسيين الشعبويين في تلك الدول حتى يصعدوا من حملاتهم الخطابية المعادية للأجانب والتي تستهدف اللاجئين ضمن سعيهم لإخراجهم من البلد. ثم إن التوقعات التي انتشرت في دول الجوار حول عودة أعداد كبيرة من اللاجئين قريباً لا تستوي مع الشكوك التي تدور حول الأسد ونيته بإعادة أبناء شعبه حقاً بما أنهم أصبحوا بنظره خونة ويمكن أن يتحولوا إلى تهديد له مستقبلاً، ولهذا برأيه لا يستحق هؤلاء أي إغراء بالعودة ما لم يحصل على مكافآت مقابل إعادتهم إليه.
ولفتح شهية العرب حتى يتعاملوا مع الأسد، سمح النظام السوري لأعداد ضئيلة من اللاجئين بالعودة إلى البلد، حيث قامت فروع الأمن في لبنان بطرد اللاجئين على الرغم من اعتراض وكالات الأمم المتحدة والدول الغربية المانحة، غير أن النظام يصر على فحصهم أمنياً، وكل من لا تسير أموره على ما يرام تخفيه المخابرات قسراً. وبالإضافة إلى بث الذعر، خلق النظام عقبات أخرى أمام عودة اللاجئين، شملت تجريدهم من ممتلكاتهم بشكل قانوني، وإعادة هندسة تجمعاتهم في المدن، وحرمانهم من حق العودة إلى الأماكن التي خرجوا منها.
الأسد لم يعد شريكاً وفياً لإيران
أثار الاحتضان العربي للأسد مخاوف في لبنان من تحكم سوريا بسياسته من جديد، فالمرشح الأبرز للرئاسة في لبنان، سليمان فرنجية، ما هو إلا أمير حرب سابق ضعيف على المستوى السياسي، وكل ما لديه هو تقاربه مع النظام السوري وحزب الله.
رحبت أهم حليفتين للأسد، أي إيران وروسيا بالتطبيع العربي مع سوريا، إذ تدور حسابات إيران حول استكمال هذه العملية وفقاً لشروط الأسد، من دون أن تقلق البتة حيال نفوذها في سوريا، وذلك لأنها توغلت عميقاً في البلد وبوسعها أن تعمل دون أن يعيقها أحد، باستثناء الغارات الإسرائيلية التي تستهدف وكلاءها. والأسد يعرف هو أيضاً بأنه لم يعد شريكاً وفياً لإيران بعد الآن، بصرف النظر عن مدى صعوبة هذه الشراكة في بعض الأحيان. ولذلك ليس بغريب أن يزور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي دمشق وسط الانفتاح العربي عليها في مطلع شهر أيار، لتكون تلك الزيارة الأولى من نوعها لسوريا منذ قيام الثورة.
كما رحبت روسيا بعودة النظام السوري للعالم العربي ترحيباً كبيراً، إذ سمحت هذه الخطوة لموسكو بأن تقدم نفسها كطرف منتصر أمام شعبها وكل من يشكك بقدراتها في الوقت الذي تواصل فيه حربها على أوكرانيا. كما حافظت على صورتها كقوة عظمى عالمية ورسخت شراكتها مع إيران والسعودية وغيرهما من الدول. هذا ولقد استعانت موسكو بالنظام السوري أيضاً لتستقطب تركيا بعيداً عن المحور الغربي وذلك عبر تنظيمها لاجتماعات بين أرفع المسؤولين الدبلوماسيين والعسكريين والأمنيين في كل من إيران وسوريا وتركيا. أي أن عملية التطبيع حملت معها وعوداً بتسهيل أمور موسكو. وأخيراً، تتوقع روسيا من الدول العربية أن تسهم في نشر الاستقرار في سوريا، فتخفف بذلك هذا العبء على موسكو.
إن تكرار الغرب لكذبة: "لا يوجد حل عسكري للنزاع السوري إنما حل سياسي" صار مفضوحاً، ولهذا ليس بغريب أن تترتب نتائج سياسية على الانتصارات في ساحة المعركة، لذا فإن هذه الكذبة لن تفيد إلا في تبرير التقاعس الغربي تجاه نزاع أثر على السياسة والأمن في أوروبا بشكل مباشر، وفي إعادة تأهيل الأسد على يد الدول العربية اعتراف آخر بهذا الواقع، إذ في الوقت الذي تتجادل فيه الدول الغربية حول الأهداف التي ينبغي عليها السعي لتحقيقها في أوكرانيا، تبقى سوريا شاهداً يذكرنا بالكلفة الاستراتيجية والبشرية للتهاون في هذا المضمار.
المصدر: Foreign Affairs