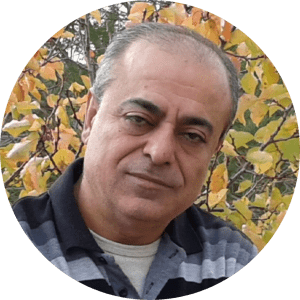حاجة الأمم إلى التفاعل والتواصل وتبادل الخبرات والمعارف، تطلبت منذ القدم اطلاعًا حثيثًا على نتاج ثقافاتها، ولا توجد طريقة أيسر للوصول إليها سوى القراءة. ومن هنا برزت أهمية الترجمة الأدبية والفكرية كوسيلة للاطلاع والتعرف إلى الثقافات والعلوم الأخرى، كما صارت تلك الترجمات رديفًا للنتاج الأصلي وأحيانًا تفوقه انتشارًا.
فترجمة أي عمل هي إعادة كتابته بروح جديدة، وانطلاقًا من هذه المقولة التي يؤيدها الأديب والمترجم السوري "عبد الكريم بدرخان"، تبرز تساؤلات عدة أهمها؛ ماذا يتطلب على المترجم عمله لضمان جودة تفريغ النص من دون طغيان أسلوبه الكتابي على أسلوب الكاتب الأصلي؟ وهنا يؤكد "بدرخان" على ضرورة التقاط أو تقمص المترجم لأسلوب ونَفَس الكاتب الأصلي وطُرُقه في الوصف والتعبير سواءً كان أسلوبه شاعريًا أو واقعيًا، إن نزح نحو التهكم أو الجد، كما يشير إلى نقطة مهمة لا ينتبه إليها بعض المترجمين، وهي تعدد الأصوات والشخصيات في العمل الروائي مثلًا، بالإضافة إلى التركيب النفسي والاجتماعي للشخوص، أي بما معناه التقاط الأنا العليا لكل شخصية وإسقاطها في النص الجديد كما هي في الأصل.
ويعد الإلمام بثقافة بيئة العمل المترجم من أهم المؤثرات على جودة الترجمة أيضًا، فالإلمام باللغة وحدها لا يكفي لضمان نقل يتسم بالجودة، وعن الفارق بين التأهل للترجمة في عالمنا العربي وبين الغرب عمومًا يقول بدرخان:
"إن معظم من يختصون باللغات في عالمنا العربي عمومًا وسوريا خصوصًا، لم يختصوا فيها عن شغف، بل أجبروا بسبب المعدلات التي لا تؤهلهم لدخول فروع أخرى، هذا بالإضافة إلى عدم خضوعهم إلى دورات أكاديمية تخصصية في الترجمة الأدبية والفكرية وإن أغلب من نجحوا في مجال الترجمة كانوا خريجي فروع أخرى لا تمت للترجمة بصلة أحيانًا، وذلك على عكس ما يحصل في الغرب، فمنذ القدم نرى المستشرقين والمستعربين يقصدون السفر إلى بلدان العالم العربي على أقل تقدير لأخذ فكرة عن طبيعة الحياة والثقافة العربية. بينما نرى المترجم العربي يقدم عشرة أعمال أحيانًا من دون أن يكون قد زار ولو لمرة واحدة بلد العمل الأصلي الذي ترجمه".
وبين الأمانة في النقل وضرورة إيصال الصيغة المبتكرة، قد يجد المترجم نفسه أمام معضلة، وقد ينزاح نحو الأمانة كما يرى المترجم "أحمد م أحمد" الذي يكمل في هذا الشأن:
"الأمانة مقدّسة في الترجمة. وغالباً ما أتخيّل أن أحداً ما يترجم كتاباتي إلى لغته، وأسأل نفسي: هل أسمح له بأن يتصرف بعبارة مركزية في النصّ بشكل يقتل المعنى أو يميِّعه أو يسيء إلى إيقاعه الداخليّ؟ ويكون جوابي السريع: لا. وبهذه الروح أتعامل مع النص الذي أترجمه، فأحاول نقل المعنى والصورة والصوت والإيقاع بأكبر قدر ممكن من الأمانة والحساسية، مع مراعاة الجاذبية والارتياح في قراءة النصّ العربي المترجَم. وفي ذلك، أجد أنني موفَّق أكثر من غيري في الحفاظ على معادلة الأمانة والجماليات في ترجمتي الشعرية والروائية على وجه الخصوص".
فالأمانة برأي "أحمد" هي الأساس والضرورة في الترجمة، وهذا برأيه ينطبق على التابوهات أيضًا، فعمل المترجم هو نقل أفكار ورؤى قد تنافي أحيانًا الأفكار التي يتبناها المترجم ومجتمعه مثل "الديانات، العادات، والسياسات"، وعلى سبيل المثال قد يمتنع مترجم عن نقل نص فيه ألفاظ تعتبر خادشة بالنسبة لمجتمعه، وقد يحاول آخر تطويع أو تخفيف حدة التابوهات المطروحة، بحيث تتناسب والمتلقي، وعن هذا يقول أحمد م أحمد:
"أنا مع الأمانة في الترجمة، بما في ذلك الحفاظ على الكلمات البذيئة جنسياً ودينياً وسياسياً، بل أُجيدُ وأستمتع بترجمتها إلى العربية، وأشعر كأنني بذلك أمزّق نقاباً أو أفكّ حزام عفّةٍ. وقد (أخذتُ راحتي) في ترجمة روايتين هما (زومبي)، جويس كارول أوتس، و(1 2 3 4)، بول أوستر، والفضل يعود للحرية التي أتاحتها لي دار المتوسط، تلك الحرية التي لا تتيحها دورٌ أخرى. وأذكر أنني لم أتدخّل في آراء أوستر المنافية للأخلاق بل وضعتُ هوامش ألفتُ فيها انتباهه إلى أن (إسرائيل) ليست الدولة التي (يتعايش) فيها الإسرائيليون والعرب تعايشاً مثالياً، وإلى أن فلسطين بلد محتَلٌّ والفلسطينيين يشكلون أكبر الجاليات في معظم بلدان العالم لأنهم مطرودون من وطنهم".
ومما سبق قد يغلب الظن على أن الترجمة ليست سوى مهنة بعيدة عن النزعات الإبداعية للإنسان، لكنها في الأساس سواءً كانت ترجمة إبداعية أم فكرية، فهي تعتمد على الرؤية المختلفة والإبداع في جميع نواحيها، وقد عُرف معظم المترجمين وخصوصًا في عالمنا العربي على أنهم أدباء ومفكرون في الأساس ويميلون نحو ترجماتهم ميلهم إلى أعمالهم الإبداعية، وعلى هذا يؤكد عبد الكريم بدرخان فيقول:
"يرتبط إنتاج الأعمال الإبداعية بالذكريات والمشاهد والوقائع التي تمر معنا في الحياة، وسواءً كان النص ذاتيًا أو أن الكاتب اخترع شخوصه، فإنه في الحالتين يكتب ما عرفه في الحياة وبالتالي يكون التصاق العمل الإبداعي بذاكرة الكاتب وبتكوينه النفسي أقرب من العمل المترجم، أما الأخير فيشكل جزءًا من حياتنا، أي أننا نعيش مع العمل المترجم لمرحلة زمنية وهذه المرحلة أيضًا هي مرحلة تفاعل فكري وتترك أثرًا في النفس وفي الذاكرة ما يجعل العمل المترجم جزءًا من ذاكرتنا وتكويننا ووعينا أيضًا. وقد تغني الترجمة عن الكتابة الإبداعية أحيانًا، وهذه مسألة ذاتية تختلف من شخص إلى آخر، فالأمر هنا يتعلق بتحقيق الذات والشعور بالرضا والإنجاز، فهنالك من يرى الاشتغال في الترجمة أو العمل الصحفي ما يحقق له الشعور بالرضا عن النفس وتحقيق الذات، وبالتوازي مع ذلك يحقق أو ينال اعتراف الآخرين عند قراءتهم أو إشادتهم لهذا العمل المترجم أو المادة الصحفية، وهنالك مبدعون آخرون قد لا يكتفون شعورياً بالترجمة، ولا يكتفون بصفة المترجم، بل يرون أن ذواتهم لا تتحقق إلا باكتساب صفة الإبداع في الرواية أو الشعر فالمسألة كما أسلفت ذاتية بحتة، كما أنها تختلف أحيانًا باختلاف المراحل العمرية للشخص. فكثيراً ما يبدأ المرء حياته بالكتابة الإبداعية ثم قد يتحول إلى الترجمة أو إلى النقد أو إلى الصحافة وينسى الكتابة الإبداعية فبالتالي من الممكن أن تكون هنالك بدائل تحل محل أخرى، فإذا كانت كتابة الشعر تحقق للمرء الشعور بالرضا لتحقيق الذات واعتراف الآخرين، يمكن بعد ذلك للعمل في الترجمة والصحافة أن تحقق له تلك الغاية أيضاً".
وأخيرًا عن حال حركة الترجمة العربية، يقول أحمد م أحمد:
من جهة، أرى أن حركة الترجمة العربية تبعث إما على الضحك أو على البكاء- ما يشبه المسخرة الثقافية: إذا قارنّا بين معدَّل قراءة العربيّ ومعدّل قراءة الأميركي، أو الألماني، أو الروسيّ، أو حتى الإسرائيلي، لشعرنا بالعار، وبأننا أمة في طريقها إلى الصحراء أو الغابة! ومن جهة أخرى، أتّهم الأنظمة العربية ومؤسساتها بالإجرام بحقّ شعوبها، ليس لأنها لم تكرّس تقاليد القراءة وتدعم صناعة الكتاب فحسب، بل لأنها لم تؤسس مراكز محترفة للترجمة، تستقبل فيها مترجمين متخصصين ومشهود لهم، فتختار أهم العناوين العالمية في الفكر والفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس، إلى جانب الشعر والرواية. كما أتّهم دور النشر بالتساهل والتسرّع في نشر الترجمات. وأما المسؤول الأكبر الذي قلّما يراه أحد: الذهنيّة العربية المتخاذلة، والاستهلاكية والاتّكالية التي عادت إلى هيمنتها على حياتنا بعد أن غابت في الخمسينيات والستينيات- العقدين الأكثر نشوةً في تاريخنا العربي. إننا نعيش أسوأ عصور انحطاطنا.