في عودة لصالون الكواكبي إلى نشاطه الثقافي، أقام مركز حرمون للدراسات خلال يومي 19 – 20 من شهر تشرين الأول الجاري، ندوة حوارية بعنوان (التنظيم السياسي والاقتصادي والاجتماعي لسوريا المستقبل)، وقد شارك في الندوة واحد وعشرون كاتباً وباحثاً، تنوّعت أوراقهم بين ما هو سياسي، وقانوني، واجتماعي، وقد غابت الأوراق الاقتصادية عن مناخ الندوة، وربما دفع هذا الغياب الملحوظ للرؤى الاقتصادية، رئيس مركز حرمون الأستاذ سمير سعيفان ، إلى الإشارة في كلمته التي اختتم بها الندوة، إلى ضرورة التعاطي مع الجانب الاقتصادي في ندوات مقبلة، باعتباره الجانب الأكثر حيويةً بالنسبة إلى حياة السوريين من جهة، ولأنه الجانب الذي تبدو فيه توافقات السوريين أكثر من اختلافاتهم من جهة أخرى.
على الرغم من تعدد عناوين الأوراق والمداخلات، فإن مسألتين اثنتين كانتا الأكثر حضوراً واستقطاباً للحوار:
1 - (مفهوم الوطنية السورية)
لا تخلو ورقة من أوراق الندوة من إشارة واضحة، إلى حالة الافتضاح الهوياتي التي باتت تشغل السوريين، وذلك بفعل التداعيات العسكرية والسياسية لحالة الاحتراب على الأرض السورية طيلة ثماني سنوات مضت، إذ إن مبلغ القمع الذي مارسه نظام الأسد على السوريين منذ أكثر من أربعة عقود، أوجد حالة من (التماسك القسري) للمجتمع، وبالطبع لا يخفي هذا التماسك أي مقوّمات أو دلائل توحي بوجود حدّ أدنى من التجانس المجتمعي الذي يعبّر عن إرادة الجماعة – الجماعات – وتطلعاتها، بل إن (التماسك القسري) لم يكن أكثر من حالة فظيعة من الإكراه تمارسها السلطة على الجميع بدون استثناء، وبالتالي كان من تداعيات حالة الإكراه تعزيز الخوف الذي يحول دون أي حراك مجتمعي يتيح للأفراد التحدّث عما يؤرقهم أو يرضيهم، ما أدّى إلى
بات من غير المريب رؤية حاملي الأيديولوجيات الكونية يعودون فجأة إلى ملاذهم الطائفي أو الإثني، أضف إلى ذلك تعدد الولاءات للمشاريع الوافدة من الخارج
شيوع السكوت ووجوب الاستسلام لخطاب السلطة الذي لم ينقطع عن تكرار مقولات وعبارات هي فاقدة لمضامينها من مثل (الوحدة الوطنية – تكاتف الجماهير وتماسكها – وحدة النسيج السكاني - اللاطائفية... إلخ). ومع انطلاقة الثورة السورية وزوال حاجز الخوف والتحرر النفسي من الروادع الكابحة، ظهرت بوضوح هشاشة العبارات والمفاهيم التي كانت توشّي خطاب السلطة طيلة عقود من الزمن، وبات جليّاً أن ما كان يظهر على أنه علائم اجتماعية إيجابية، ما هو في حقيقة الأمر سوى عبارات فرضتها مركزية القمع وبطش السلطة، أمّا واقع الحال في الجذر الاجتماعي فهو مزيد من التشظي والتنابذ والتناقض الثقافي والعقدي والاجتماعي والعرقي، ولعل ازدياد العنف بشتى أشكاله ومصادره على الأرض السورية قد أتاح المجال لظهور مجمل مظاهر الأزمة المجتمعية أفقياً وعامودياً، وأصبح من المألوف جداً أن ترى النخب الثقافية تعود بلا وجل إلى حواضنها البدائية (عشائرية – مناطقية) كما بات من غير المريب رؤية حاملي الأيديولوجيات الكونية يعودون فجأة إلى ملاذهم الطائفي أو الإثني، أضف إلى ذلك تعدد الولاءات للمشاريع الوافدة من الخارج، وعدم قدرة السوريين على إنضاج حالة وطنية جامعة ينضوي السوريون تحت ظلالها. ولعل جميع ما سبق ذكره يؤكد عمق الشروخ داخل المجتمع السوري، تلك الشروخ التي لا تتوقف أسبابها على تداعيات الحرب العسكرية فحسب، بل تعود إلى مصادرة السلطة لإرادة المجتمع السوري والحيلولة دون إنضاج العقد الاجتماعي الذي يجسد ملامح الهوية الوطنية للسوريين.
وعلى الرغم من جدّية المشهد الحواري للندوة، وكذلك على الرغم من سلامة النيّة في طرح القضايا والأفكار، فإن مجمل التصورات التي حاولت مقاربة الأزمة ظلّت رهينة المتخيَّل الإيديولوجي في غالب الأحيان، ولم تتجاوز مجمل الأفكار المطروحة التخوم الثقافية والفكرية التي وسمت أصحابها منذ وقت طويل، ففي الوقت الذي يرى فيه العلمانيون ضرورة وجوب استلهام المُعطى الحداثي في بناء المجتمع والدولة، دون الوقوف عند العوائق التي قد تفرضها قداسة الموروث بكل أصنافه، ما يعني العمل على بناء مفهوم جديد للهوية الوطنية، فإن الإسلاميين – في المقابل - يُبدون حرصاً كبيراً على حضور المرجعية الدينية كناظم ومنطلقٍ أساسي لأيّ جهد فكري في هذا الاتجاه. ولعلّ هذا المنحى المتباين من التفكير لدى الطرفين، يدفع نحو ظهور إشكالية أخرى، وهي:
2 – مسألة (التأصيل)
تتلازم عملية التفكير لدى الإسلاميين مع البحث المستمر في المرجعيات الدينية النصية عن القرينة التي توجب القَبول أو الرفض، وذلك دون النظر إلى عامل الزمن، أو المتغيرات الكونية التي تجتاح العالم، إيماناً منهم بأن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، وكذلك اعتقاداً منهم بشمولية الدين الإسلامي على كل مستجدات العالم التي لها صلة بحياة الإنسان وحاجاته، منذ بداية الخليقة حتى نهايتها، وهذا ما يرسّخ الاعتقاد لدى الإسلاميين بوجود أصل ثابت في التراث الديني (النصي والفقهي) لكل مظاهر ومقوّمات الدولة الحديثة (الديمقراطية – المواطنة – الحريات بأشكالها ...إلخ)، ومادام الأمر كذلك، فإن هذه المعطيات
يجد المرء نفسه أمام تيارين، يزعم كلّ منهما أنه يسعى بجدّية إلى تجديد منظومته الفكرية، واستنهاض مرجعياته الإيديولوجية، مواكبةً لمستجدّات العصر
يجب أن تتقيّد بأصلها وسمتها الإسلامية، ولا يجوز التعاطي معها – وَفقاً للإسلاميين – إن تجرّدت من دالّتها الإسلامية. وذلك في مقابل طرف آخر (علماني – ليبرالي) لا يرى حاجة إلى السماء في صياغة مستقبل الإنسان الدنيوي، وخياراته في تحديد نمط عيشه، وتوافقاته المجتمعية التي هي وحدَها، تُنتِج عقده الاجتماعي الذي تتقوّم عليه سياسة البلاد وشكل الدولة ودستورها.
وبناءً على هذا المشهد الثنائي المتباين من حيث التفكير والرؤية، يجد المرء نفسه أمام تيارين، يزعم كلّ منهما أنه يسعى بجدّية إلى تجديد منظومته الفكرية، واستنهاض مرجعياته الإيديولوجية، مواكبةً لمستجدّات العصر، إلّا أن جدّية هذا المسعى لدى الطرفين، تخذلها الأدوات المعرفية العقيمة التي لا يبرّر عقمها سلامة النية، والحماسة الزائدة، وردّات الفعل العاطفية التي غالباً ما كانت تنوب عن التفكير العقلاني الذي يستلهم آدمية الإنسان كما هي في الواقع، وحاجاته الجوهرية ككائن حرّ كريم.
ليس بجديد القول: إن قدرة السوريين على بناء مفهوم جديد لهويتهم الوطنية السورية تبقى مرهونةً بقدرتهم على التخلص من التفكير اليقيني أو الوثوقي والشمولي، المتناسل من رحم الإيديولوجيات التقليدية بشتى أصنافها، إلّا أن هذا المُنجَز الافتراضي لا يتأتى من قدرة الجميع على الحيازة المعرفية فحسب، بل قبل ذلك كله، يستلزم الإرادة والجرأة الأخلاقية لتحرير الذات أولاً، ثم الانطلاق نحو كل ما هو إنساني ثانيا.


 إيران الوصيّة على الأسد
إيران الوصيّة على الأسد حين يكون الإبداع ضحية الإيديولوجيا
حين يكون الإبداع ضحية الإيديولوجيا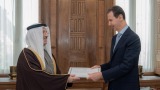 دعوة بشار الأسد إلى قمة المنامة
دعوة بشار الأسد إلى قمة المنامة اللقاء المُرتقب للجنة الدستورية مصلحة سورية أم حاجة إقليمية؟
اللقاء المُرتقب للجنة الدستورية مصلحة سورية أم حاجة إقليمية؟