أظهرت الفتوحات المعرفية والثقافية لثورات الربيع العربي، والثورة السورية على وجه الخصوص، قدرة كبيرة على كشف مجمل عورات الإيديولوجيات التقليدية، بأنساقها المختلفة، ولئن استطاعت هذه العورات الفكرية أن تتلطّى عقوداً من الزمن، خلف خطاب إعلامي تضخّه وترسّخه السلطات الحاكمة حيناً، وتسهم في ديمومته حالة من الركود الاجتماعي والاستسلام الثقافي حيناً آخر، إلّا أن شرارة الثورات التي انطلقت في أكثر من بلد عربي، أظهرت أن الوعي المحرّك للطاقات الجماهيرية الثائرة، وبخاصة جيل الشباب، قد تحرر- إلى حدّ كبير- من السلطات المعرفية التقليدية، وبدأ يستلهم قيم نضاله من سياقات حياته المعيشية من جهة، ومن إحساسه بحالة الاستلاب القيمي التي مارستها الأنظمة الاستبدادية على شعوبها من جهة أخرى، الأمر الذي دعا قطاعات واسعة من المواطنين – بعد انطلاق الثورات – إلى إعادة السؤال من جديد عن جملة من المفاهيم ( الهوياتية)، ولعل أبرزها مفهوم ( الهوية الوطنية) الذي ظل مدحوراً طيلة عقود سابقة طويلة، بفعل حالة السبات الاجتماعي والسياسي والثقافي الذي رسَّخته الإيديولوجيات المذكورة، وحواملها السلطوية.
فالكيانات الراهنة في نظر الإسلاميين والقوميين، والتي هي في واقع الحال، هذه الدول التي نعيش في أكنافها، لم تبدُ سوى دول مهترئة وهشة
إذ ْيرى القوميون أن مفهوم ( الوحدة العربية ) جاء ردّاً على واقع التجزئة الذي فرضته السياسات الاستعمارية على الوطن العربي، لذا فإن جميع الكيانات أو الأقاليم التي كانت جسداً واحداً ثم تقطّعت إلى أوصال، بفعل الإرادات الاستعمارية الغربية، هي كيانات لا تحظى بشرعيتها ( كدول قائمة بذاتها ) من جانب معظم المفكرين القوميين، بل هي كيانات تجسّد حالة راهنة أو طارئة فرضها الاستعمار، وذلك ما أُطلق عليه في الأدبيات القومية مصطلح ( الدولة القطرية)، ومنذ ذلك الحين اتسم هذا المصطلح بانطباع سلبي على الدوام، فالدولة القطرية باتت مصدر إيحاءات ذهنية ونفسية عديدة، فهي رمز للتجزئة والضعف والتخلف، بل باتت في نظر بعضهم مصدر الشرور والبلاء كافة، ولهذا فهي لا تستحق الاهتمام في بنائها وتطويرها، لأن هذا المسعى – كما يرى بعضهم – يجسد ترسيخاً لما سعى إليه الاستعمار، فهي في أفضل حالاتها ليست أكثر من حالة راهنة، يتوجب تجاوزها إلى بناء كيان قومي موحّد تجتمع فيه الأوصال ( الكيانات القطرية)، وذلك الكيان الموحد ( الدولة العربية الواحدة) هو ما يستحق الاهتمام ويوجب التطوير.
ولعلّ ما يماثل هذا التصوّر، قد لازم المشروع الإسلامي المُتَخيّل أيضاً، إذ لا يرى الإسلاميون أن طموحهم السياسي يمكن اختزاله ببناء دولة في بقعة جغرافية محددة من العالم، بل إن الدولة الإسلامية المنشودة هي التي ينضوي تحت لوائها المسلمون جميعاً، وليست التجارب الإسلامية في هذا البلد أو ذاك، إلّا حيّزاً جزئياً، لن يكتمل إلّا بانتظامه أو التحامه بالأجزاء الأخرى، التي تشكّل جميعها دولة الإسلام .
لعلّ السمة المشتركة لكلا التصوّرين السابقين هي تجاهل ما هو واقعي ومحسوس ومعاش، واستمرار التفكير فيما هو مُتخيّل، وكذلك تجاهل الحقيقة القائلة: إنّ مشروعية أي حلم، إنما هي مشروطة بسلامة حوامله الواقعية الملموسة.
(الدولة القطرية) لدى القوميين، و( والولاية الإسلامية القائمة أو المُفترضة) لدى الإسلاميين، واللتان لا تجسّدان سوى واقع مذموم، وطارئ أو مؤقت لدى الطرفين، ما هما – في حقيقة الأمر- سوى الواقع الذي ضحّى به الطرفان، امتثالاً للحلم الذي تثبت الوقائع والمنطق معاً – يوماً بعد يوم – طوباويته وعدم جدواه.
فالكيانات الراهنة في نظر الإسلاميين والقوميين، والتي هي في واقع الحال، هذه الدول التي نعيش في أكنافها، لم تبدُ سوى دول مهترئة وهشة، ومبعث هشاشتها ليس بسبب عدم توحّدها كما يوحي به خطاب الإيديولوجيات، بل بسبب افتقارها إلى مجمل النواظم القانونية والاجتماعية والأخلاقية التي تحدّد العلاقة فيما بين الأفراد بعضهم البعض، أو بين الفرد والدولة، وكذلك بسبب افتقار مواطني هذه الدول إلى الحصانة الإنسانية التي تتقوّم على الحريات بكافة أشكالها، وعلى مبدأ المواطنة والديمقراطية وسيادة القانون، هذه الحصانة هي المؤسِّس الحقيقي لمفهوم الوطنية الذي سبّبَ غيابُه بروزَ مجمل التناقضات العرقية والطائفية والسياسية التي تستنزف طاقات الشعوب، فضلاً عن أن التجارب الوحدوية الأكثر نجاحاً عبر التاريخ، هي تلك التي تتأسس على وحدة المصالح وتكامل الاقتصاد وتلبية الحاجات المجتمعية، وليست تلك التي تتأسس على خطاب إيديولوجي مبعثه الدين والثقافة واللغة وحسب.
إن درجة الوعي المتقدم التي أظهرتها الثورات الشعبية في أكثر من بلد عربي، والتي لم تجسّد مطالب معيشية يحتاج إليها المواطنون فحسب – على الرغم من أهميّة تلك المطالب – ولكنها جسّدت أيضاً حالة من الشعور بالاستلاب الوطني، وخاصة في الحراك الشعبي السوري واللبناني والعراقي، إذ ثمة حالة من السخط لدى أكثرية الشارع، مبعثها يكمن في سعي الأنظمة الحاكمة، على امتداد عقود من الزمن، إلى محاربة تبلور ولاء جمعي للوطن يتأسس على عقد اجتماعي يلبي تطلعات ومصالح المجتمع بكافة أطيافه العرقية والدينية، ويعكس قبول ورضا الجميع، وليكون هو العقد الناظم لعلاقة المواطن بالدولة، وليس مشيئة الحاكم وأهواؤه.
وجد كثير من الإسلاميين في ثورات الشباب، وخاصة في سوريا، فرصةً لاستنهاض النزوع نحو الهيمنة والاستيلاء على مفاصل الحراك الشعبي
المؤسف حقاً، أن فهم النخب السياسية المؤدلجة لصعود الوعي الشعبي الذي جسّدته الثورات الشعبية كان معكوساً، إذ يرى القوميون أن تداعي اشتعال الثورات في أكثر من بلد عربي في أوقات متقاربة دليل، بل تأكيد على صوابية رؤيتهم حول (وحدة الشعور والمصير القومي)، ولم يجدوا في هذه الثورات المتجاورة استجابة شعبية لاستحقاق تاريخي لا بدّ من مواجهته بتفكير جديد يستلهم ما هو راهن وعصري، ولا يركن إلى ما هو فائت وفاقد للفعالية، كما لم يقتنعوا بعد، بأن مفهوم ( القومية) كغيره من الأفكار، يخضع للتحولات التي تمليها الشروط التاريخية، ولا يحمل سمة الثبات والقداسة، ولئن كانت الفكرة ( القومية ) ضرورة موجبة في ظرف تاريخي ما، فيتوجب عليها – إن شاءت الاحتفاظ بقيمتها – أن تراعي الضرورات الراهنة أيضاً، ولعلّ أهمها أن النهوض بأيّ مشروع سياسي أو نهضوي، لا يمكن له النجاح إلّا بالتأسيس على الحامل الوطني الذي يجسد مصالح المواطنين وحاجاتهم، وليس تجسيداً لافتراضات رغبوية.
وفي موازاة ذلك، وجد كثير من الإسلاميين في ثورات الشباب، وخاصة في سوريا، فرصةً لاستنهاض النزوع نحو الهيمنة والاستيلاء على مفاصل الحراك الشعبي، من خلال بعض المظاهر الدينية التي برزت في أوساط الحراك السلمي، كخروج المظاهرات من المساجد، ورفع بعض الشعارات الدينية التي تعكس حالة من التديّن الفطري السائد في المجتمع، ووجدوا ذلك سبباً كافياً لاعتبار ثورة السوريين هي عودة للمطالبة بإقامة دولة الخلافة الإسلامية، بل لم يتورع قسم منهم عن الادعاء بأن ثورة آذار 2011 ، هي امتداد للمواجهة التي جرت في ثمانينيات القرن الماضي بين جماعة الإخوان المسلمين وسلطة الأسد.
ولعلّ هذا الفهم المضاد لحقيقة ثورات الربيع العربي، وكذلك السلوك السياسي الموازي لهذا الفهم، لا يجسّدان حالة من احتباس في الوعي واستمراء الغثاثة الفكرية والثقافية فحسب، بل يعزّزان نزوعاً خاذلاً لأي تطلّع تحرّري.


 إيران الوصيّة على الأسد
إيران الوصيّة على الأسد حين يكون الإبداع ضحية الإيديولوجيا
حين يكون الإبداع ضحية الإيديولوجيا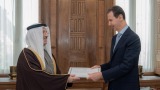 دعوة بشار الأسد إلى قمة المنامة
دعوة بشار الأسد إلى قمة المنامة اللقاء المُرتقب للجنة الدستورية مصلحة سورية أم حاجة إقليمية؟
اللقاء المُرتقب للجنة الدستورية مصلحة سورية أم حاجة إقليمية؟