عندما خرج فرانسيس فوكوياما بكتابه نهاية التاريخ والإنسان الأخير، في العام 1992، مدعياً انتصار الرأسمالية، واختزال التطور التاريخي عند حدود انتصارها. كانت الولايات المتحدة الأميركية قد أكلمت صراعها التاريخي الذي افتتحته بشكل مباشر في الحرب العالمية الأولى للسيطرة على النظام العالمي. دخول أميركا إلى الحرب العالمية الأولى، هدف لإثبات دورها كعنصر موفّر للانتصار لمن يتحالف معها. قالت لفرنسا وبريطانيا إن بقاءهما منوط بدورها، وهو ما تكرر في الحرب العالمية الثانية، التي بعدها، بدأ التمدد الأميركي في العالم يتوسع، أجبرت باريس ولندن على اللجوء إلى الجناح الأميركي، وتصدرت واشنطن مواجهة الاتحاد السوفييتي.
بسقوط الإتحاد السوفييتي، كرّس الأميركيون سيطرتهم على العالم، أكملوا إنجاز النظام العالمي الذي طمحوا إليه، ما حدا بفوكوياما، إلى كتابة "نهاية التاريخ". في الأخذ المباشر والمبسط للعبارة المكملة لعنوان الكتاب، أي "الإنسان الأخير". فهي حكماً تعني انتهاء حقبة بشرية واستيلاد حقبة أخرى، تقوم على جعل الإنسان كائناً استهلاكياً ليس للسلعة فحسب وفق شروط النظام الرأسمالي، إنما متلقياً لما يُغدق عليه من أفكار وتنميطات ثقافية واجتماعية، بـ"ثورة" دعائية سياسية، سينمائية روائية وغيرها، تهدف إلى إسقاط كل ما يتعلق بالنقد والانتقاد، أو النقد البناء وفق المصطلحات الماركسية. مقابل تكريس منطق الزبائنية الفكرية، بحيث من يتماشى مع هذه "العصرنة الفكرية" يكون تقدمياً ومن لا يتماشى مع الطبائع التي تكرسها هذه الفكرة يكون رجعياً وساقطاً في حسابات العالم الجديد.
هنا يمكن أن تنقلب جملة "الإنسان الأخير" إلى "آخرة الإنسان"، بما يمثله من قيمة فكرية قادرة على النسج والتطوير الفكري في مجالات متعددة، في مواجهة كل محاولات مكننته وفق مقتضيات السوق. والمدى الأبعد لتلك العبارة هو إسقاط كل ما يتعلق بالصراع الفكري، وجعل الصراع مادياً فقط على السلعة، التي يفترض بالإنسان الأخير أن يتماهى معها. ولا بد لإسقاط أي صراع فكري أن يؤدي إلى تتفيه المجتمعات، وهو ما تشهده أقطار العالم كلها، منذ ثلاثين سنة إلى اليوم. طبعاً لا يمكن ربط حماية الأفكار بوجود الاتحاد السوفييتي، الذي كان أيضاً أحد أكبر المساهمين في إجهاض أي فكرة أو ابتكار، وإنما الأساس هو لرمزية وجود صراع فكري.
النتاج الأولي لفشل النموذج السوفييتي، والتسيد الرأسمالي للنظام العالمي الجديد، المتخطي لكل الحدود "ثقافياً" واقتصادياً، عبر شركات متعددة الجنسيات، هو انهيار منظومة الأفكار السياسية التي تنتج ديناميكية تطورية في مجالات اجتماعية وفلسفية وسياسية واقتصادية وثقافية وفنية. وهذا ما انعدم كلياً بعد إعلان نهاية التاريخ. ليتلقى النظام العالمي المتسيّد ضربة أولى في العام 2008، إثر الأزمة المالية العالمية التي عصفت به، وأدت إلى فرض تغييرات جذرية في آلية عمل السوق وتدخل الحكومات في تنظيمها.
الضربة الثانية التي تسقط جذرياً "نهاية التاريخ" جاءت من بوابة صحية وطبية، وهي أزمة كورونا، التي أول ما عصفت به غيرت الإنسان، حيث كانت هذه المنظومة قائمة على أساس السوق فتطورت، فالاتحاد الأوروبي تطور من سوق أوروبية مشتركة إلى اتحاد بين دول أوروبا، ليعود الاتحاد ويسقط، في تصارع دوله على مواجهة الوباء والسعي إلى البقاء، بدون أي مساعدة من أي دولة، ما حدا بوزراء ومسؤولين أوروبيين إلى القول، إنه إذا ما كان الاتحاد قائم فقط على تجارة في سوق مفتوح فلا يمكن له الاستمرار.
حتماً، لن يبقى النظام العالمي على حاله بعد أزمة كورونا، وما سينتج عنها من أزمات سياسية وكساد اقتصادي، وتداعيات اجتماعية وبشرية. تلك الأزمة التي سددت ضربة قاسمة إلى منطق اقتصاد السوق، وإنتاج مؤسسات وقطاعات منتجة موازية أو مضاربة لمؤسسات الحكومات. فيما لم يجد الناس غير الحكومات من معين لهم في أزمتهم الحالكة هذه، وأثبت السوق المتفلت فشله في مواجهة التداعيات والمخاطر وتوفير البدائل. أعادت الأزمة الاعتبار لعمل الحكومات وتدخلها في السياسات الاقتصادية والرعاية الاجتماعية، وليس الصحيّة فقط. وهي من شأنها أن تشرّع الأبواب أمام نقاشات فكرية مديدة حول كيفية تطور دور الدولة، ومستقبل هذه الدول، ونظمها، وآلية تعاطيها مع مواطنيها. خاصة أن كل دولة أو مجتمع انغلق على نفسه، وعادت معه نفحة العنصرية أو التفوق العنصري، كما حدث بالنسبة إلى الأفارقة والمغاربة في فرنسا، أو التعاطي الأوروبي العام مع إيطاليا وإسبانيا، أو التعاطي الأميركي مع الصينيين.
بعد كل فورة صناعية أو اقتصادية، تنتج أزمة عالمية، تؤدي إلى حروب ونزاعات عسكرية أو بأوجه مختلفة
والملاحظ، أنه بعد كل فورة صناعية أو اقتصادية، تنتج أزمة عالمية، تؤدي إلى حروب ونزاعات عسكرية أو بأوجه مختلفة، فتنتج هذه الحروب نماذج جديدة من التفاهة السياسية القائمة على المنطق الشعبوي، كما حصل إبان الحرب العالمية الثانية والذهاب إلى بروز "النازية" و"الفاشية". وغالباً ما تأتي الشعبوية التسخيفية بعد الهزائم، بحيث يعمل الشعبويون على تستير عيوبهم ونواقصهم بالصراخ الديماغوجي المتودد إلى الجموع المحتقنة التواقة للاحتشاد والتعبير عن الغضب. ترتبط السياسة التتفيهية هنا بشخص شعبوي، يدعي الإلهام والألوهية، ويهدف للسيطرة على العقول، بتقديس قضيته من خلال تقديسه لذاته. كتأسيس موسوليني للفاشية القائمة على المعتقد القومي والإثنية، وعبادة الدولة التي يجسدها الحزب القائد أو الشخص القائد، الممثل لمصلحة المجتمع التي تُفضّل وتُقدم على مصلحة الأفراد، بما يلغي أن ديناميكية اجتماعية. وهذا ما حاول هتلر أن يبتكره ويكرسه في التماهي بين شخصه وألمانيا، بجنون عظمته الجانح نحو الحرب.
منذ القرن التاسع عشر والثورة الصناعية، هناك رهان بأن الرأسمالية هشة وغير عادلة، وعند كل أزمة ومنعطف، تبرز هذه الرهانات، ولكن كل تحدٍّ يُطرح بوجه هذه الرأسمالية، تنجح في هضمه واستيعابه وتطوير نفسها. كتحسين شروط العمال، والمنفعة، وتوزيع الثروة، وهذا كان تطور في بنيتها، بينما ما يناقضها لم يكن لديه قدرة على تسويق أو تطوير أفكاره. طبعاً ما يتبع الانتصار الرأسمالي الاقتصادي، هو التركيز على عنصرين إلى جانب هذه الرأسمالية، فهي ليبرالية المجتمع، والديمقراطية السياسية. هذه الرأسمالية فرضت نفسها على أنظمة كانت في عداد الاشتراكية والشيوعية كالصين مثلاً كنظام رأسمالي ولكن غير ديمقراطي، وروسيا كنظام رأسمالي أوتوقراطي ليس فيه أي مقومات للديمقراطية.
حتماً سيكون ما بعد كورونا، معضلة كبرى لدى الديمقراطيات الغربية، بحيث سيكون هناك نزوع نحو حكومات أكثر تشدداً بنزعتها الوطنية والقومية، بحيث ستميل الناس إلى تيارات الخوف من الآخر والخطر الآتي من الخارج، ما سيؤدي إلى نوع من أنواع كبح العولمة، والخوف الأكبر من المختلفين والاختلاط، وهو سيؤثر حكماً على الديمقراطيات وليس على الرأسمالية، التي لا يوجد ما يواجهها جدياً. الديمقراطيات ستكون أمام تحدّ حقيقي، يؤدي إلى طفرة شعبوية، بمواجهة "وحدة مصير العالم" ووحدة الجنس البشري، المتساوي أمام العجز الناتج عن هذه الأزمة. وهذا سيكون أكثر عقلانية كمقابل للنزعات الشعبوية الأخرى.

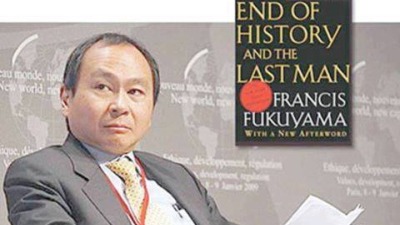
 حروب المنطقة وتقلباتها.. مصالح الدول والمشاعات ومكافحة المجاعات
حروب المنطقة وتقلباتها.. مصالح الدول والمشاعات ومكافحة المجاعات منادمة الأسد والأبخازي.. وانطلاقة جديدة لتلفزيون سوريا
منادمة الأسد والأبخازي.. وانطلاقة جديدة لتلفزيون سوريا طرفان استضعفا أميركا.. خصم مدّعى وحليف منبوذ
طرفان استضعفا أميركا.. خصم مدّعى وحليف منبوذ إيران ووقف الرحلات المدنية إلى سوريا.. تقويض الممرات في صراع المعابر
إيران ووقف الرحلات المدنية إلى سوريا.. تقويض الممرات في صراع المعابر