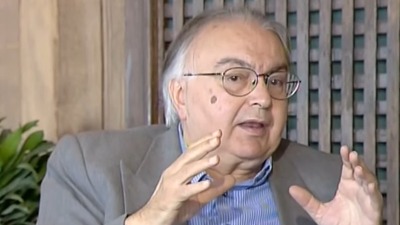في جو من الجدل السياسي الحاد حول الموقف من الثورة السورية، التي أصبحت معيارا أخلاقيا يقيس به مجتمع الثورة والمؤمنون بها قيمة هذا الكاتب أو ذاك الروائي، جاءت وفاة وليد إخلاصي لتعيد طرح الأسئلة نفسها التي مازلنا ننشغل بها منذ أكثر من عقد من عمر الثورة، حين يموت أحد المبدعين. فمعظم المناقشين ينظرون إلى المتوفى من زاوية موقفه الأخلاقي، لا من زاوية الأدب أو الفكر الذي أنتجه. وفي ظل هذا الانقسام المجتمعي، يصبح من المستحيل على المرء أن يتناول الأديب أو المفكر من زاوية إنتاجه فحسب، ناهيك عن تقييم هذا الإنتاج سلبا أو إيجابا.
النقاش الذي دار حول وليد إخلاصي امتزجت فيه عوامل شتى، من بينها الحديث عن العلاقات الشخصية بالرجل، وعمله في مؤسسة الأقطان، وثمة من تطرق للحديث عن فساد الرجل إبان وجوده في تلك المؤسسة، بينما ترحم آخرون على رجل دمث الأخلاق، لم يعرف عنه الدخول في خصومات شخصية، أو مشاحنات لا يخلو منها الوسط الثقافي. هذا إلى جانب حديث الذكريات عن رجل كان مشهورا في حلب بغليونه المعروف، وبجلوسه في المقهى المقابل لساحة سعد الله الجابري...إلخ. وقد وصل النقاش أو الجدل في ظل الانقسام السوري للكلام على أصول الرجل التي تعود إلى لواء إسكندرون، وهو منبت رأى فيه آخرون جذورا علوية، كانت برأي بعض الناس عاملا في وقوفه إلى جانب النظام.
في خضم هذا النقاش، من الصعوبة العثور على شيء جديد، فالحقيقة أننا نكرر أنفسنا في سوريا منذ عشر سنوات، دون القدرة على الخروج من هذه الحدية، الخروج الذي يضمن لنا رؤية سليمة دون التنازل عن الموضوعية التي يفترض بنا التحلي بها.
هذا النقاش الحاد يغفل مسألة التفرقة بين الجمالي والفني، فالإنتاج الأدبي في مثل هذه الحالات يخضع للتقييم السياسي، ولموقف وليد إخلاصي السياسي في مثل هذه الحالة، وهو موقف كان رماديا في أحسن الحالات، أو معاديا للثورة كما يرى كثيرون الذين جاؤوا بدليل واضح، وهو لقاء أجراه تلفزيون النظام مع وليد إخلاصي بعد سيطرة النظام على حلب. ولهذا السبب يصعب على الأشخاص الذين ينتمون إلى الثورة الإقرار بأن يكون هذا الرجل أديبا، أو أن يكون أدبه على شيء من القيمة الفنية، فالأدب أو الفن في نظر عامة الناس إنتاج يسمو بصاحبه فوق شبهات الحياة وأدرانها البائسة، فالفنان كائن روحاني، رقيق الطبع، تغلب عليه الفطرة الخيرة، ولهذا يتعذر على الناس القبول بوجود شخص مبدع في حقل الأدب يقف مع الطغاة والمجرمين.
السؤال الأخلاقي هذا يصادفنا في الشخصيات العامة: الكتاب، المفكرين، الروائيين...إلخ، فهؤلاء نجوم العالم المعاصر، ولأنهم يشتغلون في العلوم الإنسانية، فإن البشر قد أضفوا عليهم صفات تتجاوز في كثير من الأحيان طبيعتهم البشرية، الأمر الذي يعيدنا مجددا إلى الأساطير التي كان يتداولها العرب القدماء عن الشعر ومصدره الغيبي (شياطين الشعر).
في الجانب الفني، لا أظن أن روايات وليد إخلاصي حققت ذلك الحضور المرجو، ولا سيما إسهامها في إغناء الساحة الثقافية العربية
هذا النقاش في عالم وسائل التواصل نقاش سياسي وأخلاقي غير مثمر من الناحية الفنية، فعدا أن جزءا كبيرا من المناقشين لم يسمعوا باسم وليد إخلاصي من قبل، فإن طيفا واسعا من النخبة المثقفة لم يقرأ للرجل، فدخل حلبة الجدل متسلحا بالتصورات الفكرية والإيديولوجية، وهذه كلها لا تفيد في تقييم الفن. لا يمكن أن تصادر على شخص ما حقه في إحجامه عن قراءة عمل أدبي لأن صاحبه وقف مع السلطة الأسدية التي ارتكبت الجرائم بحق السوريين، وشردتهم في أصقاع الأرض أمما، كما لا يمكن أن تنكر على شخص عدم قدرته على تلمس مواطن الجمال في عمل شخص شجع أو على الأقل سوغ للسلطة جرائمها وهمجيتها بحق أهله وجيرانه. ولكن هذا لا يعني إصدار حكم فني. الحكم الفني من حق الناقد وحده، فمعرفته بتاريخ الأدب، وبموضع هذا العمل في حقله الأدبي، ومستوى الإبداع والتجديد فيه، كلها معايير تمنحه سلطة وضع هذا الأديب أو ذاك في المرتبة التي يستحقها في طبقات الأدباء.
في الجانب الفني، لا أظن أن روايات وليد إخلاصي، مثلها مثل معظم الكتابات الروائية السورية، حققت ذلك الحضور المرجو، ولا سيما إسهامها في إغناء الساحة الثقافية العربية، على خلاف تجارب روائية عربية أصغر عمرا منها، وهذا عائد لأسباب تتعلق بطبيعة الحراك الاجتماعي في سوريا، وانعكاس ذلك على الأدب والرواية تحديدا. فالرواية هي ابنة الحرية والمجتمع المنفتح لا المغلق. والمجتمع السوري لم يكن مجتمعا حرا على الأقل منذ بداية الثمانينيات من القرن المنصرم. هذا إن لم نذكر أن مدينة محافظة مثل حلب لا يمكن أن يزدهر فيها فن الرواية، فن التجلي لا الخفاء.
مع قضاء النظام على حركة "الإخوان المسلمين"، وسحب السياسة كليا من المجتمع السوري، مات الحراك الاجتماعي والثقافي، وتحولت سوريا كلها إلى قبر صامت. الرواية هي صورة للحياة، ولذلك لن نعثر على أي عمل روائي يمكن أن نقول إنه عمل خارج إطار المألوف والعادي. إن روايات وليد إخلاصي تتناول الحياة الاجتماعية في مدينة حلب التي تشكل الفضاء أو الحيز الذي تتحرك فيه شخصياتها، وتؤرخ للحياة السياسية والحراك الاجتماعي، منذ نهاية الدولة العثمانية حتى بداية الثمانينيات، مرورا بالنضال الوطني ضد الانتداب الفرنسي، والصراع السياسي في الخمسينيات وبداية الستينيات. ولكن مع بداية الثمانيات يصمت الروائي، لأنه عاجز عن قول أي شيء، إذ كيف يمكن أن تتحدث عن الحياة في جسد ميت؟ فإذا عرفنا أن هذا الصمت يطول فترة ثلاثين عاما، أدركنا حجم الهوة التي وجد فيها الأديب نفسه.
داخل هذا التأطير النقدي وحده، يمكن النظر إلى روايات وليد إخلاصي ومحاكمتها فنيا، ولا أظن أنها ستكشف لنا كثيرا من الإنجاز الروائي المتميز، فهي روايات تسجيلية للعادات والتقاليد، ولا تكاد تتجاوز ذلك. أما الاحتفاء الكبير بوليد إخلاصي، فمرده إلى أنه قادم من مدينة لا تساعد طبيعتها الاجتماعية على ولادة فن روائي، فضلا عن قلة الروائيين السوريين عموما، الأمر الذي استدعى من النقاد والمشتغلين بالشأن الثقافي الترحيب بأي صوت روائي، وإن لم تكن له بصمة مميزة.
حين نذكر جمال الغيطاني، فأول ما يتبادر إلى ذهننا "الزيني بركات"، وحين نتكلم على العلاقة بين الشرق والغرب، فإننا نستشهد بـ"موسم الهجرة إلى الشمال" للطيب صالح...إلخ. هذان مثالان عن روائيين مقلين، يؤيدان القاعدة المعروفة التي تقول إن الكثرة لا تعني الجودة أبدا. ما الذي يمر بساحة تفكيرنا من روايات حين نذكر "وليد إخلاصي"؟ لا شيء.