في زيارة لإحدى الصديقات، كانت تجري اتصالاً مع أهلها في الخارج، وكانت الجدّة وهي سيدة تجاوزت التسعين، وبدأ القسم الأكبر من ذاكرتها يخونها، فلم تعد تفرق بين أبنائها وأحفادها، ولم تعد تميّز الوجوه والأشخاص، كانت تشاهدنا عبر كاميرا الهاتف الجوال وتسأل من أكون، وهنا خطر ببال الابنة أن تذكر لها أنني صديقة، وبأنني من حي "جورة الشياح" الحمصي، وذلك لترى أو لتدعني أشاهد ردّة فعلها.
وبالفعل بدت علامات الدهشة على وجه الجدة العجوز، وأعادت السؤال مراراً لتتأكد أنني من هناك، ذكرت بصوت مفعمٍ بالحنين أن بيتها الذي تركته هناك، وماكينة الخياطة التي ارتبطت بها ارتباط صداقة عميقة، السرير والخزانة والأثاث، فستان الزفاف وأشياء كثيرة أخرى طرأت على بالها، وأشياء كثيرة حبيبة لم تستطع حملها معها إلى خارج سوريا.
في تلك اللحظات كنت أفهم تماماً كيف لا تخون الذاكرة هؤلاء الأشخاص، طالما تعلقت بأرض ووطن حبيب، إنها الآن تعيش في مكانٍ بعيدٍ جميلٍ وآمن، وحولها أغلب أولادها وبناتها وأحفادها، ومع ذلك، فقلبها في مكانٍ آخر تماماً، قلبها معلّق بالمدينة التي أحبتها، بالجيران والأهل، تلك أمورٌ ليست عرضة للتلف وإن شاخت الذاكرة، ولا مكان فيها للنسيان، لأن الأمان الحقيقي هناك، حيث الانتماء والارتباط والشعور بوجود الهوية الحقيقية، إنها رهن بالأمور التي امتلكتها شخصياً، شيء ما لا يشبه من جانب أو آخر بطاقة اللجوء، ولا الشعور بغربة الأرض واللغة والروح!
لقد كنت أفكر وأنا أتقمص دور " بنت الحارة" بما طرأ على ذاكرة السوريين ضمن موجات الهجرة واللجوء في الأعوام الأخيرة، وهي التي كانت في حقيقتها حالة الإنسان الباحث عن أمان وبيئة مستقرّة يعيش فيها بسلام، ضمن بيئة الحرب التي مزّقت كل شيء، وشوّهت الصورة الجميلة التي يرسمها كل إنسان لأرضه ووطنه، فقد السوري كل شيء، لكنه لم يفقد ذاكرته، وظلّت تلحّ عليه بمشاهد وصور شتى، تخبره كلما خلا بنفسه، أو نظر في المرآة عن جذوره وكينونته، عن تفاصيل كثيرة أثّرت به وتركت في أعماقه ما يستحق العودة إليه والرغبة باستعادته، تلك الحالة الغريبة عن الخيط الخفي الذي يربط الناس بالأرض مهما ابتعدوا، وذلك الحلم بالعودة مهما أسسوا من عوامل استقرار في المهجر مدعاة للتفكير والتأمل، فأولئك المواطنون الصالحون في الخارج في قلوبهم غصة أن يعودوا لأوطانهم بعد أن تزول كل الأحداث التي أبعدتهم عنها، وإن فئة منهم وضعت في أولوياتها العمل على بناء تلك العوامل مهما كان الثمن، الأمر ذاته عند العراقي والفلسطيني وعند كل مبعد عن وطنه قسراً.
إننا حين نحاول جمع الصور المخزونة في ذاكرتنا، لن نستطيع التحكم بما نحتفظ به ولا بما علينا أن نتخلى عنه، ولكننا نتحمل أيضاً أمام ذاكرتنا مسؤولية التمسّك بحقوقنا
في لقاء مع عجوز فلسطينية في لبنان، تتذكر العجوز أرضها في حيفا، شوارعها الجميلة، الجامع المجاور لمنزلها هناك، الحقول والأشجار، كل التفاصيل التي تعلمتها وحملتها معها يوم هُجّرت وهي في الرابعة عشرة من العمر، حتى الدروس التي تعلمتها في حيفا لها وقع مختلف في النفس، ذاكرة من الحب والحنين وعبق من زهر البرتقال والبساط السندسي الرائع الذي يكسو الأرض كل ربيع، كل ذلك لم تستطع نسيانه أبداً، بل حافظت على ذاكرتها حيّة نقيّة بانتظار أن تعود، هذه الذاكرة امتدت معها عقوداً حتى تجاوزت الثمانين من العمر، وياللغرابة كيف احتفظت بالأمل كل هذا الوقت؟ كيف تمسكت به ومنعته من الهرب وهي تتابع كل يوم نشرات الأخبار، وكيف يقتل الصهاينة أبناء فلسطين، وهي تراقب وتحزن وتتألم وتنشد وتغني عن الأرض والوطن والحب بتفاعل رائع مع الكلمات، إنها مثقلة بالحنين والألم لكنها لا تفقد الأمل أبداً، فأمنية حياتها مقترنة بالعودة مهما طال الزمان، والإصرار على الحق مطلب لا تراجع عنه، وتلك برأيي أهم عوامل القوة الذاتية التي يمكن لإنسانٍ حرّ أن يمتلكها.
إننا حين نحاول جمع الصور المخزونة في ذاكرتنا، لن نستطيع التحكم بما نحتفظ به ولا بما علينا أن نتخلى عنه، ولكننا نتحمل أيضاً أمام ذاكرتنا مسؤولية التمسّك بحقوقنا، فطالما كانت قيمة الإيمان بالحق مُلحّة وقوية وعميقة في النفس، ستبقى ذاكرتنا نشطة بكل العوامل المحفزة على استعادتها، ومادام الإنسان قد نذر نفسه لقضية وعاش لأجلها، فمن المستحيل أن ينسى، ومن المستحيل أيضاً أن يتنازل عن حقه مهما طال الزمان، الأمر مرهون بنا، بمقدار تحملنا المسؤولية، والأمر رهن بما نقرر أن نحيا لأجله، وبما يستحق أن نموت ونحن نطالب به.


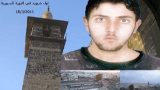 محمود الجوابرة – أول شهداء ثورة الكرامة
محمود الجوابرة – أول شهداء ثورة الكرامة خطيب الضمائر.. حمزة الخطيب
خطيب الضمائر.. حمزة الخطيب المظاهرات النسائية في حمص
المظاهرات النسائية في حمص بوابة الله كل ما ينتظره السوريون في الأضحى
بوابة الله كل ما ينتظره السوريون في الأضحى عن السياسة والقهوة
عن السياسة والقهوة