قصة العائلة السورية التي وضعت صورة لحافظ الأسد والتي حلّت عليهم كاللعنة، طغت على حبهم لرؤية ضوء الشمس المحجوب، فلا هم يتجرؤون على إزالتها، أو على أقل تقدير إزاحتها قليلاً لينفذ الضوء إلى الغرفة المظلمة. إليكم قصة أخرى، في إحدى جلسات الاختبار التي أجرتها نقابة المحامين لنيل الإجازة في المحاماة، كان المحامي المتمرّن الذي يخوض الاختبار عضواً في مجلس الشعب السوري. فسأله أحدهم: بما أنك برلماني، فمن يملك سلطة التشريع في سوريا؟. بعد صمت عميق يشي بتوجّس واضح من أن يكون السؤال فخاً يقوده إلى الحديث عن الصلاحيات الاستثنائية لرئيس الجمهورية في التشريع، ردّ المحامي مبتسماً: "لن أجيب على هذا السؤال".
حسناً بلا شك، قد تبدو القصتان ضرباً من ضروب الخيال أو ربما مشهداً مبتكراً من شطحات الكوميديا السورية السوداء، إلاّ أنه، ولا يختلف على ذلك اثنان، تعكسان واقع السوريين الذين لا زالوا يخشون بعضهم بعضاً، ويخفضون أصواتهم المرتعشة كلما تحدثوا بالسياسة. «للجدران آذان وللنوافذ عيون» عبارة ما انفكت تتردد على ألسنتهم، منهية حديثاً عابراً عن شخص الرئيس أو فساد أحد أفراد أسرته، في وقتٍ عمد فيه نظام الأسد، ولضمان تدجين شعبه، إلى اتباع أسلوبِ زرع الجواسيس في كلّ مؤسسات المجتمع، وتوزيع المخبرين في حياة أناس عاديين لا علاقة لهم بالعمل السياسي، لتغدو الوشاية وتقديم الخدمات إلى الأجهزة الأمنية أهم آليات الترقي الوظيفي، بل وأبرز شروط الحياة الكريمة في سوريا.
المذهل أنّ كثيراً من السوريين كانوا شجعاناً في شوارع المدن السورية، يتظاهرون تحت الرصاص ويرفعون أصواتهم في وجه الطاغية والقتلة
لا شكّ كانت الثورة السورية حدثاً استثنائياً عصيّاً على التحليل، مفاجئاً ومباغتاً، إلى حدّ لم يكن يتنبأ به أحد، وأول المتفاجئين السلطة التي تعرف شعبها جيداً، والتي أذاقته مرارة الهزيمة تلو الأخرى، وباعته وهم الانتصارات على امتداد عقود، حتى أصبح مخدّراً وعبداً للعقيدةِ الكاريكاتورية المقدسة "عبادة القائد الملهم والمعلم". المذهل أنّ كثيراً من السوريين كانوا شجعاناً في شوارع المدن السورية، يتظاهرون تحت الرصاص ويرفعون أصواتهم في وجه الطاغية والقتلة، لكنهم اكتشفوا أنه في سوريا فقط لا شيء ثابت وأصيل، ولا شيء كامل ومثالي سوى الخوف، وفي حال زواله سيتعرض الوعي الجمعي للفراغ والإرباك، لتغدو الرؤية ضبابية.
واليوم وبدلاً من الاستمرار في مواجهة جنون الطاغية وتجاوزات مطبّليه الفاسدين، لتنحية الخوف ولو قليلاً، تنامى اتجاه سوريّي الداخل خاصة نحو "اللا مبالاة" بعدما طمرهم اليأس في مستنقع القهر والفقر، لتغدو أشبه باستراتيجية ناجعة لعلاج "الخوف العضال" سلوكياً ومعرفياً ونفسياً، بغرض التخفيف عن الروح من تداعيات الحرب الطاحنة. فاتباع المضطهدين والمسحوقين خطة "التطنيش" وتجاوز المستبِدّ يشعرهم بأنهم ربحوا المعركة على الأقل أمام أنفسهم، وبالانتصار الشخصي يستعيدون زمام المبادرة ويحسون بمعنى حياتهم وقيمتها. بطبيعة الحال بدأت "استراتيجية التحرر" أولى خطواتها بما يسمى "الحسّ الفكاهي بالمأساة السورية" يعبرون عنه في وسائط التواصل الاجتماعي. كمّ ليس بقليل من هذه السخرية موجه بشكل سياسي بحت حتّى لو حمل سمة خفّة الظل. فما مُنع قوله في الشارع أصبح بالإمكان قوله في الفضاء الإلكتروني.
وفي الحقيقة لم يعد "غول الخوف" سيد البلاد هذه الأيام، حيث أزاحه غول أقوى شوكة منه وهو "اليأس" من جراء الشعور الغامر بعدم الجدوى من أي شيء، فلم يعد يهمّ السوريون خروج "لونا الشبل" المستشارة الخاصة في رئاسةِ الجمهورية، لتصدّر أبشع وجوه القهر السوري وهي تكرّر مقولة رأس النظام عن عدم امتلاكه "العصا السحرية" لتغيير الواقع، ولم تغب عن الذاكرة بعد محاضرات "بثينة شعبان" المملّة والممجوجة عن الصمود والتصدي، كذلك تصريحها المنفصم أنّ الاقتصاد السوري تحسّن بنحو خمسين مرّة عما كان عليه عام 2011. هما الصامدتان بأموال خرافية وبامتيازات استثنائية. ولم يعد يعني شيئاً إهانة مئة جريح من جرحى العجز الكلي من جيش النظام السوري في دورةَ "ألعاب جريح الوطن" عندما جرى استثمار عجزهم بشكلٍ استعراضي، رخيصٍ ومهين. وطبعاً لم يعد يهمّ الغباء المستفزّ الذي يبديه مسؤولو النظام في التعامل مع الكوارث المعيشية المتصاعدة والمتأزمة، أو المنظر المأساوي لتسرّب مادة الفيول بكميات هائلة وصلت إلى تخوم الجزيرة القبرصية، في حين يعاني السوريون من انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة تصل إلى عشرين ساعة في اليوم، وربما أكثر.
أيضاً لم يعد القصف الإسرائيلي لمواقع إيرانية في سوريا خبراً مهماً، بعدما صار تفصيلاً روتينياً من تفاصيل اليوميات السورية لاقتناع السوري أنّ الصمت جزء من اعتراف صريح بحقّ المعتدي. ولم يعد تهزّه أخبار الجرائم والاغتيالات، كخبر العثور على جثة لفتاة من دون رأس مرمية في إحدى حاويات القمامة، أو خبر اغتيال طبيب معروف بإنسانيته ومساعدته الفقراء وسط عيادته وبأبشع أشكال العنف والاستفزاز. ولم يعد يؤثّر به رؤية طوابير الذلّ الطويلة أمام مصادر الغذاء والوقود، ولا تصريحات "الحكومة البائسة" المثيرة للضحك أنّ هناك عرقلة خارجية مقصودة لعودة الراغبين من اللاجئين إلى وطنهم، وهم أغلبية. بينما تخامر أفكار الهجرة حتّى الجمهور الموالي للسلطة، والذي كان يعلّل الدمار الهائل الذي أطاح بالبلاد بكلمتين لا ثالث لهما: "مؤامرة خارجية".
اليأس مثل الأمل يصنع التغيير الحتمي، ولذا فإن قراءة الدلالات التي تنطوي عليها هذه العبارة تؤكد حياة الأمم المتجددة وفاعليتها المتواصلة حتى في أقسى مراحلها
أضف إلى ذلك أنه لم يعد يعني السوري شعارات "الضحك على اللحى" كشعار "الأمل بالعمل" وشعار "سوا منعمرها". وشعاره الذي اعتنقه يقيناً بجدوى فعاليته "بالتطنيش.. نعيش". وعليه فإنّ سيكولوجيا الحياد السوري أو ما أسميه تجاوزاً "اليأس الحميد" هو لا شكّ إحساس عالٍ بالمظلومية وتعبير صريح عن مقولة "طفح الكيل" من الاستخفاف بحياة ومستقبل السوريّين، واتساع هوة أزمة الثقة بين النظام المستبد وبين الشعب المقهور. هذا اليأس الذي ترك آثاره المدمرة في الشارع السوري، فارتفع منسوب التشدّد الديني والانتماء إلى منظمات إرهابية، أو عصابات الجريمة المنظمة والمخدرات والتوجه للرذيلة، وسواد مشاعر عدم الانتماء إلى الوطن، كذلك الحلم الدائم بالهروب مهما كانت طرقات الهجرة غير الشرعية محفوفة بالمخاطر.
يُقال إنّ اليأس مثل الأمل يصنع التغيير الحتمي، ولذا فإن قراءة الدلالات التي تنطوي عليها هذه العبارة تؤكد حياة الأمم المتجددة وفاعليتها المتواصلة حتى في أقسى مراحلها، عندما تنهض الانكسارات على نحو جديد وغير متوقع، فلا تفتح بوابة إلى الأمل فقط، بل إلى التحدي، وهذا ما بدأ ينمو في سوريا، باعتبار "اليأس الحميد" مبدأ أخلاقي فاعل في كلّ معادلات التغيير، فأوروبا التي شهدت في النصف الأول من القرن الماضي أنظمة استبدادية شمولية، دفع سكانها ثمناً باهظاً لسياساتها الجائرة، تجسد في التقاتل والتصارع أولاً، ثم في التكامل والتوحد لاحقاً، مما سمح بحدوث التحول الكبير. ويحتاج السوريون الذين يعيشون موتاً سريرياً بطيئاً، والذين يضحكون من أوجاعهم المستعصية وينامون مطمئنين إلى كوابيسهم السوداء، أن يذاكروا "مثلاً" حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي المتبادل بين قبيلتي الهوتو والتوتسي في رواندا، الذي خلّف نحو المليون ضحية، حتى تكهّن البعض بانقراض شعبها. وفي واقع الأمر انتقلت البلاد، وبعد أقل من عقدين، من الفشل الى النجاح في منافسة اقتصاديات الدول المختلفة، ونالت عاصمتها "كيجالي" التي كانت يوماً ما "مدينة صفيح" لقب أجمل عاصمة أفريقية.


 في مواجهة زعيم مملكة الكبتاغون السلطانية
في مواجهة زعيم مملكة الكبتاغون السلطانية الثورةُ المضادة والارتدادات الثورية الناعمة
الثورةُ المضادة والارتدادات الثورية الناعمة غواية "حاكمات الظلّ" واستراتيجية السطوة الناعمة
غواية "حاكمات الظلّ" واستراتيجية السطوة الناعمة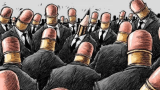 الجاهلية الأسدية والأنبياء الذين لم يُوحَ إليهم..
الجاهلية الأسدية والأنبياء الذين لم يُوحَ إليهم.. القطيعُ السوري المهاجر من وإلى فناء العدم المطلق
القطيعُ السوري المهاجر من وإلى فناء العدم المطلق