في الثاني من شهر أيار الجاري حلّت الذكرى السنوية التاسعة لرحيل الناقد الأستاذ يوسف سامي اليوسف (1938م – 2013م )، وبذكرى رحيله يتجدّد الحديث في الأوساط النقدية والثقافية عن المُنجز النقدي للمرحوم اليوسف، باعتباره مُنجزاً نوعياً يتسم بعمق النظرة وشموليتها، وبسعة الإحاطة المُزوّدة بثقافة قلّما حازها ناقد في العصر الحديث. إلّا أن تميّز التجربة النقدية أو فرادتها لدى المرحوم اليوسف لم يجعلها تنأى عن العديد من الأسئلة الإشكالية التي ظلت ملازمة لمعظم ما كتبه اليوسف من نقد، بل ربما تحوّلت عند البعض إلى مأخذ منهجي أخلّ بالرؤية النقدية لليوسف، وأعني بذلك تحديداً : تداخل المعيار النقدي بين الذاتية والموضوعية، بل وانحياز اليوسف إزاء نصوصه الأدبية المدروسة إلى ( ذاتيته ) التي تجعل من نصه النقدي نصاً إبداعياً آخر، غالباً ما يكون موازياً للنص المدروس، وليس منبثقاً عنه.
تميّز التجربة النقدية أو فرادتها لدى المرحوم اليوسف لم يجعلها تنأى عن العديد من الأسئلة الإشكالية التي ظلت ملازمة لمعظم ما كتبه اليوسف من نقد
لا ريب أن مشروعية هذا المأخذ النقدي – وفقاً للقائلين به – إنما تستند إلى التصوّر الذي يرى في العملية النقدية نشاطاً علمياً يقتضي الموضوعية، إن لم نقل إن الموضوعية هي سمته الأساسية، ما يعني ضرورة وجود مسافة بين النص والناقد تتيح له القراءة والتمعّن بتجرّد عن ذاتيته، بل ربما رأى البعض أن اختزال تلك المسافة أو تجاوزها، ربما أدى إلى انزياح كلام الناقد من الحيّز النقدي ذي الدلالات التي توضحها المصطلحات الدقيقة، إلى حيّز الانطباعات والتعابير التي تنتمي إلى فضاءات الإبداع أكثر مما تنتمي إلى لغة النقد.
ما يمكن تأكيده هو أن هذه الإشكالية المنهجية في النقد كانت قد أثارت اهتمام المرحوم اليوسف واستوقفته قبل غيره، وبسط فيها القول في أكثر من موضع في كتبه أو مقالاته، ولكن ربما لم تكن مقنعةً لمُنتقديه، ما يعني أن الخلاف بين الطرفين – كما أعتقد – لا يمكن اختزاله في طبيعة المنهج النقدي فحسب، بقدر ما هو نابع من تصوّر عام لدى كلا الطرفين عن ماهية الفن ووظيفته من جهة، وعن وظيفة النقد من جهة أخرى، ولئن كان حيّز هذه المقالة لا يتيح الإسهاب وتلمّس الجذور الخلافية بين الرؤيتين، فلا بأس من الوقوف بإيجاز عند مفهوم الناقد يوسف سامي اليوسف لـ (علمية النقد وذاتيته ) وذلك وفقاً لما جاء في كتابيه : (القيمة والمعيار – ما الشعر العظيم).
يميّز اليوسف بين نوعين من الوعي النقدي: وعي الثمالة، ووعي الدلالة، أمّا الأول فإنه ينبثق عن ذات الناقد ولا يفارقها، وإن أصرّ على التفكير من خلال ذاته فحسب، ولم يخرج عنها، فإنه لن يجد أمامه من معايير النقد سوى ( التوسّم أو التذوّق أو التمتّع) وهذه المزايا وإن كانت حيازتها شرطاً ضرورياً لأي ناقد، إلّا أنها بمفردها لا ترقى لأن تكون منهجاً نقدياً، ولن يكون الناقد - حينذاك – سوى متحدث عما يضمر في ذاته وليس عما يضمره النص، بل ربما كان الناقد عندئذٍ هو أقرب إلى الإنسان الصوفي (إنك لن تذوق سوى نفسك). أمّا المستوى الثاني من الوعي (وعي الدلالة) فهو ينبثق عن قراءة تكتفي بشرح مضامين النصوص وأغراضها، دون القدرة على ملامسة بواطن التجربة الجمالية أو الإبداعية، بل ربما تسهم هذه القراءة في تسطيح النص الأدبي باعتباره مُنتَجا إبداعياً يعبّر عن مكابدة عميقة الغور في النفس البشرية، وكعادته في الحرص على ربط الظاهرة الأدبية بسياقاتها الفكرية التاريخية، يرى اليوسف أن ما أسهم بشيوع المناهج النقدية التي تقف عند تخوم الدلالة المباشرة للنص فقط، هو انهزام الفلسفة المثالية في بدايات القرن العشرين أمام المدّ الكاسح للفلسفات المادية، فضلاً عن أن بعض الأفكار قد انبثقت من حقول معرفية أخرى ذات منحى لغوي أو اجتماعي، ثم تحوّلت فيما بعد إلى منهج نقدي، كالبنيوية على سبيل المثال، والتي يُؤخذ عليها غياب الجانب المعياري في دراسة النصوص.
لعله من واضح أن المرحوم اليوسف إذ يقارب بعمق ذاتية النقد وموضوعيته، فإن مقاربته لم تكن منفصلةً عن مقاربة النقد التراثي العربي لتلك الإشكالية ذاتها
لعله من واضح أن المرحوم اليوسف إذ يقارب بعمق ذاتية النقد وموضوعيته، فإن مقاربته لم تكن منفصلةً عن مقاربة النقد التراثي العربي لتلك الإشكالية ذاتها، إذ ثمة من النقاد التراثيين من رأى أن الفحوى الحقيقي للشعر إنما يكمن في جرعته الوجدانية بحسب تعبير اليوسف، ولعل من أبرز هؤلاء ( القاضي الجرجاني 322هـ - 392 هـ) الذي يرى أن جاذبية النصوص الشعرية و تأثيرها في النفوس لا يمكن أن تتحقق من خلال المحاججة العقلية أو المنطقية، بل (بالرونق والطلاوة والحلاوة)، ولئن كان اليوسف يرى أن الاكتفاء بمنظور القاضي الجرجاني لا يُنتج سوى نقدٍ ذوقي لا يرتقي إلى ( عِلْمية النقد)، فإنه يرى أن الفكرة ذاتها ربما باتت أكثر نضجاً لدى ناقد تراثي آخر هو ( عبد القاهر الجرجاني 400 هـ - 471 هـ) الذي تميّز بملكتين تجسّدان قوام العملية النقدية، أولاهما ذاتية، وتعني الحساسية الروحية والقدرة النفسية على تلمّس الأثر الوجداني للنصوص، وثانيهما نزعته العقلية ذات المرجعية ( الأشعرية ) التي تزوّده بالقدرة على التبرير والتمييز وأسباب الانتقاء أو التفضيل، ذلك أن الناقد الحق ليس من يشير إلى الجميل فحسب، بل مَنْ يبيّن أسبابه وبواعثه أيضاً. وفي موازاة هذا المنظور، ثمة منظور تراثي آخر يرى أن القيمة الجوهرية في النص الشعري إنما مبعثها قوّة الخيال القادر على إنتاج الصور البيانية الأكثر إبداعاً وغرائبيةً، ولعل التيار الذي أسسه أبو تمام يُعدّ الأبرز في هذا المنحى. ولا يبدو يوسف سامي اليوسف نصيراً بالمطلق لأحد هذين التيارين التراثيين النقديين، فلئن كان يرى أن النقد الذوقي لا يغادر حدوده الانطباعية، فإنه يرى من جهة أخرى، أن الشعر الذي ينبثق عن قوّة الخيال فحسب، هو شعر( متليّف موغل في الشكلانية التي تعتمد على التجريد العمائي الخاوي) القيمة والمعيار ص8 . وربما كان اليوسف – في هذا السياق - أقرب إلى مفهوم تكاملي عبر عنه بمصطلح خاص به، هو ( الخيال الوجداني)، إذ يرى أن الشعر لا ينهض إلّا على ركنين اثنين هما ( الخيال والوجدان)، وربما بدا كسيحاً أو أعرجاً بغياب أحدهما.
لعله ليس بجديد التأكيد على بروز معالم القراءة الصوفية للشعر لدى الناقد اليوسف، وهي القراءة التي تعتمد على قوّة الحدس وعمق البصيرة ونقاء التذوّق، مستلهماً بذلك قول أبي العلاء المعري:
أما اليقين فلا يقين وإنما أقصى اجتهادي أن أظن وأحدسا
إلّا أن هذه الاندفاعة الجوّانية نحو عمق النصوص بغيةَ التماس ما يدعوه النقاد التراثيون (بالرونق والحلاوة والطلاوة) لا يجعل اليوسف أسيراً لفلسفة باطنية تختزل النص الأدبي في أبعاده الشعورية أو النفسية فحسب، أو ترى أن عظمة الفن تكمن في عمق المكابدة البشرية لآلامها أو أفراحها فقط، ويصبح التأويل الاعتباطي الذاتي – حينذاك – هو أداة الناقد الوحيدة، بل لا بدّ من حيازة القدرة على عقلنة آليات القراءة التي من شانها أن تحوّل محتويات النص الشعورية والوجدانية إلى خلاصات معرفية، وتلك العملية لا يملك القيام بها سوى ناقد حاز قدراً كبيراً من العمق المعرفي المتنوّع، فضلاً عن حيازته تماسكاً رفيعا في التفكير.
ربما كان من غير المستغرب أن تبقى التجربة النقدية للمرحوم يوسف سامي اليوسف مثيرة للأسئلة التي تبدو إشكالية في معظم الأحيان، ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن المرحوم اليوسف قد أسّس بناءه المعرفي، وكذلك مُنجزه الثقافي والنقدي، بعيداً عن تيارين نقديين ثقافيين، كلاهما تقليدي في النتيجة، أولهما التيار الذي التحف عباءة التراث ولم يستطع الخروج منها، وبالتالي ظل وعيه محكوماً برؤية السلف، ولم يتمكن من النفاذ إلى فضاء الحداثة. والآخر وعيٌ حداثي ولكنه مُستلب، أُتيح له الاطلاع على أفكار وثقافات حديثة، ولكنه غير قادر على تحويل تلك الأفكار إلى مشروعات ثقافية تلبي حاجات مجتمعية محلية أو وطنية، فظل رصيده المعرفي الحديث محكوماً بمرجعياته المجتمعية الغربية.
لعل قدرة الناقد اليوسف على تجاوز هذين التيارين، وتفرّده في إنجاز نصوص نقدية مُعزّزة بزاد معرفي وفير، وحساسية عالية قادرة على النفاذ إلى عمق الخطاب الفني، دون الوقوع في شرك الماضي وأغلاله، وكذلك دون الإحساس بالاستلاب الثقافي والحضاري تجاه الحداثة الغربية، هو بالنتيجة ما جعل نصّه النقدي يحوز سمتين، ظن الكثيرون أنهما نقيضتان، ولكنهما لدى يوسف اليوسف تبدوان متكاملتين، وأعني بهما: سمة العلم وسمة الإبداع.


 إيران الوصيّة على الأسد
إيران الوصيّة على الأسد حين يكون الإبداع ضحية الإيديولوجيا
حين يكون الإبداع ضحية الإيديولوجيا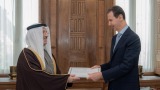 دعوة بشار الأسد إلى قمة المنامة
دعوة بشار الأسد إلى قمة المنامة اللقاء المُرتقب للجنة الدستورية مصلحة سورية أم حاجة إقليمية؟
اللقاء المُرتقب للجنة الدستورية مصلحة سورية أم حاجة إقليمية؟