ها هو الخريف الدمشقي الرائق، نصل إلى معبر جديدة يابوس، حيث لا تزال آثار عاصفة الليلة السابقة تبلل الأرض والمباني. الطابع العسكري والأمني يُخرجنا على الفور من حال التمتع بالطبيعة الخلابة والناعسة. الجنود ببدلاتهم العسكرية المتهللة متوزعون على أطراف المعبر. حرس الحدود بعيونهم الجائعة لاصطياد أولئك المسافرين المرتبكين: فريسة سهلة للابتزاز. نحن في سيارة التاكسي، بحركة أوتوماتيكية، نلمُّ مبلغا بسيطاً ونمنحه للسائق، الجزية السرية التي سيمررها لمدقّق الجوازات، مع ربطات الخبز اللبناني، كرسم جمركي راسخ.
الجنود والحرس، في هيئاتهم الباهتة وسحناتهم القاسية وقصّات شعرهم البلا شكل وشواربهم الريفية العتيقة، ونبرة أسئلتهم المتشككة بجدية تقارب الاشتباه والريبة، تجعلنا موقنين أننا بتنا في سوريا. بلاد المخابرات والمطاردة الأبدية.. للمشبوهين، للأفكار الخطيرة، للبضائع المحرّمة.
بتنا في سوريا. بلاد المخابرات والمطاردة الأبدية.. للمشبوهين، للأفكار الخطيرة، للبضائع المحرّمة
المروج والهضاب بجانب وادي بردى.. أقل من ساعة بسيارة مسرعة ووجوم الدخول إلى الأرض السورية والصمت الملتبس، ما بين الحذر والتأمل في هذا الفضاء والخلاء. صمت ملازم لحيرة النظر إلى تلك الأنصاب والتماثيل التي تباغتنا على الطريق، تماثيل رئيس الأبد، غير المتقنة، الكاريكاتورية في أخطاء اللاتناسق بين حجم الرأس والجذع، أو طول اليدين أو تمطط القامة أو انضغاطها. وهي كاريكاتورية أيضاً في ألوانها، ما يجعلها دوماً أقل بشرية، كشخصية غير ممكنة التعيين، مراوغة وممسوخة. شخصية بمختلف الأحجام والسمات والألوان، إلا الصفات الخاصة بالوجه الكامد.
المفارقة غير المتوقعة أن رداءة فن صنع هذه التماثيل، هي التي تمنحها تلك المسحة المخيفة، الطاقة على بث الرعب. لا بشريتها هي مصدر قوتها الإيحائية المفزعة.
كالعادة، ما إن ندخل أوتوستراد المزّة، حتى نتجه إلى ساحة المالكي، هناك صانع الفطائر اللذيذة والشاورما. مقصد الواصلين من بيروت إلى دمشق. استراحة في واحد من أرقى أحياء المدينة، حيث تبدو الحياة اليومية بالغة الرخاء واللطافة. كأننا هنا نثأر من الأذى النفسي الذي أصابنا من الحدود وطوال الطريق. هنا، يتغير إيقاع تنفسنا. نبدأ بالحديث بأريحية تعاكس ساعة التشنج التي اختبرناها للتو.
إلفة الشوارع وأرصفتها المشجرة، والسكان المنحازون للهدوء.. كل هذا يرسم دمشقَ أخرى، ما تزال موجودة داخل دمشق العسكريتارية المخابراتية البعثية الأسدية.
الهواء البارد والجاف الذي يداعب المدينة، والمشهد المفتوح نحو جبل قاسيون، والمباني التي تحيط بنا هنا ذات الطابع البرجوازي، وفق عمارة الأربعينات والخمسينات، وإلفة الشوارع وأرصفتها المشجرة، والسكان المنحازون للهدوء.. كل هذا يرسم دمشقَ أخرى، ما تزال موجودة داخل دمشق العسكريتارية المخابراتية البعثية الأسدية.
أتجه إلى منطقتي المفضلة، ذاك المربع الذهبي للعاصمة، ما بين الصالحية وأبو رمانة والحمرا. وجهة الإقامة دوماً إما فندق أمية أو فندق الشام. "أمية" العراقة، الذاكرة، الفخامة الأصلية بلا مبالغة، الترتيب المحلي للضيافة والنظافة، وحميمية الغرف، ولباقة الموظفين. لكن "الشام" الأنيق بصالونه الرحب هو صرة الاجتماع بالأصحاب ولقاءات الصدفة بوجوه الثقافة والصحافة، أو بمقهاه "برازيل"، حيث موعدي التلقائي بمحمد الماغوط. هو أيضاً فندق مهرجان المسرح وأيامه الأسطورية الخالدة في ذاكرة من عايش عقديّ الثمانينات والتسعينات.
أتحاشى دوماً "الميرديان" و"الشيراتون"، تلك الجزيرة الموبوءة بـ “النخبة" الحاكمة، بأثرياء السلطة ونجومها ورجال أعمالها وضباطها الكبار بملابسهم المدنية التي تضفي عليهم ملمحاً لصوصياً. أتحاشى تكرار تجربة الدخول إلى "لوبي" أحد الفندقين، حيث كانت قهقهات فاحشة بين زمرة من هؤلاء الذين ذكرتهم ومجالسيهم من "فنانات" ورجليّ سياسة لبنانيَين، يأكلون "البيتزا" بالشوكة والسكين!
يا لروعة مقهى الروضة، الاقتراح الدمشقي الأنصع لفضاء المقهى ورائحتها وأثاثها وأصواتها ونكهة شايها العادية جداً. صلتها بالشارع وبالعابرين وبروادها الجالسين هنا منذ مئة عام وسيظلون فيه مئة عام أخرى. يا لحضور العسس والمخبرين وآذانهم الدبقة ونظراتهم، المسمارية أحياناً أو التلصصية دوماً.
أتطلع إلى مبنى "مجلس الشعب". مبنى ينتمي إلى عهد سياسي بائد، وقد استولى عليه عهد سياسي متأبّد. كأن الفارق بين مزاجه المعماري المتناسق مع أصالة الحيّ وسكانه، ووظيفته الحالية كواحد من "مؤسسات" النظام، تجعلني أنظر إليه كمن يشفق على كائن مُغتصَب. وجوده هكذا في وسط سكني وتجاري يذكرنا بزمن البرلمانات العربية المنتخبة من أهل ونخب وعائلات وجماعات وطبقات متآلفة ومتنوعة ومتنازعة تباشر السياسة من تمثيل نفسها وتعبير عصبياتها واختلاف مصالحها.
أول المساء، سنتجمع شلة من كتّاب وفنانين.. ومتبطّلين، هم نسخة خاصة بهيبية الثقافة السورية وبوهيميتها المحلية المترعة بالكحول دوماً. نجتمع في تلك الغرفة الأسطورية لشاعر (لن أذكر اسمه حرصاً عليه) لا يعرف سوى توزيع الودّ والكثير من النميمة غير المؤذية. وحتى وقت متأخر من الليل، حين يتم القضاء على طن من اللحوم والعرق.. سأتواطأ مع الأقل تعتعة لننسرب إلى حانات باب توما المستجدة بعد العام 2000.
السحر الصباحي لدمشق، هو الفضاء الصوتي المذهل الذي يكتسح العاصمة. مئات آلاف الراديوات في كل مكان، من ردهة الفندق إلى دكاكين الأسواق، داخل سيارات التاكسي، من شرفات المنازل، داخل المكاتب والشركات: أغاني فيروز، المعبودة هنا إلى حد الشبهة الوثنية. لا تستفيق دمشق إلا مع أغانيها. تقليد وطني يثير ريبتي، بل وبتأويل باطني، لا يخلو من خبث، أشعر أن هذا يتصل بعقيدة سياسية سورية طمّاعة تاريخياً بضم لبنان والاستحواذ عليه. هذا شطح ومبالغة، لكن الاكتواء بالهيمنة السياسية والمخابراتية الأسدية على لبنان، يجعل مبالغتي معقولة الحجة.
لا وقت في دمشق، هو مجرد زمن غير قابل للتنظيم، بل لا داعي للسيطرة عليه أو ترتيبه.. ينساب وحده فيما الحياة ترافقه بكسل ولامبالاة
لا وقت في دمشق، هو مجرد زمن غير قابل للتنظيم، بل لا داعي للسيطرة عليه أو ترتيبه.. ينساب وحده فيما الحياة ترافقه بكسل ولامبالاة. ليس الأمر ترفاً، بل هو توطد اللامعنى. لا معنى من قلق الغد، طالما أنه تكرار للأمس واليوم. يعيش الأصحاب بخفة واستسلام، طالما أن شروط العيش لا تتطلب كفاحاً مريراً لتحصيل أكلافه. دمشق نقيض بيروت المتوحشة في ضغطها على سكانها اللاهثين لتأمين رزقهم، والتي لا ترحم الكسالى. بيروت رب عمل ودمشق أمّ صابرة.
لكن كل دقيقة في دمشق مغمسة بالحذر، وبتجنب النظر المباشر في العيون، بخفض الصوت حتى الهمس المرتجف. إن الانطباع الأول الذي لا يزول منذ زيارتي الأولى لها، هو هذا الكسوف في الأجسام، تلك الطأطأة للرأس، انخفاض الأكتاف نحو الصدر.. من لا يكون جسمه على هذه الصورة، يظهر فوراً بهيئة متنمر من أجهزة السلطة، وسترى على الأرجح نتوء خصره بمسدس.
منذ العام 2004، ما عاد متاحاً لي الذهاب إلى دمشق. ولم أتوقف يوماً عن هذا التمرين المنعش للذاكرة: زيارة متخيلة إلى المدينة التي أحبتني من النظرة الأولى.


 حكومة سعد الحريري لإنقاذ حزب الله أولاً
حكومة سعد الحريري لإنقاذ حزب الله أولاً حرائق لبنان وسوريا.. أو "صناعة" الكوارث
حرائق لبنان وسوريا.. أو "صناعة" الكوارث  إطلاق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية.. لا عزاء لحزب الله
إطلاق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية.. لا عزاء لحزب الله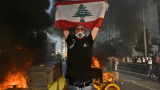 "جهنم" لبنان لم يبدأ بعد
"جهنم" لبنان لم يبدأ بعد حزب الله منتصراً على لبنان.. وفرنسا
حزب الله منتصراً على لبنان.. وفرنسا