جاءت المواطنة السورية من ألمانيا، حيث تقيم بصفة لاجئة، إلى بيروت، للقاء زوجها ووالديها، القادمين من سوريا. هذا حال معظم "المنفيين" السوريين مع "الصامدين" في الداخل: اللقاء في بلد ثالث. على الأغلب، هو لبنان أو الأردن.
الحياة السورية التي دخلت عليها تجارب جماعية من هذا النوع، أصابتها بكثير من الصدمات والتحولات الثقافية والأخلاقية. التصورات العامة تجاه الذات والعالم والتي ظلت ثابتة وجامدة لزمن طويل، لم تعد واضحة، خصوصاً للذين خرجوا من سوريا. تجربة الشتات لابد أنها أضفت على الهوية السورية بعداً جديداً. كذلك الحال، من خاض يوميات الثورة والحرب.
السيدة السورية التي عاشت جلّ عمرها في مدينة داخلية، ريفية الطابع، وتقطنها جماعة أهلية نادرة الاختلاط، تقيم اليوم وحيدة في شقة برلينية، باستقلالية تامة. هذا منحها نظرة مختلفة إلى أناها وإلى الآخر. وهي راحت تروي أثناء تعلمها للغة الألمانية، أنها تلقت أيضاً دروساً في التاريخ الألماني، أحداثاً وسياسة وأفكارا ومسارات ثقافية واجتماعية وفلسفة أخلاقية.. وقد عبّرت بكثير من الدهشة عن تشدد الألمان تجاه الحقبة النازية وإصرارهم على "الاعتذار" بوصفه طقساً قومياً ألمانياً، و"الشعور بالذنب" على أنه ليس واجباً وحسب، بل جدارة سياسية.
التماهي السوري مع الهولوكوست، كما فعلته هذه السيدة، ليس فقط تعريفاً للنفس بأنها "ضحية"، لكنه انقلاب في الوعي السياسي والأخلاقي تجاه الضحية الآخر (اليهودي).
ورغم حرجها (المستجد طبعاً، والمكتسب من "ألمانيتها") من القول بصيغة السؤال، هل يا ترى أن بقاء ألمانيا ومعها أوروبا على مشاعر الذنب تجاه "الهولوكوسوت" هو بسبب "نفوذ اللوبي اليهودي"، إلا أنها استدركت قائلة، لا يجوز ربما التساؤل، متذكرة أن القوانين الألمانية والأوروبية تعاقب من ينكر "المحرقة" النازية. حيرتها وارتباكها يدل على تلك المنازعة في دواخلها بين تربية "عربية – بعثية" راسخة، منسجمة مع نفس وكينونة صُنعتا على مدى حياتها، وفق منظومة سياسية وأيديولوجية واعتقادية رعت الشعب السوري كله (ومعظم الشعوب العربية) على مدى أجيال.. وبين تربية ألمانية أوروبية غربية طارئة على الوعي، وتسبب تناقضاً، في الوجدان كما في الروايات والسرديات المتبناة للتاريخ وللسياسة وللأخلاق والثقافة (الحق والباطل، الخير والشر).
وهي إذ راحت تحكي كما لو أنها تخاطب نفسها، ما علمته عن فظاعة حملة الإبادة التي لحقت باليهود، وجدت بسهولة تلقائية المقارنة بين "المحرقة" النازية من ناحية، وكيف تركت أوروبا كلها اليهود لمصيرهم البائس، وبين المحرقة الأسدية التي تسببت بقتل نصف مليون سوري وتشريد حوالى 11 مليوناً، ستة ملايين منهم باتوا في الشتات، وكيف تركت الدول العربية ومعها العالم السوريين للمصير نفسه. التماهي السوري مع الهولوكوست، كما فعلته هذه السيدة، ليس فقط تعريفاً للنفس بأنها "ضحية"، لكنه انقلاب في الوعي السياسي والأخلاقي تجاه الضحية الآخر (اليهودي) من ناحية، ومراجعة أيديولوجية للسرديات التاريخية التي كانت تتبناها، من ناحية أخرى.
التبدل في النظر إلى الذات وإلى العالم، معطوفاً على التغير في معنى الأخلاق والعدالة والحق، ليس يسيراً دوماً. قضية الضابطين السوريين، أنور رسلان وإياد العمر، اللذين اعتقلتهما السلطات الألمانية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، فتحت سجالاً سورياً، حقوقياً وسياسياً. فالضابطان منشقان والتحقا بصفوف المعارضة، ولجأا إلى ألمانيا. وعلى هذا، فإن بعض السوريين قد يعتبر الضابطين "بطلين"، أو على الأقل يعتقد هذا البعض أن "انشقاقهما" يمنحهما غفراناً عن أي ارتكاب واقتراف سابق.
يستند هؤلاء، أخلاقياً، إلى واقع تورط شطر كبير من ضباط الجيش والجنود، وسائر عناصر الأجهزة الاستخباراتية، كما أفراد الشرطة، والمخبرين السريين، وأعضاء في حزب البعث.. في جرائم موصوفة ومتكررة طالت أعداداً هائلة من المواطنين، وامتدت على مدى عقود من القسوة والديكتاتورية. ويتشارك مع هؤلاء في تلك الجرائم، عدد كبير من أعضاء الجسم القضائي مثل العاملين في القطاع الطبي ورهط كبير من البيروقراطيين. وإلى المسؤولين المباشرين عن هذه الاقترافات المنظمة والواسعة النطاق، يمكن ضم المسؤولين غير المباشرين فيها، كالدبلوماسيين وأعضاء البرلمان والوزراء وكبار موظفي الدولة والمستشارين والمشرفين على وسائل الإعلام والمثقفين.. وكل من ساهم في تشجيع أو تسهيل أو تبرير أو "تغطية" المجرمين. بمعنى آخر قد يكون هناك ملايين من المذنبين
الذين يعتبرون أن الضابطين المعتقلين الآن في ألمانيا لا يستحقان الإجراء العدلي الألماني، يستندون إلى ظن سياسي، بأن كل المذنبين، كانوا قبل الثورة. وحكم المغفرة والبراءة ينالونه بمجرد التحاقهم بالثورة وانشقاقهم عن النظام. فعل التوبة يحدث لحظة الخروج على النظام، وفعل المغفرة يتحقق لحظة انضمامهم إلى الثورة أو اللجوء إلى خارج سوريا. وهذا يشبه الناموس الديني عن الخطيئة والتوبة لا علاقة له بالعدالة الأرضية.
هناك دافع آخر لاستهوال ما جرى للضابطين. هو دافع الخوف من محاكمة كل المذنبين، ماقبل الثورة وأثناءها وبعدها. إنه أمر مهول وقد يطال الملايين حرفياً. وهذا مأزق وطني هائل وسؤال أخلاقي بامتياز.
لكن، هناك دافع آخر لاستهوال ما جرى للضابطين. هو دافع الخوف من محاكمة كل المذنبين، ماقبل الثورة وأثناءها وبعدها. إنه أمر مهول وقد يطال الملايين حرفياً. وهذا مأزق وطني هائل وسؤال أخلاقي بامتياز. والأسوأ أنه معضلة كبرى مع تاريخ سوريا، واستحقاق صعب يهدد المستقبل.
في المقابل، ثمة سوريون يؤيدون ملاحقة كل من ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بل ويعملون حقوقياً في شتى أرجاء العالم بالتعاون مع منظمات رسمية أو غير حكومية من أجل مطاردة المجرمين، وينظمون الملفات والقضايا ويجمعون الشهادات ويوثقون الأدلة تمهيداً لأي تحقيق جنائي فعال ولأي محاكمة ستقام مستقبلاً. وهم ينحازون لطلب العدالة وتحقيقها من أجل الضحايا أولاً ومن أجل الخروج الفعلي من "سوريا الأسد". ما يعني، عملياً، عدم تخوفهم أن يكون المذنبون ليسوا فقط بالملايين، بل أن "الأمة السورية" برمتها مذنبة، لا في اقتراف الجرائم وحسب بل في اعتناقها سياسة وأيديولوجيا ومنظمومة أخلاقية وثقافية فاسدة وشريرة.
هؤلاء، خطوا خطوة أبعد من السيدة السورية المقيمة في ألمانيا التي تتلمس وعيها "الجديد"، الألماني. إنهم يقطعون أخلاقياً، بالمعنى "الثوري" للكلمة، مع المنظومة السورية (والعربية)، ويباشرون ما هو في ألمانيا أبعد من ثقافة "الاعتذار": الإقرار بالذنب التاريخي. ثم واجب: كشف الحقيقة، المصارحة، المراجعة والمحاكمة. هؤلاء، يعتنقون فكرة أن إعادة بناء الأمة مشروطة أولاً بالعدالة.
السوريون اليوم، يراقبون الدناءة التي تتسم بها الأنظمة العربية وهي تسرع نحو تطبيع علاقتها بالنظام السوري، ويشعرون أن هذه الأنظمة ساقطة أخلاقياً. هذا هو تماماً ما نحاول التدليل عليه. فغياب مبدأ العدالة ومبدأ المحاكمة والمحاسبة، هو العطب الذي تعيشه شعوبنا العربية، والذي بسببه تمتد أعمار أنظمة الاستبداد وتتجدد.


 حكومة سعد الحريري لإنقاذ حزب الله أولاً
حكومة سعد الحريري لإنقاذ حزب الله أولاً حرائق لبنان وسوريا.. أو "صناعة" الكوارث
حرائق لبنان وسوريا.. أو "صناعة" الكوارث  إطلاق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية.. لا عزاء لحزب الله
إطلاق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية.. لا عزاء لحزب الله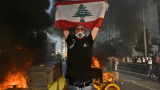 "جهنم" لبنان لم يبدأ بعد
"جهنم" لبنان لم يبدأ بعد حزب الله منتصراً على لبنان.. وفرنسا
حزب الله منتصراً على لبنان.. وفرنسا