يُعدُّ ملف (المعتقلين والمفقودين) من أبرز القضايا السورية من حيث الحضور والأهميّة، نظراً لتداعياته الموجعة والمزمنة لدى شريحة كبيرة من المواطنين، وفيما تتفاقم هذه القضية يوماً بعد يوم، تمضي الجهات الحقوقية والقانونية المحلية والدولية، وكذلك الأطراف المعنية بحقوق الإنسان، في توثيق ونشر ما يجري وفقاً لما هو متاح أمام تلك الجهات والهيئات، كما تبدي في الوقت ذاته حرصاً شديداً – بدوافع مهنية – على إيجاد المصطلحات الدقيقة للمفقودين، إذ غالباً ما يميّزون بين حالتي (الاعتقال) و(التغييب القسري)، من جهة أن الحالة الأولى توجب على الجهات الأمنية ألّا تحتجز مواطناً دون إذن سابق من جهة قضائية، فضلاً عن وجوب أن تكون الجهة المنفّذة للاعتقال معلومة الهوية، وكذلك توجب هذه الحالة أن يكون لذوي المعتقل كامل الحق في زيارة المعتقل ومتابعة أخباره ..إلخ، بينما تتّسم حالة التغييب القسري بالسرية، إذ يقوم رجال الأمن باختطاف الشخص المطلوب من الشارع أو البيت أو العمل، ويُساق إلى مكان مجهول، ولا أحد بعد ذلك يعرف عن مصيره شيئاً، بما في ذلك أهله وذووه.
منذ العام 2011 وحتى اليوم، فإن مجمل التقارير الصادرة عن الجهات الحقوقية والإنسانية فيما يخص الحالة السورية على وجه التحديد، تؤكّد أن النسبة العظمى من المواطنين الذين يقبعون في سجون الأسد، إنما هم مُغيّبون قسراً وليسوا معتقلين، وفقاً للأعراف القانونية التي يمليها مصطلح (التغييب القسري) إذ إن معظم هؤلاء المغيّبين اختطفتهم الجهات الأمنية إما من المظاهرات أو في أعقابها في عامي 2011 – 2012، أو من الحواجز التي يقيمها النظام في البلدات والمدن والطرقات العامة، أو من خلال مداهمة البيوت، أو مكان العمل، أو أي مكان يوجد فيه الأشخاص المطلوبون للسلطة.
وعلى الرغم من وجوب التفريق بين الحالتين المذكورتين، وأهمّية التمييز بينهما من الجانب المهني والقانوني، إلّا أنهما في الحالة السورية قد جسّدتا تداخلاً بين بعضهما البعض يكاد أن يكون كلّياً، سواءٌ من الناحية الإجرائية، أو من ناحية النتائج والتداعيات المادية والمعنوية التي تطول المعتقلين والمغيّبين معاً، بل إن الأرقام التي تفصح عنها التقارير الحقوقية تؤكّد على الدوام أن الغالبية العظمى من السجناء السياسيين إنما هم مُغيّبون قسراً وليسوا معتقلين، نظراً للطريقة أو الإجراءات التي اتبعتها السلطة في عملية احتجازهم أو خطفهم، ومما هو جدير بالملاحظة، أن حالات شيوع حالة التغييب القسري لم تكن وليدة ما بعد انطلاقة الثورة عام 2011، بل إنها الممارسة الأبرز للنهج الأمني في الدولة الأسدية منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، إذ تكشف بعض التقارير الحقوقية عن سبعة عشر ألفاً من المفقودين، يعود تاريخ احتجازهم إلى مطلع ثمانينيات القرن الماضي، إذ تمتنع الجهات الأمنية عن الإفصاح عن مصيرهم.
وعلى الرغم من محاولات النظام الرامية إلى شرْعنة العنف، وتأطيره قانونياً، منذ بداية الثمانينيات، كاستمرار العمل بموجب قانون الطوارئ المفروض منذ العام 1963، وإصدار القانون 49، وإحداث المحاكم الاستثنائية والميدانية، واستخدام مواد المرسوم رقم 6 الصادر عام 1965، والتي تحمل في مضامينها اتهامات بعيدة جداً عن الدقة والوضوح، بل تتيح للسلطة التفسير والتوظيف الذي يناسبها بغية النيل من الخصوم، على سبيل المثال وليس الحصر (إضعاف الشعور القومي – النيل من هيبة الدولة – مناهضة أهداف الثورة – مخالفة تطبيق النظام الاشتراكي ...إلخ)، ثم بعد انطلاقة الثورة 2011 ألغى النظام قانون الطوارئ واستبدله بما لا يقل عنه سوءاً (قانون الإرهاب)، إلّا أن تلك الإجراءات جميعها لم يكن بمقدورها أن تخفي الطابع التوحّشي البعيد بعداً مطلقاً عن أي التزام بقرينة قانونية أو إنسانية، لممارسات السلطة حيال من تعتقلهم أو تغيّبهم، إذ ثمة حالات لا يمكن تأطيرها بقانون ولا إحاطتها بمصطلح، ولعل أبرزها هي حالات القتل الجماعي التي باتت المنهج الأكثر حسماً لدى الدولة الأسدية في التخلص من الخصوم، فالذين قُتلوا في سجن تدمر في حزيران 1980 (العدد يشير إلى 800 ضحية) إنما قُتلوا بقرار انتقامي من رفعت الأسد ردّاً على محاولة فاشلة في اغتيال أخيه حافظ، وكذلك الآلاف الذين أقدمت سلطات الأسد على حرق جثثهم في سجن صيدنايا (بحسب تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في أيار 2017)، إضافة إلى العديد من حالات القتل الجماعي كمجزرة الحولة في أيار 2012، ومجزرة داريا في آب 2012، ومجزرة البيضا في أيار 2013، وغيرها الكثير من حالات التي شهدت قيام السلطات الأمنية بالقتل الجماعي لعشرات وربما المئات من المواطنين.
حين يصبح القتل الجماعي منهجاً لدى السلطة، سواء داخل السجون أو خارجها، فإن حيّز المصطلحات القانونية يصبح ضيّقاً، ومدلولاتها تصبح قاصرة عن الإحاطة بتوصيف الحدث، ذلك أن فداحة الجريمة تجاوزت كل التصورات السابقة، ولم تعد المسألة تنحصر في إجراء عقابي مؤطر بقوانين وإجراءات محددة تقوم به السلطة حيال خصومها، بل تحوّل الأمر إلى سعي الحاكم إلى إبادة خصمه وليس عقابه، ما يؤكّد صواب الرؤية التي تجد في الصراع بين الأسد والسوريين صراعاً وجودياً، وليس صراعاً سياسياً يمكن أن يفضي بالنتيجة إلى تسوية ما.
مفهوم الخصومة – بالنسبة إلى الدولة الأسدية – لا يمكن إخضاعه إلى أي إطار قانوني أو عرف سياسي أو حتى مبدأ إنساني، كمعيار ناظم لعملية التخاصم بين طرفين مختلفين، بل هو قائم بالأصل على محو الآخر أو استئصاله أو إقصائه وإبعاده، وذلك وفقاً لدرجة القوة التي يمتلكها النظام نفسه، فلو استعرضنا أبرز سلوكيات السلطة تجاه خصومها خلال عشر سنوات مضت، لوجدناها تتحدّد في ثلاثة أنماط: (القتل الجماعي داخل السجون – القتل الجماعي خارج السجون بما في ذلك القتل بالسلاح الكيمياوي والبراميل المتفجرة – التهجير القسري المتمثل باستئصال المواطنين من بيوتهم وبلداتهم ومدنهم وقذْفهم في ديار أخرى كما جرى لسكان حلب الشرقية والغوطة وشمال حمص والقلمون) وهذه الأنماط الثلاثة كلها تنتمي إلى جذر إجرامي واحد هو الإبادة التي لا تترك أثراً للخصم، بالطبع ثمة ممارسات عديدة أخرى خارجة عن هذه الأنماط لا يمكن التقليل من فداحة الأذى الناتج عنها، ولكنها تبقى اشتقاقات من مفهوم الإبادة، ولعل هذا ما دفع الكثيرين للاعتقاد بأن توصيف نظام الحكم في سورية بمصطلح (ديكتاتوري) هو توصيف غير دقيق، لأن الديكتاتور هو حاكم يفرض رأيه وهيمنته على دولة ذات مؤسسات وكيانات ويحاول إخضاع قوانين الدولة وأنظمتها لمشيئته، إلّا أن الحاكم في الدولة الأسدية ليس بحاجة إلى تطويع القوانين واستثمار المؤسسات وترويضها، بل سلوكه الذي يراه مناسباً هو القانون ذاته، لذلك لا يحتاج نظام الأسد إلى استصدار نص قانوني – وربما كان قادراً على ذلك لو أراد – يجيز له حرق الجثث داخل السجون، أو اغتصاب المعتقلات، أو قتل السجناء ودفنهم في مقابر جماعية في صحراء تدمر، أو قتل الأطفال بالغازات السامة، أو هدم البيوت فوق رؤوس أصحابها بالبراميل المتفجرة، هو لم يفعل ذلك ليقينه بأن منظومة القوانين والأعراف الإنسانية الناظمة لحياة البشر لا ترقى إلى مستوى المساس بمصالحه كفرد مالك للبلد وليس كحاكم له فحسب.
لعل جميع استراتيجيات المواجهة التي اعتمدتها معارضات نظام الأسد منذ انطلاقة الثورة وحتى الوقت الراهن، لم تكن منبثقةً من تصورات دقيقة تنمّ عن فهم عميق لماهيّة النظام وما يكمن وراء منظومته السلوكية، بقدر ما انبثقت من تصوّرات تمليها رغبة الاستمرار في إدارة الصراع وليس الوصول إلى الحل.


 إيران الوصيّة على الأسد
إيران الوصيّة على الأسد حين يكون الإبداع ضحية الإيديولوجيا
حين يكون الإبداع ضحية الإيديولوجيا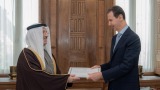 دعوة بشار الأسد إلى قمة المنامة
دعوة بشار الأسد إلى قمة المنامة اللقاء المُرتقب للجنة الدستورية مصلحة سورية أم حاجة إقليمية؟
اللقاء المُرتقب للجنة الدستورية مصلحة سورية أم حاجة إقليمية؟ عن وثيقة المناطق الثلاث
عن وثيقة المناطق الثلاث