في رواية الكاتب محمد مصطفى علوش، وهو والد النائب السابق في البرلمان اللبناني مصطفى علوش، "حكاية سورية"، يروي الكاتب، حكاية مدينة طرابلس شمال لبنان مع ضباط الأمن والمخابرات في الجيش السوري، والتنكيل الذي كانوا يمارسونه بحق زملائهم وليس فقط معتقليهم. يقدّم الكتاب صورة واضحة عن ضابط الأمن السوري، الذي أكثر ما يشكّل تهديداً له هو صوت الآخرين، الصوت هنا يمثّل الحرية، أو التعبير عن الشعور بالحسّ الإنساني وما يحتاجه من تعبير عن الرأي أو من تعبير حتى عن مشاعره. روايات سورية كثيرة، كتبها معتقلون تعرضوا لأبشع عمليات التعذيب النفسي والجسدي، يمكن الاستخلاص منها، أن الهاجس الذي أرساه نظام البعث خصوصاً في ظل حكم حافظ الأسد، هو تجريد الإنسان من أي إحساس أو تجريده حتى من شعوره.
قصة قصيرة لضباط الأمن مع المواطنين السوريين، تختصر رحلة هذا النظام وغايته القصوى، في منع السوريين من التعبير عن مكنوناتهم، عنوانها أنه لا يجب أن يكون للسوري صوت أو شكوى أو طلب. في إحدى القطعات العسكرية، تتلقى المخابرات إخبارية أن شخصاً يدعى عزّت يخطط لاستهداف طائرة حافظ الأسد بصاروخ، القصة حقيقية، يرويها ميشيل كيلو في كتابه دير الجسور، حيث تم إلقاء القبض على كل من يحملون هذا الاسم. أحد الضباط في الجيش من بين الموقوفين لأنه يحمل اسم عزت، بعد عمليات تعذيبهم، فشل المحققون في انتزاع أي معلومة أو خبر من هؤلاء، حتى لدى سؤالهم عن هواجسهم أو مطالبهم، عن احتياجاتهم، أو ملاحظاتهم على النظام أو الرئيس، فلم يجد المحققون أي إجابة.
في الوقت الذي غرق المحققون في همومهم لعدم انتزاع أي اعترافات يعودون بها إلى قيادتهم، كانت القيادة تفرح وتهلل، لم يفهم المحققون السبب، حتى جاءهم الجواب، بأن عدم وجود أي إجابة أو سؤال أو طلب لدى هؤلاء، يعني أن الهدف
عندما صرخ اللبنانيون في آذار 2005، كان صدى الصرخات يضج في الشام، وعندما صرخ السوريون في العام 2011، انتظر اللبنانيون حريتهم من هناك
الاستراتيجي للنظام قد تحقق، وهو إنتاج كائنات بشرية لا تطالب بأي حقوق، ولا تسعى إلى أي تغيير، فقط كائنات عددية مجردة من أي حس أو فكرة. هذا هو النموذج المثالي الذي أراد بعث حافظ الأسد تعميمه في سوريا. أي جعل المجتمع السوري بأسره "هومو بعثستيكوس"، أي الكائن البعثي، من صفاته أن يكون عبداً مطواعاً، يفتقد لأي طموح، يستوي لديه أكل حبة الزيتون بقتل القتيل، لا يفكر بل يعمل بما يُلقن، ويقدم فروض الطاعة والولاء.
المشكلة الأكبر، أن حافظ الأسد، كان طموحاً في بعثيته، لا يريد لنظريته أن تبقى داخل سوريا، وانطلاقاً من وحدويته، كان يريد تعميم مفهوم "الهومو بعثستيكوس" في لبنان وفلسطين. فأصبحت الحكاية اللبنانية جزءاً من حكاية سوريا. ولذلك عندما صرخ اللبنانيون في آذار 2005، كان صدى الصرخات يضج في الشام، وعندما صرخ السوريون في العام 2011، انتظر اللبنانيون حريتهم من هناك. وهذا هو التلازم الحقيقي للمسارين، الذي يتجدد حالياً في "الربيع اللبناني" الذي بلا شك ستكون أمامه عقبات كثيرة، ولكنه بالتأكيد هو استكمال لربيع 2005، ولربيع سوريا في 2011.
في ثورتهم، لجأ السوريون إلى استعادة صوتهم، أو لغتهم التي تجلّت بهتافاتهم للحرية. وهذه الأيام، يستعيد اللبنانيون صرخاتهم وأصواتهم، ضد "الهومو عونستيكوس" أي ضد النهج الذي يرسيه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، وليس بسيطاً أن يطلق على مناصريه لقب "العونيون". خنق حافظ الأسد صوت السوريين بتجربة حماة في الثمانينيات، فأصبح خيارهم بين الخضوع الأبدي أو الموت بذريعة الإرهاب. تماماً كما يريد أركان الحكم اللبنانيين العودة بطرابلس إلى الاختناق، أو إلى معادلة وصفها بقندهار، لأن مشهد الثورة اللبنانية فيها يزعج ميشال عون وحزب الله. ولا بد من إعادة تصويرها بعاصمة التطرف والإرهاب.
أسلوب العمل نفسه بين النظامين، على الرغم من أن نظام الأسد يتخذ صورة صلبة وجامدة، بينما النظام اللبناني يتخذ طابع المرونة الخبيثة التي ترتكز على معادلات مذهبية وطائفية قادرة على ضرب أي حراك مدني تقدمي، أو قادرة على ابتلاعه وإغراقه في بطنها. في الوقت الذي كان يصرخ فيه اللبنانيون رافضين "العونية" وسطوة حزب الله على بلدهم، كان العونيون على الطريقة الأسدية يلجؤون إلى إعادة تجديد بيعتهم، من خلال تنظيم تظاهرات مؤيدة، ترفع فيها لافتات لعون ولتياره، بخلاف كل التظاهرات التي شهدتها المناطق اللبنانية المختلفة، وترفع فيها الأعلام اللبنانية وتلتقي على مطالب جامعة.
والتلازم ما بين "هوموبعثستيكوس" والهومو عونستيكوس" هو تدمير المجتمع وبناه الفكرية والثقافية، لحساب الشخصانية، المختصرة بالقائد الخالد. وينطلق هذان المفهومان من مبدأ تدمير الدولة ومؤسساتها، مع ما يعنيه من تحطيم لمفهوم "الدولة الوطنية" أو الدولة الأمة، لحساب نصف جماعة اجتماعية أو سياسية أو طائفية، تريد أن تسطو على كل شيء. ولتحقيق سطوتها، تجد هذه النماذج نفسها حاجة لإسرائيل مثلاً، التي تلتقي مع الشخصانيات العربية على ضرب مفهوم منطق الدولة، فتتضح المعادلة أكثر، بمقولة أمن إسرائيل من أمن سوريا الأسد، ويصبح الأسد حاجة
صعود إيران الإسلامية، جاء بعد فشل الناصرية كتجربة قومية استثنائية، وبعد فشل الوحدة السورية المصرية، وصولاً إلى هزيمة حزيران ١٩٦٧ والتي كشفت هشاشة النظام المصري
وضرورة إسرائيلية، الأمر الذي يتكامل مع نظرية لبنانية عونية بأن لا خلاف إيديولوجي مع إسرائيل، ولها الحق أن تعيش بسلام. والكلام لوزير الخارجية اللبناني جبران باسيل وهو صهر ميشال عون وأقرب المقربين إليه.
والغريب هنا، هو التقاء هؤلاء بتحالف عميق مع إيران، التي أيضاً لديها غاية أساسية في توسيع مشروعها الذي يقوم على ضرب الحواضر العربية وهدما أسسها الدولتية. هنا ربمّا تجدر العودة إلى المفكر العربي السوري الياس مرقص، والذي يعتبر أن صعود إيران الإسلامية، جاء بعد فشل الناصرية كتجربة قومية استثنائية، وبعد فشل الوحدة السورية المصرية، وصولاً إلى هزيمة حزيران ١٩٦٧ والتي كشفت هشاشة النظام المصري. إلى بروز الساداتية البراغماتية الذاهبة إلى إسرائيل، والأسدية التي تهدف إلى سحق الإنسان.
ويربط مرقص بين فشل المشروع العربي التقدمي وبروز إيران كنموذج متطرف راديكالي يعيد العرب إلى زمن كانوا يظنون أنهم تجاوزوه، وهو المشروع المذهبي التقسيمي الذي يلتقي بشكل أو بآخر مع الإسرائيلي على تدمير البنى العربية. المشكلة الأخطر، أنه في السابق كانت الغاية تركز على ضرب النظم العربية أو المؤسسات، بينما حالياً وفي إطار الثورات المضادة، فإن ما يتم التركيز على ضربه هو الإنسان العربي، عبر شخصنته "أسدياً أو عونياً" مثلاً، فيصبح مفتقداً لأي مفهوم وطني، مبني على فكرة، إنما وجوده يرتبط بشخص، كـ"الأسد أو نحرق البلد"، و"الله لبنان عون وبس". هنا حصراً يكمن تلازم المسارين بين الشعبين، للخروج على نرجسية "القائدين" والعودة إلى مفهوم الوطنية، بدلاً من العونية والأسدية.


 طرفان استضعفا أميركا.. خصم مدّعى وحليف منبوذ
طرفان استضعفا أميركا.. خصم مدّعى وحليف منبوذ إيران ووقف الرحلات المدنية إلى سوريا.. تقويض الممرات في صراع المعابر
إيران ووقف الرحلات المدنية إلى سوريا.. تقويض الممرات في صراع المعابر إيران وترك غزة لوحدها.. الخوف من فتح جبهات أخرى
إيران وترك غزة لوحدها.. الخوف من فتح جبهات أخرى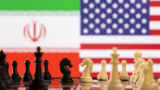 بين طهران وواشنطن.. استراتيجية تغيير الرجالات لترتيب التفاهمات
بين طهران وواشنطن.. استراتيجية تغيير الرجالات لترتيب التفاهمات