قبل 37 عاماً، ما بين 16 و19 أيلول 1982، وقعت مجزرة صبرا وشاتيلا. وتحولت ذكراها إلى عنوان لمأساة الشعب الفلسطيني، المستمرة منذ نكبة 1948 وحتى اليوم.
وقائع المجزرة معروفة بفظائعها، والفاعلون فيها معروفون بالأسماء. المسؤولية عن ارتكابها تقع على عاتق إسرائيل أولاً، بجيشها الذي كان يقوده آرييل شارون. المرتكبون المباشرون للقتل هم مجموعتان: ميليشيا "جيش لبنان الجنوبي" بقيادة سعد حداد، وميليشيا "القوات اللبنانية" بقيادة إيلي حبيقة.
بعد شهر ونصف على المجزرة، قرر رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية إسحاق كاهان أن يتولى بنفسه رئاسة لجنة تحقيق خاصة حول ما حدث في صبرا وشاتيلا. وبعد ثلاثة أشهر فقط، خلصت لجنة كاهان إلى إدانة آرييل شارون كونه "تجاهل إمكانية وقوع المجزرة، ولم يسع للحيلولة دونها" (فيما بعد، ستوضح شهادات ضباط وجنود إسرائيليين أن شارون كان مذنباً أكثر من ذلك بكثير: تسهيل وتشجيع ارتكاب المجزرة ومراقبة حوادثها عن كثب).
استطاعت إسرائيل عبر هذه اللجنة التملص من مسؤوليتها كدولة، والحد من الضرر الذي لحق بسمعتها وسمعة جيشها، وإن فشلت بتبرئة نفسها، خصوصاً وأن تاريخ إسرائيل، قبل صبرا وشاتيلا وبعدها، لا يخلو من المجازر والارتكابات التي لا عدّ لها بحق الشعب الفلسطيني.
على المقلب اللبناني، أُدرجت المجزرة في سياق الحروب اللبنانية المتعددة، وكعملية ثأر لاغتيال الرئيس المنتخب بشير الجميل. أي تمّ طمس الحدث وحرمانه من صفته كجريمة ضد الإنسانية، وكجريمة إبادة جماعية ارتكبت ضد مجموعة سكانية عزلاء. والأسوأ من ذلك، أن لا تحقيق رسمياً أُجري لكشف الوقائع أو حتى معرفة عدد الضحايا على وجه الدقة، رغم أن المجزرة وقعت على أراض لبنانية، بل وثمة بين الضحايا مواطنون لبنانيون، عدا عن غياب أي مسعى لتحديد المسؤولية وتسمية المرتكبين. إذ كان الحل السهل عند الجميع، رمي المسؤولية على "العدو الإسرائيلي"، بما يريح من عناء البحث عن الحقيقة.
هكذا، يصير حبيقة بطلاً قومياً وصديقاً لعصبة آل الأسد وجزءاً من "الأحزاب والشخصيات الوطنية والقومية والإسلامية" التي ترعاها وتدعمها الأجهزة السورية في لبنان
بعد ثلاث سنوات فقط، وصل المسؤول المباشر عن المجزرة، إيلي حبيقة، إلى دمشق ليرتب اتفاقاً مع النظام السوري ويتحول حليفاً له. هكذا، يصير حبيقة بطلاً قومياً وصديقاً لعصبة آل الأسد وجزءاً من "الأحزاب والشخصيات الوطنية والقومية والإسلامية" التي ترعاها وتدعمها الأجهزة السورية في لبنان.
سرعان ما سيحمل إيلي حبيقة لقب "أبو علي حبيقة" تحبباً وتكريماً له في عيون أتباع "الممانعة" السورية – اللبنانية، ولن يُسأل مرة عن تاريخه وعن اقترافاته، طالما أنه بات مقرباً من حافظ الأسد شخصياً وخادماً أميناً للسياسات السورية ومخابراتها في لبنان.
في تلك السنة، 1985، ستبدأ حرب الأسد على المخيمات الفلسطينية في لبنان، منعاً لعودة منظمة التحرير وياسر عرفات إليها. وستخوضها ميليشيات شيعية. المفارقة أن مجزرة 1982 استمرت ثلاثة أيام. أما حرب المخيمات فاستمرت ثلاث سنوات وشهرين، قضى فيها من الفلسطينيين أضعاف ضحايا المجزرة، وتم فيها تدمير شبه كلي لصبرا وشاتيلا خصوصاً.
بالطبع، لم يُنظر إلى ما حدث خلال تلك السنوات الثلاث على أنها "مجزرة" أو جريمة. جميعهم، الفلسطينيون واللبنانيون والسوريون أدرجوها في سياق عاديات حروب الأهل حتى ولو فاقت فظائعها فظائع الحروب مع العدو القومي.
بتدبير من المخابرات السورية، جاء انتخاب إيلي حبيقة نائباً عن الدائرة الانتخابية التي تضم المخيمين!
أفدح من ذلك، وبعد ست سنوات على نهاية حرب المخيمات وعشر سنوات على ذكرى مجازر صبرا وشاتيلا، وبتدبير من المخابرات السورية، جاء انتخاب إيلي حبيقة نائباً عن الدائرة الانتخابية التي تضم المخيمين! لا بل وكوفئ بتسميته وزيراً للطاقة.
تطرح علينا كل هذه الوقائع مشكلة أخلاقية سياسية لا يمكن حلّها إطلاقاً عبر رمي المسؤولية على إسرائيل أو العدو الخارجي أو "المؤامرة". وأول المشكلة هو ما أشرت إليه في تعبير "عاديات حروب الأهل" أي جعل الجريمة من مظاهر الطبيعة والحياة التي لا تستدعي أي سؤال أخلاقي. إنها اضطرار أو ضرورة وربما واجب أحياناً، بل هي ملازمة لـ"السياسة" بما لا يستدعي أي استنكار أو اعتراض أو إدانة. الآخرون، الأغيار، الأجانب.. هم وحدهم "المجرمون". القتل فيما بيننا ليس سوى قضاء وقدر واضطرار وضرورة محتومة.
على هذا القياس مثلاً، لا يُسأل مثلاً صدام حسين عن المقابر الجماعية لـ300 ألف عراقي. ولا يبذل العراقيون أي جهد لمساءلة النفس كيف حدث ذلك. فصدام حسين لم يقتل كل هؤلاء بيديه. هناك ألوف العراقيين وربما عشرات الألوف ممن شاركوا بجنون القتل الجماعي في كل أنحاء العراق على مدى عقود.. وكثر من هؤلاء على شاكلة إيلي حبيقة في سيرة الصعود إلى السلطة حتى يومنا هذا. لم تتحول كل الوقائع – الفظائع التي ارتكبها نظام البعث العراقي إلى "سؤال" تُبنى عليه ذاكرة ومراجعة.
في سوريا الأسد، كان غياب السؤال عن مجزرة حماة في العام 1982 (سبقت مجزرة صبرا وشاتيلا بأربعة أشهر تقريباً)، وغياب أي محاسبة أو تحقيق أو توثيق، طالما أنه قتل أهلي، هو الممهد "الأخلاقي" لفظاعات أخرى امتدت من مذبحة سجن تدمر إلى ملحمة المعتقلات المظلمة والوحشية طوال ثلاثين عاماً، قبل أن يفتتح النظام السوري المجزرة الشاملة ابتداءً من العام 2011.
يُقال إن عدد ضحايا صبرا وشاتيلا يناهز ثلاثة آلاف شخص. فيما تقول أكثر الإحصائيات تحفظاً إنّ ضحايا حرب النظام السوري على شعبه بحدود نصف مليون شخص. في الواقعة الأولى يتحمل المسؤولية "العدو الصهيوني" وحده، وفي الواقعة الثانية تم ابتكار "المؤامرة الكونية" لتحميلها مسؤولية الموت السوري.
تحولت صبرا وشاتيلا إلى رمز أخلاقي في ضمير العالم. فيما تجهد "الممانعة" لحرمان الضحايا السوريين ليس فقط من المعنى الرمزي لموتهم بل من صفتهم كضحايا
تحولت صبرا وشاتيلا إلى رمز أخلاقي في ضمير العالم. فيما تجهد "الممانعة" لحرمان الضحايا السوريين ليس فقط من المعنى الرمزي لموتهم بل من صفتهم كضحايا. هم مشروع نسيان لا مشروع تذّكر، لأنهم "موتى القضاء والقدر" والاضطرار والواجب. ولا يطرح موتهم أي سؤال أخلاقي. بل ومن الأفضل بعد وصمهم بصفة "التكفيريين" والإرهابيين يصير قتلهم استحقاقاً طبيعياً. وحتى في حال تعذر التهمة، فهم مجرد "مضللين" وكان موتهم خسارة لا يمكن تجنبها.
شرف صفة "الضحية" المظلومة يُمنح فقط للذين يقتلهم العدو الخارجي. هؤلاء جديرون أن يكونوا خبراً في "الميادين" و"المنار" والقنوات الرسمية.. أما مئات الألوف الذي ذبحوا "أهلياً" فلا داعي لأي وخزة ضمير. الجريمة هنا "سياسة" وحسب، بل شرط للسياسة والسلطة. ومن أجل ذلك، يُنحى السؤال الأخلاقي تماماً.
هكذا نشأ التشوه الأخلاقي الذي يطبع الوعي السياسي لمجتمعاتنا. ما نقيس به الخير والشر في أعمال الآخر، الغير، الأجنبي.. هو تماماً معطل في قياس أعمالنا، أهلاً وسلطة وجيوشاً وسياسة. وعلى هذا المنوال، تستأنف دولنا وأنظمتنا وجماعاتنا مجزرة صبرا وشاتيلا آلاف المرات، ويأتي آلاف إيلي حبيقة ويصير "أبو علي" سلطة ودولة ونظاماً ممانعاً وطنياً وقومياً دحراً لـ"المؤامرة الكونية" ودفاعاً عن بقاء الأمة أرض موت ومقابر جماعية وانتصارات إلهية.


 حكومة سعد الحريري لإنقاذ حزب الله أولاً
حكومة سعد الحريري لإنقاذ حزب الله أولاً حرائق لبنان وسوريا.. أو "صناعة" الكوارث
حرائق لبنان وسوريا.. أو "صناعة" الكوارث  إطلاق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية.. لا عزاء لحزب الله
إطلاق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية.. لا عزاء لحزب الله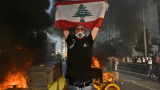 "جهنم" لبنان لم يبدأ بعد
"جهنم" لبنان لم يبدأ بعد حزب الله منتصراً على لبنان.. وفرنسا
حزب الله منتصراً على لبنان.. وفرنسا