شكّلت الحرب الدولية في مواجهة تنظيم داعش في سوريا ( تموز 2014 – آذار 2019 ) مفصلاً استراتيجياً هاماً في السياسة الخارجية الأميركية، ولئن سارعت جميع دول التحالف التي يبلغ عددها ثلاثاً وثمانين دولة، إلى الاحتفاء بقضائها على الإرهاب في سوريا، وفقاً لتلك الدول، فإن الرئيس الأميركي السابق (دونالد ترامب) كان الأكثر حماساً لإعلان ذلك الانتصار، بل يمكن القول: إن نشوة ترامب بإعلانه الانتصار على تنظيم داعش في سوريا تؤكّد حرصه على أن يكون هذا الانتصار إحدى منجزاته الشخصية التي يمكن استثمارها في انتخابات الرئاسة آنذاك، التي لم يفز بها.
اليوم، وبعد مرور ما يقارب العامين على طرد داعش من آخر معاقلها السورية ( الباغوز)، تتحوّل نشوة انتصار التحالف الدولي في مواجهة داعش إلى كابوس مخيف، حيث تتواتر المخاوف الدولية من عودة تنظيم داعش، وبخاصة على أعقاب العمليات المتلاحقة التي شنها التنظيم على قوات الأسد في البادية السورية، وريفي حماة وإدلب، إضافة إلى العمليات الخاطفة التي ينفذها التنظيم في ريفي الحسكة ودير الزور مستهدفاً قوات قسد، ويتزامن الحديث عن عودة داعش مع فيض غزير من التحليلات الرامية إلى البحث عن أسباب عودة التنظيم، وكيفية مواجهتها، مع الحرص الشديد من جانب معظم الأطراف الدولية، على تعزيز التصوّر الذي يختزل داعش بالمقاتلين الأجانب الذين توافدوا إلى الأرض السورية، مع حرصٍ شديد أيضاً على تجاهل العوامل الحقيقية الكفيلة بإنتاج سلالات غير محدودة من الدواعش.
اليوم، وبعد مرور ما يقارب العامين على طرد داعش من آخر معاقلها السورية ( الباغوز)، تتحوّل نشوة انتصار التحالف الدولي في مواجهة داعش إلى كابوس مخيف
لقد كان من أبرز التوافقات التي أجمعت عليها أطراف التحالف الدولي هي القضاء على البنى التحتية لتنظيم داعش، وتدمير مقاره وثكناته وكافة الوسائل الحربية وغير الحربية التي يستخدمها، واستئصال عناصره أينما وُجدوا، وبالفعل فقد أبدع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، وبالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية، في تنفيذ الجزء الأول مما توافقوا عليه ( تدمير البنى التحتية للتنظيم)، ولكن السؤال الذي لم يغب عن الأذهان منذ أن بدأت المواجهات حول ما إذا كان تنظيم داعش يملك بنى تحتية في سوريا، فهل المدن والبلدات السورية التي استولى عليها داعش هي بنى تحتية تعود له بالأصل، أم أنها بنى تحتية تعود ملكيتها للمواطنين السوريين أو الدولة السورية؟ لقد دمّر التحالف الدولي مدينة الرقة دماراً شبه كامل، وإن الأعداد التي غادرت الرقة من أعضاء التنظيم لا تتجاوز بضعة آلاف، لم يُقتل منهم إلا الأعداد القليلة، وما تبقى في الرقة بعد خروج داعش هو الخراب الذي ما يزال قائماً، إضافة إلى المقابر الجماعية التي ما تزال تظهر تباعاً.
ثمة إصرار كبير لدى أبرز الخائفين والمُحذّرين من عودة داعش، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، على المضيّ في استهداف مظاهر الإرهاب الداعشي، دون النظر أو الاهتمام بأسباب تفريخه أو عوامل نشوئه الحقيقية، ليس جهلاً بطبيعة هذه السياسات المتناقضة، ولكن انسجاماً مع الاستراتيجيات التي تمليها مصالح كل طرف، وبهذا تغدو مواجهة الإرهاب في سوريا ليست هدفاً بحدّ ذاتها، بقدر ماهي فصول تنفيذية تخدم رؤى وسياسات أكثر أولوية لدى الأطراف الدولية، وبهذا أيضاً، تصبح الجغرافية السورية قابلة لتدوير الإرهاب على الدوام، وذلك من خلال محاولات استئصاله من جهة، ثم العمل على تغذية عوامل إنتاجه من جهة أخرى.
لقد أتاح نأيُ الولايات المتحدة الأميركية، ومن خلفها الاتحاد الأوروبي، عن الاهتمام المباشر والجدّي بالقضية السورية، لنظام الأسد وحلفائه الروس والإيرانيين، أن يكلّلوا مُنجَزهم العسكري المتمثل بحالات الخراب المادي والقتل البشري لملايين السوريين وتهجير أضعافهم، ببداية جديدة لمشروع خراب مجتمعي، يبدأ بالمحاصرة وتشديد الخناق على الواقع المعيشي لحياة السوريين، وإجبارهم على الانصياع الكامل لما تمليه عليهم مقتضيات استمرار وجودهم أو بقائهم على قيد الحياة، إلى درجة يصبح فيها التفكير بكيفية تأمين الحدّ الأدنى من مقومات العيش كابوساً يؤرق المواطن، فحين يصبح الحصول على ربطة من الخبز وأسطوانة الغاز والنزر القليل من الخضار، ضرباً من البراعة، فعندئذٍ يتحوّل سلوك المواطن من سعيٍ مشروع لتأمين لقمة العيش، إلى نمط من التحايل على المعيشة، وعند هذا الحدّ، تضيق شيئاً فشيئاً منافذ القيم، وتنمو نوازع الجنوح نحو شتى أشكال الاستعداد للانحراف، تحت ضغط الحاجة حيناً، وحيناً آخر تحت تأثير الإحباط وحالات البؤس التي تبدأ تستوطن النفوس، موازاةً مع حرص شديد من جانب منظومة الأسد على الإمعان في ترسيخ الضغط الاقتصادي والبؤس الاجتماعي، سعياً إلى خنق وتجفيف منابع الوعي الذي ينبغي أن يبقى مخنوقاً ضمن آفاق الجوع والخوف والفاقة.
لعل الانتقال من التخريب المادي إلى التخريب القيمي في المجتمع السوري هو الحالة المثلى التي تراها إيران كفيلة بتسهيل مهامها حيال السوريين، إذ تصبح محاولات استقطاب الشباب السوري لتجنيدهم وإلحاقهم بالميليشيات الطائفية مواتية جداً، وذلك في سياق عملية لا تخلو من الابتزاز الأمني حيناً، والإغراء المادي حيناً آخر، و في ظل غياب فرص العمل وشيوع الشح الاقتصادي وندرة موارد العيش، يصبح لواء فاطميون، ولواء زينبيون، هما الملاذ الذي يُؤوي المئات من الشباب المُحبط اليائس، ليكونوا وقوداً في الحرب القائمة على أهلهم وأوطانهم.
وفي ظل حالة الانسداد الاقتصادي التي تهيمن على المجتمع السوري، ثمة سعيٌ محموم لميليشيات إيران، وبالتنسيق مع ميليشيات الأسد، إلى إيجاد آفاق اقتصادية موازية أو بديلة، قوامها إغراق المدن والبلدات السورية بالمخدرات، وتنشيط الاتجار بها،( من القلمون الشرقي وسرغايا والزبداني، مروراً بالقصير، ووصولاً إلى البوكمال والميادين شرقاً) إلى درجة باتت تُباع فيها حبوب ( الكبتاغون) في محال الألبسة والمواد الغذائية، وبأسعار زهيدة ( 250 ل . س ) سعر الحبة الواحدة، وذلك تسهيلاً لتداولها من جهة، ونظراً لإنتاجها المحلّي من جهة أخرى. وما ينبغي التأكيد عليه، هو أن الاعتماد على إنتاج المخدرات والاتّجار بها، بغية إيجاد بديل اقتصادي، هي سبْقٌ تجاري واقتصادي حقق فيه حزب الله اللبناني ريادةً عالمية، مما حدا بإيران لاستنساخها في سوريا، فضلاً عن أن إنتاج المخدرات والاتجار بها يحظى بفتوى خمينية قديمة، بشرط أن يتم بيعها للعدو، لاستنزافه مالياً، وتخريبه قيمياً، وفقاً للفتاوى الدينية الإيرانية.
لم يكن مسعى إيران الرامي إلى السيطرة على المجتمع المحلي السوري واستثماره وفقاً لأجنداتها مرضياً للجانب الروسي الذي لم يتوان هو الآخر، وكخطوة مماثلة لنظيره الإيراني، بالبدء بتجنيد العشرات من السوريين، ومعظمهم ممن يوجدون ضمن ميليشيا الدفاع الوطني، أو ممن لم يلتحقوا بالخدمة العسكرية داخل قوات النظام، سواءٌ بإدماجهم في الفيلق الخامس، أو تأطيرهم بمجموعات خاصة تابعة لقاعدة حميميم، وذلك من خلال أساليب مشابهة لما تقوم به ميليشيات إيران، إذ يبلغ الراتب الذي يدفعه الروس للواحد من هؤلاء ( بين 70 – 90 دولارا) بينما لا يتجاوز ما يدفعه نظام الأسد لجنوده وميليشياته ( 30 دولارا) في أفضل الحالات.
لعل قدرة نظام الأسد وحلفائه على إزاحة أو تحطيم الحصانة القيمية للمجتمع السوري، من خلال ممارستهم لشتى أشكال القهر والإذلال المعيشي، بعد تحطيمه مادياً واجتماعياً، يجعل من الأرض السورية مجالاً رحباً لظهور أنماط جديدة للإرهاب، تتجاوز التصنيفات التقليدية، طالما أن الإرهاب هو مُعطى تاريخي ذو بواعث سياسية واقتصادية، ولا يمكن حصر منابعه بالمصادر الدينية، الأمر الذي يؤكد على أن استمرار الأطراف الدولية ذات الحضور في الشأن السوري على إدارة الصراع فقط، دون الدخول بعملية تفكير جدي لإيجاد حل سياسي عادل ينهي مأساة السوريين، ما هو إلّا مهادنة حقيقية لحالة التخريب التي يمارسها النظام وأعوانه منذ عشر سنوات، كما أن السعي الدولي إلى محاربة الإرهاب في مظاهره الداعشية، والسكوت أو التغاضي عنه في منابعه الأسدية الإيرانية الروسية، ما هو إلّا إعادة إنتاج للإرهاب، وربما بسلالات وتصنيفات جديدة، وليس سعياً للقضاء عليه.


 إيران الوصيّة على الأسد
إيران الوصيّة على الأسد حين يكون الإبداع ضحية الإيديولوجيا
حين يكون الإبداع ضحية الإيديولوجيا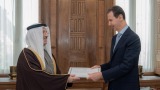 دعوة بشار الأسد إلى قمة المنامة
دعوة بشار الأسد إلى قمة المنامة اللقاء المُرتقب للجنة الدستورية مصلحة سورية أم حاجة إقليمية؟
اللقاء المُرتقب للجنة الدستورية مصلحة سورية أم حاجة إقليمية؟