فيما تستمر قوات نظام الأسد وحليفاتها من ميليشيات إيران بتضييق الخناق على مدينة درعا بهدف اجتياحها، ثم السيطرة التامة عليها، يستمرّ - من جهة أخرى – المتسائلون والمفسرون في إيجاد قرائن يمكن من خلالها تفسير السلوك العدواني الراهن حيال درعا، فثمة من يربط بين ما يجري وما تسعى إليه إيران من إقامة منطقة نفوذ في الجنوب السوري تكون معقلاً لميليشيات إيران، وذلك على غرار معقل حزب الله في الجنوب اللبناني، وسواء أصحّت تلك التصورات وسواها أم لا، فإنه يمكن التأكيد على أن مقوّمات العدوان الأسدي في الأصل موجودة، بعيداً عن أيّة مؤثرات خارجية، إذ ثمّة حقائق لا يمكن نكرانها أو تجاهلها، وكذلك لا يمكن الزعم بأن نظام دمشق لم يعد محكوماً بنزعة الانتقام التي باتت من أبرز السمات الناظمة للعقلية الأسدية.
ولعل من أبرز تلك الحقائق أن مدينة درعا –من الناحية الفعلية- هي من أوصلت قطار الثورة السورية إلى سكة ثورات الربيع العربي، وأن رجولة ونخوة أبناء درعا هي التي لم تتح في آذار 2011 (لعاطف نجيب – رئيس فرع الأمن السياسي وابن خالة بشار الأسد) بأن يجعل من تنكيله بأطفال درعا ضوءاً أخضر باستمرار انتهاك كرامة السوريين، وربما كانت تلك الحادثة إيذاناً بوجه النظام يؤكّد أن استباحة المنظومة الأمنية لأرواح السوريين وكرامتهم والتي باتت نهجاً مألوفاً لدى المخابرات الأسدية منذ مطلع الثمانينيات، لا يمكن أن تستمر. ولعل ثانية تلك الحقائق تكمن في عدم قدرة مخابرات الأسد وجلّاديه –آنذاك– في حصر تداعيات عدوانهم الآثم على الموطنين بذوي الأطفال المغدورين وعائلاتهم فحسب، بل سرعان ما تحوّلت ردّة الفعل الشعبية إلى غضب جماهيري عارم لا يستهدف عاطف نجيب شخصياً فحسب، بقدر ما يستهدف السلطة الاعتبارية لدولة الأسد، وبهذا تكون مدينة درعا هي اليد السورية التي نالت من الهيبة الأمنية الأسدية، ثمّ حطّمت جدار الخوف الذي أقامته السلطة حائلاً دون أي احتجاج شعبي مهما تفاقم الظلم والجور بحق المواطنين. أضف إلى ذلك أن روح التضامن والتكاتف الذي ظهر بأبهى تجلياته بين مواطني مدن وبلدات وقرى محافظة درعا في عام 2011، ووقوفهم صفّاً واحداً في وجه آلة القمع الأسدية، وكذلك قدرتهم على تحويل تلك الاحتجاجات الشعبية إلى نواة ثورة شعبية سرعان ما انطلقت شرارتها بسرعة مذهلة لتعم جميع المحافظات السورية، كل ذلك قد أفضى إلى قناعة لدى سلطات دمشق بأن درعا هي أوّل يد سورية تجاسرت على البدء بنزع الأنياب الأمنية من شدق السلطة المتوحشة.
بعد التدخل العسكري الروسي المباشر في أواخر أيلول 2015، بدأت موازين القوى تتغيّر، إذ كان اجتياح القسم الشرقي من حلب وتهجير ما يقارب مئتي ألف من سكانها تهجيراً قسرياً خارج المدينة في نهاية العام 2016، أولى علائم استراتيجية جديدة يسعى نظام الأسد وحلفاؤه إلى تطبيقها، وتتمثل بعدم الاكتفاء بسحق المعارضة المسلّحة واستهداف البنى التحتية والمستشفيات ودور العبادة ومنازل المدنيين فحسب، بل تسعى أيضاً –وهذا هو الأهم– إلى استئصال الحاضنة البشرية للثورة، وذلك من خلال الإيغال في القتل والتدمير وإطباق الحصار، بغيةَ وضْع السكان المدنيين أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الموت تحت وابل القذائف وإما النزوح خارج بلداتهم ومدنهم، وهكذا كان منهج التغيير الديموغرافي – عبر الترحيل بالباصات الخضر – هو الاستئصال الأكثر جذرية لمن تجرأ و رفض الخضوع لسلطة الأسد، وهكذا أيضاً، كان مصير سكان الغوطة الشرقية، وكذلك سكان القلمون وشمال حمص، إلّا أن المدينة الوحيدة التي لم يستطع نظام الأسد وحلفاؤه استئصال حاضنتها الثورية وترحيل سكانها هي مدينة درعا، فعلى الرغم من ضراوة المعركة التي واجه بها ثوار درعا قوات النظام وحليفه الروسي في صيف عام 2018، وكذلك على الرغم من قدرة الروس على إحداث بعض الشروخات في صفوف بعض السياسيين وقادة الفصائل الذين تحوّلوا إلى عرّابي مصالحات فيما بعد، فإن النسيج الشعبي الثوري لأهل حوران ظل متماسكاً وعصيّاً على الاختراق، ولعلّ أبرز سمات تماسك وصلابة هذا النسيج هو مرور ثلاث سنوات على المصالحات، سعى خلالها النظام وحلفاؤه الإيرانيون، ولم يدّخروا وسيلة أو جهداً من أجل إيجاد حواضن لهم في المنطقة، ليتمكّنوا – بالتالي – من بسط نفوذهم العسكري والسياسي والاجتماعي، إلّا أن النتائج كانت على الدوام تشير إلى خلاف ما أرادوا، إذ ظلت الميليشيات الطائفية الإيرانية نقطة استهداف دائمة لثوار المنطقة، كما ظلّت هي الظهير الأبرز لقوات النظام في قناعة معظم سكان حوران.
لعلّ الخطوة الأكثر حسماً، بل الصفعة الأكثر وضوحاً لنظام الأسد، تمثلت في رفض ثوار درعا وعدم سماحهم لقوات النظام بأن تكون أرض حوران مسرحاً لمهزلة انتخابات بشار الأسد
ولعلّ الخطوة الأكثر حسماً، بل الصفعة الأكثر وضوحاً لنظام الأسد، تمثلت في رفض ثوار درعا وعدم سماحهم لقوات النظام بأن تكون أرض حوران مسرحاً لمهزلة انتخابات بشار الأسد في السابع والعشرين من أيار الماضي، وكأن درعا كانت تقوم بإبلاغ الأسد – من خلال هذا الرفض – : إنك قاتل مجرم لا تصلح أن تكون حاكماً للبلاد.
ولئن استجمع بشار الأسد بدفعٍ من إيران، جميع ذرائع العدوان على درعا، مدفوعاً بنزعة انتقامية حاقدة، تمثلت بزيارة وزير دفاعه مهدّداً باجتياح المدينة ورفع علم النظام على مئذنة الجامع العمري، فإن مقوّمات صمود درعا هي الأخرى موجودة، إلّا أن وجودها لم يكن بحوزة سكان حوران وحدهم، بل بحوزة السوريين جميعاً لو أنهم اصطفوا وتكاتفوا وتفازعوا كما تفازع وتكاتف أهل حوران، كان بإمكان الائتلاف مثلاً – كممثل سياسي للثورة – أن يعلن عن مقاطعته لأي مسار تفاوضي احتجاجاً على خرق اتفاقيات خفض التصعيد من جانب نظام الأسد، وكان يمكن لهيئة التفاوض أن تلوّح بحلّ نفسها إن استمر العدوان على درعا، وكان يمكن لوفد اللجنة الدستورية أن يعلن عن مقاطعته لأي لقاء قادم مع وفد النظام احتجاجاً على هذا العدوان، وكذلك كان يمكن أن يعلن ثمانون ألف مقاتل في الشمال السوري (ينضوون تحت مسمى الجيش الوطني) أن يلوّحوا بالتنصل من جميع اتفاقيات وقف إطلاق النار، ويعلنوا استعدادهم بإشعال جبهات الشمال جميعها إن أقدم النظام على اجتياح درعا، ربما لدى السوريين الكثير مما يفعلونه، سياسياً وعسكرياً وشعبياً، إلّا أن هذا الفعل المُنتَظر أو المأمول، ربما تحوّل إلى ضرب من الأمنيات أو أحلام اليقظة، أو ربما بات مزيجاً من السذاجة والشعبوية في نظر البعض، وذلك بسبب الواقع المتردّي والمبعثَر لقوى الثورة من جهة، وبسبب غياب القرار الوطني لكيانات المعارضة من جهة أخرى.
من درعا انطلقت شرارة الثورة، وهي اليوم – على الرغم من حصارها – تعطي الفرصة للسوريين من جديد، ليس لاستعادة الوجه الناصع للثورة فحسب، بل لقلب الطاولة – كما يقال – على جميع عوامل الخراب والدمار في الثورة، ولكن واقع السوريين يذهب باتجاهات أخرى.


 إيران الوصيّة على الأسد
إيران الوصيّة على الأسد حين يكون الإبداع ضحية الإيديولوجيا
حين يكون الإبداع ضحية الإيديولوجيا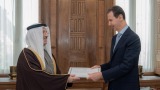 دعوة بشار الأسد إلى قمة المنامة
دعوة بشار الأسد إلى قمة المنامة اللقاء المُرتقب للجنة الدستورية مصلحة سورية أم حاجة إقليمية؟
اللقاء المُرتقب للجنة الدستورية مصلحة سورية أم حاجة إقليمية؟ عن وثيقة المناطق الثلاث
عن وثيقة المناطق الثلاث