في تعريف بسيط وبديهي لـ"الضعيف"، فهو الذي يستشعر الخوف ويعيش على قلقه الدائم خوفاً من خسارة أو اضمحلال. يعرف الضعيف مكامن ضعفه، فيذهب إلى مواجهتها برفع صوته، أو الرهان على أوهام، لعلّه تستعيضه عن ما يفتقده.
يعرف الضعيف نقاط الضعف، لكنه يجهل نقاط القوة لديه، أو يتكاسل عن السعي لاكتشافها والمراكمة عليها. فتتكون لديه شخصية رافضة لأي نقاش، متعالية عن أي اختلاط. خبر المواطنون العرب هذه التجربة في تخالطهم مع اللبنانيين، وهذه تجربة تبدأ من الطائرة التي يستقلّها السياح الذين يقصدون لبنان، فيواجهون بتعال من فريق "خدمتهم" اللبناني. هذا فيما يتعلّق بالخدمات الواجب توفيرها للسياح، فكيف بالحري، إذا ما كانت الحالة تحتّم التعاطي مع "لاجئين" "ضعفاء" هاربين إلى لبنان طلباً لأمن وأمان.
تلك تكون الفرصة الأولى للضعيف، كي يثبت قوته، فيلجأ إلى توهمات وتخيلات، تحيله إلى الرهان على استضعاف الضعيف، لعلّ هذا الاستقواء يشعره ببعض من قوته. لكن مشكلة المجتمع اللبناني، أن تلك الشوفينية الناجمة عن ضعف، لا تقتصر تجاه العرب بالنظرة الاستعلائية عليهم، ولا تجاه الغربيين بالنظرة الدونية تجاههم. معاناة المجتمع اللبناني أعمق بكثير، وأبعد من عنصرية تجاه اللاجئين. تلك "العنصرية" تجلّت قبل فترة في لبنان، بين مسيحيين ومسلمين لبنانيين، على خلفية التملّك والحق بالإيجار في إحدى مناطق ضواحي بيروت. يستشعر أهالي المنطقة المسيحية خطراً وجودياً من توجه المسلمين لملك الشقق في منطقتهم أو حتى استئجارها. هنا يظهر عمق الأزمة "اللبنانوية" في رفض قبول الآخر بغية "الحفاظ على التنوع". وعلى السوريين والفلسطينيين عندما يروا مصائب اللبنانيين فيما بينهم أن تهون عليهم مصائبهم على الرغم من فداحتها.
ليست العنصرية اللبنانية المتجلية تجاه السوري والفلسطيني، تختلف عن عنصرية طرف لبنان تجاه الطرف الآخر
ليست العنصرية اللبنانية المتجلية تجاه السوري والفلسطيني، تختلف عن عنصرية طرف لبنان تجاه الطرف الآخر. وهذا يحتاج إلى بحث عميق في البنية الثقافية اللبنانية، التي تبنى على سادية قاتلة. تلك السادية تهوى التفوق ولو على كوارث أو في التابوت. إنها جزء من طفولتنا، ننمو عليها، ولا نشذّ عنها، فحديث "القرايا" يحكم "السرايا". والمقصود بحديث القرايا هذا، أن التركيبة الثقافية السياسية والاجتماعية اللبنانية، ترتكز على أحاديث أمجاد القرى، وما تختزله من نضال وعنفوان، يأبى التراجع ولا يضع في حساباته أي احتمال للخطأ. تختصر هذه "المقومات" بلغة عشائرية أو قبلية، يرفض القائمون بموجبها، الخروج عنها. وفيها لا مجال للحكم بالصح أو بالخطأ، ولا مجال للدخول في لعبة العقل وتحكيمه أو حتى تشغيله. تلك اللغة منزلة لا ريب فيها ولا نقاش. كـ لبنان عنوان للعيش المشترك مثلاً، هذا توصيف لا يمكن النقاش فيه، بينما لا يحتاج المرء بحثاً عميقاً لاكتشاف الاقتتال الأهلي الدائم أو الصراع على مواقع النفوذ السلطوية بين القوى "المتنوعة".
في اللافرق اللبناني، بين حديث القرايا وحكام السرايا، تكمن مناعة "المجتمع" في لبنان. مناعة عصية على أي نقض أو تقويم، والرحلة طويلة، من أحاديث القرى في المنازل، إلى المجتمع الأوسع في المحلة أو المنطقة، ولاحقاً إلى ما هو أوسع في المدرسة وما بعد مراحل الارتقاء التعليمي. واللغة المعممة لبنانياً لا تختلف في مضامينها عن أحوال "القبائل أو الطوائف". السردية الثابتة قائمة من منهاج التربية، إلى لغة الصالونات. وهي تقوم على عناوين لا يفرغ اللبناني من التغنّي بها: "كالنصف ساعة من الجبل إلى البحر، ولبنان أجمل بلدان المنطقة، ولا يعلو على اللبناني الذي يجيد تعدد اللغات ويحسن الإستقبال والتقديم، ولبنان صحيفة العرب، ومنبر مضطهديهم".
تلك القناعات الراسخة لبنانياً، لا تعدو كونها جزءاً من جنون العظمة، أو نرجسية غير ناجمة سوى عن استشعار بفراغ تواق دوماً لما يسدّه. وغالباً من يصرخ مدعياً اختزان فعل القوة، يكون علمياً ساعياً إلى التعبير عن ما يفتقد، فيستعيض عن القوى الواقعية أو الفعلية بادعاء وجودها. وما ينطبق على عامل القوة، ينطبق على غيرها من القضايا والعناوين، ليس آخرها الادعاء بالوطنية الزائدة، أو طفرة الاستشعار الوطني، غير المبني على أكثر من ادعاءات.
تلك النرجسية وحدها، تحتّم الاستمرار تسليماً بالأحوال، دون الاستشعار بخطأ أو بما يستدعي التفكير ملياً بأحوال الأهوال. وغالباً ما تؤدي النرجسية إلى ما يشبه تعطيل أطر التفكير، وحصرها في خانة واحدة، تراكم على الإيجابيات فقط، أو تنظر إلى السلبيات وكأنها إيجابيات لا نقاش فيها، وبمجرد بحثها أو التفكير فيها، يعني أن الخارج عن تلك السردية النمطية والنرجسية، أصبح مخوّناً وقليل الشعور الوطني.
هذا الضعف، وحده الذي ينتج مثل نظرية التفوق الجيني، أو العرقي، التي يسوّق لها البعض ليست إلا سياق لإظهار التفوق الاجتماعي داخل البنية الاجتماعية اللبنانية، والتي ترتكز على عاملين في هذه المرحلة، عامل الادعاء لدى الطرف المسوق لهذه النظرية، والقادر على حشد التأييد لها باللعب على وتر عصبي وطائفي مغلّف بصيغة وطنية تختزل الحق والحقيقة، وعامل آخر يرتكز في أساسه على القوة التي لا يمكن تجاهلها أو تخطيّها، فيوضع الطرف القوي في خانة الطرف المتفوق. بينما الطرف الضعيف يبقى مهجوساً ومكبلاً وخاضعاً لموازين يفرضها العاملان السابقان. وهذا النموذج يتعمم أكثر في مختلف المجالات الإجتماعية والسياسية، ومن نتاجاتها هذا الانفصام في التعاطي مع الأحداث، وفوارقها بين طرابلس وحي الشراونة في بعلبك مثلاً. بين تهدئة الاشتباكات في الشراونة والدخول في مفاوضات ووقف العملية العسكرية، مقابل الإصرار على استكمال السحق والقصف في عرسال أو عبرا أو غيرهما.
وتبقى المشكلة البنيوية في هذا المجتمع، أنه مهجوس بعامل الإثارة، ينساق غريزياً إليها، إما عاطفياً أو سياسياً أو مذهبياً. والغريزة هنا، تتخطى عامل الإثارة إلى تأليه الصنميات بحيث تُفقد أي إمكانية للنقاش أو الانتقاد، لأنه يعني مسّاً بالذات الإلهية للقائد الملهم، أو انتقاصاً للجماعة الطائفية المعنية، أو في المقابل، تدفع أبناء جماعة معينة إلى استشعار حالة انتقاص أو دونية دائمة تجاه الجماعات الأخرى، صاحبة القوة أو صاحبة التفوق. حالة الانتقاص اللبنانية، والفشل الذريع للمنظومة المتكاملة، تحتاج في حالات الفصام، إلى ما يبرر وجودها، فعندها يستسهل هؤلاء إلقاء المسؤولية على "الغريب" الذي يجسّده حالياً اللاجئ السوري أو الفلسطيني. وتلك النرجسية غالباً ما تكون ذات عامل تدميري للمجتمع، كما حصل بين المسلمين والمسيحيين في أكثر من محطة سياسية. والآن يتكرر النموذج ذاته، من خلال ممارسة الاستقواء على سوريين ضعفاء، فينعكس توتراً إسلامياً مسيحياً، تتفجر معه أزمة سكن المسلمين في مناطق مسيحية. تلك المشكلة لم تكن لتظهر، علماً أن القرار بشأنها اتخذ قبل سنوات، لكن ما أعاد إحياءها هو تلك العصبية تجاه اللاجئين، من بيئة معينة، فشعرت البيئة الأخرى بأن الاستقواء ماض نحوها.


 طرفان استضعفا أميركا.. خصم مدّعى وحليف منبوذ
طرفان استضعفا أميركا.. خصم مدّعى وحليف منبوذ إيران ووقف الرحلات المدنية إلى سوريا.. تقويض الممرات في صراع المعابر
إيران ووقف الرحلات المدنية إلى سوريا.. تقويض الممرات في صراع المعابر إيران وترك غزة لوحدها.. الخوف من فتح جبهات أخرى
إيران وترك غزة لوحدها.. الخوف من فتح جبهات أخرى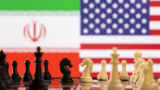 بين طهران وواشنطن.. استراتيجية تغيير الرجالات لترتيب التفاهمات
بين طهران وواشنطن.. استراتيجية تغيير الرجالات لترتيب التفاهمات