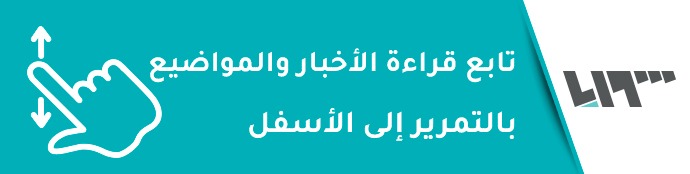نشر "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسيات" دراسة تحدث فيها عن العقوبات الغربية على الاقتصاد السوري، وسياسة نظام الأسد في التعامل مع الأزمة وفشل مؤسساته في إدارتها.
وقالت الدراسة، التي أعدها الباحث السوري المتخصص بالاقتصاد السياسي، إبراهيم الياسين، إنه "في ضوء التحديات الاقتصادية الكبرى والأوضاع المعيشية الصعبة، وانتشار فيروس "كورونا" وصعوبة الحصول على لقاحات له، يتشارك السوريون الذين يعيشون في مناطق سيطرة الأطراف المتنازعة تداعيات تدهور الوضع الاقتصادي، وهي نتيجة طبيعية لحرب مستمرة منذ أكثر من عشر سنوات، قُتل فيها مئات الآلاف وتحوّل الملايين إلى لاجئين ونازحين".
وأضافت أن القرارات الأخيرة الصادرة عن إدارة التخطيط الاقتصادي جاءت "لتستنزف ما بقي من مُقدّرات الفئات الفقيرة والهشّة لمصلحة أمراء الحرب"، مشيراً إلى أن العقوبات الغربية "أدت دوراً إضافياً في تفاقم تدهور الوضع الاقتصادي للشعب السوري، إذ باتت الأطراف المستهدفة بالعقوبات تستهدف بدورها دخل المواطنين البسطاء، عمالاً وموظفين في القطاعين العام والخاص، من أجل تعويض خسائرها، وتزيد إدارة نظام بشار الأسد للاقتصاد السوري وأزماته الوضع سوءاً".
442 مليار دولار خسائر الاقتصاد السوري
ووفق الدراسة، فإن التقارير الأممية تؤكد أن سوريا تكبدت خسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، تُقدّر بنحو 442 مليار دولار، خلال ثماني سنوات من الحرب، لتأتي على جملة من المكاسب الاجتماعية والاقتصادية التي تحققت بشق الأنفس، كما تُظهر التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، صورة قاتمة عن الوضع في سوريا.
من جانبها، تحاول حكومة نظام الأسد إدارة ما بقي من موارد من خلال قرارات وقوانين تعكس صعوبة الواقع الاقتصادي وشح موارد الدولة، تزامناً مع انهيار الأوضاع المعيشية التي يعانيها المواطنون في مناطق سيطرة النظام.
وفي الوقت ذاته، لا تختلف الحال في شمال غربي سوريا، حيث مناطق المعارضة، عن غيرها، حيث يعيش أكثر السكان على المساعدات الخارجية التي كانت مُهدّدة باحتمال إغلاق المعبر الوحيد الذي تمر عبره المساعدات الدولية.
أما مناطق شمال شرقي سوريا، التي تديرها "قوات سوريا الديمقراطية"، فتعتبر الأوفر حظاً بفضل الموارد الباطنية مثل النفط والغاز، إضافة إلى الثروة الزراعية، وعلى الرغم من أن العمل جارٍ بوتيرة متسارعة لإعادة إعمار ما دمّرته الحرب، إلا أنها لم تسلم هي الأخرى من الأزمات الناجمة عن الحرب.
وأشارت الدراسة إلى أن التبرعات الإنسانية التي جُمعت خلال العام الحالي كانت أقل من المأمول، في ظل تردّي الأوضاع الاقتصادية وانتشار جائحة "كورونا"، حيث انخفضت مساعدات الاتحاد الأوروبي بنحو 1.2 مليار يورو، كما انخفضت تبرعات المملكة المتحدة بقرابة 100 مليون يورو، في حين انخفض إجمالي تبرعات الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 120 مليون دولار تقريباً.
ولم يتخذ مؤتمر بروكسل الخامس، الذي عُقده الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بحضور أكثر من 80 دولة ومنظمة دولية، في آذار الماضي، حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، أي إجراءات جادّة من أجل تحقيق الأمان للمدنيين والضغط على الأطراف الفاعلة في اتجاه إطلاق عملية انتقال سياسي.
العقوبات الغربية مستمرة
وعن العقوبات المفروضة على نظام الأسد، أوضحت الدراسة أن العقوبات الغربية، ولا سيما الأميركية، ليست وليدة الأزمة التي تمرّ بها سوريا في العقد الأخير، فتصنيف الولايات المتحدة سوريا "دولةً راعيةً للإرهاب" يعود إلى كانون الأول من العام 1979، وأُضيفت عقوبات وقيود عليها في أيار من العام 2004، وفق الأمر التنفيذي رقم 13338، الذي أدخل قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية لعام 2003 حيّز التنفيذ.
وسعت الولايات المتحدة الأميركية، منذ اندلاع الثورة السورية في آذار من العام 2011، إلى فرض عقوبات إضافية لحرمان نظام الأسد من الموارد التي يحتاج إليها لمواصلته العنف ضد المدنيين، كان أكثرها فاعلية "قانون قيصر"، الذي دخل حيّز التنفيذ في حزيران من العام 2020، واستهدف شخصيات وشركات سورية.
أما العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي، والتي بدأت في العام 2011، فتستهدف الشركات ورجال الأعمال الذين يستفيدون من اقتصاد الحرب ومن علاقاتهم بنظام الأسد، وتشمل تدابير تقييدية تحظر استيراد النفط وبعض الاستثمارات وتجميد أصول خاصة في مصرف سورية المركزي، إضافة إلى حظر تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وكذلك حظر توريد المعدات والتكنولوجيا التي ترصد أو تعترض اتصالات الإنترنت أو الهاتف.
كما أعلنت كندا فرض عقوبات، في أيار من العام 2011، تستهدف عناصر نظام الأسد بموجب " قانون الإجراءات الاقتصادية" الخاصة الذي يُخوّل السلطات الكندية فرض عقوبات اقتصادية على أطراف معينة دفاعاً عن، أو تحقيقاً، للمصالح الكندية.
أما المملكة المتحدة، فقد استمرت في تبنّي العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا حتى بعد مغادرتها للاتحاد، ويهدف نظام العقوبات البريطاني إلى تشجيع نظام الأسد على الامتناع عن الأعمال أو السياسات أو الأنشطة التي تقمع السكان المدنيين في سوريا، إضافة إلى المشاركة في المفاوضات، بحسن نيّة، للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية لتحقيق حل سلمي للصراع.
وكذلك فرضت أستراليا، منذ العام 2011، عقوبات مستقلة على سوريا، لتعكس قلقها البالغ إزاء استخدام نظام الأسد العنف "غير المقبول ضد شعبه".
ونظراً للوضع الدولي الراهن الذي يحيط بسوريا، قررت الحكومة اليابانية منذ العام 2011، تجميد أصول 15 فرداً وستة كيانات، بمن فيهم رئيس النظام، بشار الأسد، والدوائر القريبة منه، وذلك "تماشياً مع الإجراءات التي تتّخذها الدول الكبرى الأخرى، من أجل المساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام الدولي وحل القضية السورية".
كيف يتعامل نظام الأسد ومؤسساته مع الأزمة الاقتصادية؟
وعن سياسة نظام الأسد ومؤسساته في التعامل مع الأزمة، قالت الدراسة إن حكومة نظام الأسد تعتمد سياسة التقشف والتشدد في تحصيل الضرائب، فضلاً عن اتخاذ مصرف سورية المركزي قرارات تستهدف تجفيف منابع السيولة وفرض مزيد من الضرائب، بما فيها ضريبة البيوع العقارية، وأدّت هذه السياسة إلى تثبيط الاقتصاد السوري، ودفع من بقي من المستثمرين وأصحاب الأموال إلى مغادرة البلاد.
كما تبنّى نظام الأسد مفهوم السيطرة والهيمنة الاقتصاديتين على وسائل الإنتاج والريع، إذ يعمد التجار وأصحاب رؤوس الأموال وأمراء الحرب إلى الاستثمار في قطاعات ذات عوائد مادية عالية، مثل التبغ والمشروبات الكحولية وتجارة السيارات، إضافة إلى استثمارهم في الفنادق والمنتجعات السياحية.. إلخ، في حين يبتعدون عن الاستثمار في القطاعات الحيوية، مثل القطاع الطبي أو المختبرات العلمية لتطوير البحث الدوائي أو القطاع التعليمي والصناعي، في حين انهار قطاع السياحة بشكل كامل بسبب خطورة الوضع الحالي.
أما القطاعات الأخرى التي ترفد خزينة الدولة، فهي إما خارج سيطرة النظام، حيث تقع الآبار النفطية في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، وإما استحوذت عليها روسيا، ولا سيما موارد الطاقة، من خلال عقود طويلة الأجل مع النظام.
وعلى الرغم من أن سوريا بلد غني بموارده الزراعية، إلا أن افتقار المزارعين إلى الدعم الحكومي الكافي أدى إلى تراجع كبير في الإنتاج المحلي، ولا يكاد يكفي حاجة السوق المحلية.
أما بالنسبة إلى القطاع الصناعي، فإنتاجه يذهب بالكامل إلى السوق الداخلية، ما يعني أن عدد المعامل الضخم لا يُعدّ عاملاً إيجابياً بسبب اعتمادها على الضرائب من أجل تصريف منتوجاتها، ومن ثم قدرتها على الاستمرار.
وبالنظر للمعطيات السابقة، أوضحت الدراسة أن نظام الأسد عاجز فعلاً عن تأمين الحاجات الأساسية من كهرباء ومحروقات وأمن غذائي للسكان في مناطق سيطرته، علماً أن إيران تحاول سد جزء من حاجاته من الطاقة لتمكين أجهزته، القمعية خصوصاً، من الاستمرار والسيطرة.
في حين تقدّم روسيا مساهمات إغاثية على شكل حصص غذائية وكميات من القمح، إلّا أنها خفّضت كمية المساعدات المقدمة في الفترة الأخيرة نتيجة سوء الوضع الاقتصادي في روسيا نفسها بفعل العقوبات الغربية ووباء "كورونا".
وختم "المركز العربي" الدراسة بالقول إنه "على الرغم من مساعي القوى المختلفة المسيطرة على الجغرافيا السورية لضبط الأمن وتحسين الوضع الاقتصادي، إلا أن نفوذ العصابات ومافيات الحرب، التي باتت منتشرة في المناطق السورية كلها، يحول دون ذلك، فقد أدت الحرب إلى تمزيق اقتصاد البلاد وخروج قطاعات أساسية كانت تمدّ الخزينة العامة بالموارد عن سيطرة نظام الأسد.
أما العقوبات المفروضة على النظام، فلم تدفعه إلى الآن إلى تقديم تنازلات، بل زادت ظروف السوريين المعيشية سوءاً، ودفعت حكومته إلى مزيد من التسلّط على جيوب السوريين الذين باتوا يعانون ظروفاً قاسية في مجالات الحياة كلها.