كثيراً ما تمرّ علينا أخبار من قبيل: "طفل سوري لاجئ يبكي وصوت مراسل في الخلفية يقصف اللحظة بسؤال: أخبرنا ماذا فعل بك بشار الأسد؟ هل قصف بيتك؟ هل شرد عائلتك؟. ثم يستطرد بهزّة رأس: ماذا تقول لبشار؟.. عرضت المصممة البريطانية، هيلين ستوراي، ثوباً في مؤتمر "الإغاثة والتطوير" بدبي، قماشه مأخوذ من خيمة لاجئين سوريين في مخيم الزعتري بالأردن، عليه كتابات وآثار الحياة اليومية لسكان الخيام، والهدف تذكير زوار المعرض بالحرب في سوريا، ومعاناة اللاجئين السوريين في مخيمات اللجوء.. "أمل الصغيرة" دمية عملاقة تمثل طفلة سورية لاجئة تتجول في أوروبا كجزء من مبادرة فنية، ستقطع مسافة قدرها ثمانية آلاف كيلومتر دعماً للاجئين.. تقيم منظمة "سوريات عبر الحدود" معرضاً فنياً في العاصمة الأردنية، لرسامين من مخيم "الزعتري" للاجئين السوريين، برعاية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. من بين الفنانين المشاركين أطفال رسموا لوحاتهم على قماش الخِيَم، تعبيراً عن الوضع الصعب الذي يعيشه السوريون في المخيمات الحدودية.. في مبادرة ليست الأولى من نوعها، أقام المصمم الأميركي جوني دار، معرض "جينز من أجل اللاجئين"، في العاصمة البريطانية لندن، حيث جمع ما يقارب مئة سروال جينز لمشاهير عالميين، بقصد بيعها في مزاد علني يعود ريعه بالكامل لمساعدة اللاجئين القادمين من البحر المتوسط".
تظهر لك طفلة تدعى دلال تعيش في مخيمات معرة مصرين في ريف إدلب، لتقول بعينين دامعتين "الخيمة باردة كتير وبرا كلّه طين، بتمنى بس تنتهي الحرب نترك الخيمة يلّي ما حبيتها ونرجع على بيتنا".
بعيداً عن هذه الأخبار الصاخبة، التي ورغم ما تنطوي عليه من حسن نيّة، فإنها في الواقع لا تسمن ولا تغني من جوع. فثمة حقيقة مؤلمة لا يدركها كثيرون: أن تكون طفلاً سورياً لاجئاً يعني أنّ عُمراً بكامله قد مرَّ دون أن يلامس شغاف قلبك لون من ألوان البهجة، بينما أمنيات العيد الغالية تتجسد في النجاة من الموت المحتم، أو ربما بفراش دافئ، أو أقله بلقمة تسدّ وطأة الجوع الكاسر. أن تكون طفلاً سورياً يعني أن رأسك الصغير قد مُلِئ سلفاً بقهقهات القتلة وبصراخ الضحايا، وامتزجت أنفاسك برائحة الدم. رغم ذلك لا تصحّ النظرة المتعجلة إلى أطفال الخيام كضحايا مستسلمين، فهم في واقع الأمر لا يعوزهم الصمود أو القوة، ولا بدّ من الإنصات إلى أصواتهم. ومن ثم، من الضرورة بمكان فهم أوضاعهم الخاصة أولاً حتى يتسنى تقييم نوع الدعم والحماية التي ينبغي تقديمه إليهم. فلو اقتربت اليوم من أي طفلٍ سوري لاجئ تسأله عن أمنيته في العام الجديد، فستظهر لك طفلة تدعى دلال تعيش في مخيمات معرة مصرين في ريف إدلب، لتقول بعينين دامعتين "الخيمة باردة كتير وبرا كلّه طين، بتمنى بس تنتهي الحرب نترك الخيمة يلّي ما حبيتها ونرجع على بيتنا". بدورها شهد، وهي طفلة سورية لاجئة تبلغ من العمر عشر سنوات، لم تتمنَّ ألعاباً أو حلوى بل تمنّت الحصول على خيمة. حمزة أيضاً سيقول بعينين خاويتين من الفرح: "المطر يخترق سقف خيمتنا. تتسرب قطراته إلى الداخل وتوقظنا في منتصف الليل. نرتجف من البلل. والبرد يصبح شديداً، نريد في العام الجديد، فقط، حلاً لهذه المشكلة". وبين حلم التخلص من خيمة مهترئة وحلم الحصول على أخرى جديدة، تبدو أحلام الأطفال اللاجئين بحجم حبّات الدمع في أعين السوريين الذين لا حولَ لهم ولا قوة، بحجم راحات اليد قليلة الحيلة، بحجم التنهيدات المخنوقة في الحناجر المتعبة. أطفال هربوا حفاة الأقدام من سوريا إلى "بلاد الخيام المنسيّة"، وما من درب أو وطن استطاع أن يلملم خطواتهم المشرّدة المتعبة.
مع كلّ هذه المعطيات الكارثية، نجزم يقيناً أنه في حالات الحروب فقط نرى أفضل ما في البشرية، إنهم الأطفال، ولا شيء غيرهم
من يتجرأ على الإنكار أنّ القضية السورية باتت أكبر أزمة إنسانية في عصرنا، وعليه جددت الأمم المتحدة، عبر موقعها الرسمي، تحذيرها من أنّ الأطفال وحدَهم من يدفع ضريبة الحرب في سوريا. أطفال لم يعرفوا سوى الموت والنزوح والدمار، بينما يفترض بهم أن يكونوا في المدارس وحدائق الألعاب. وبالأرقام فإن 6.7 ملايين سوري تحولوا إلى لاجئين خارج البلاد، بينهم (2.5) مليون طفل يحملون لقب "الجيل الضائع"، الذي يعيش أقسى فصول الرعب والحرمان والذلّ في مخيمات اللجوء. "الشتاء قادم"، يكفي أن تقولها على سبيل المزاح لتقشعر لها أبدان الصغار الذين يقبعون في خيام أشبه بمقابر جماعية. ومن قسوة النظام السوري إلى قسوة الشتاء، يسود مشهد مأساوي في المخيمات، ويرخي كابوس الطين بثقله على كلّ شيء عندما تتأرجح أوتاد الخيم، بفعل تدفق السيول الجارفة، أو تجمّع الثلوج المتراكمة فوق القماش الممزق، مهددة مأواهم الأخير، بينما تكتفي الأسر بصفائح البوليثين في تغطية الحفر ودرء رياح الشتاء الباردة. "الخيمة" إنها الكفن الخشن الذي يلفّ الأطفال الأحياء، والكابوس الذي سيرافقهم سنوات طويلة، هم الذين يعيشون في سلسلة اغترابات مُضنية، ومقارنات قاهرة ما بين دفء المنزل وبرودة الخيام، بين ألفة الذكريات ووحشة واقع أليم مفتوح على المجهول، وعلى الموت أيضاً.
ومع كلّ هذه المعطيات الكارثية، نجزم يقيناً أنه في حالات الحروب فقط نرى أفضل ما في البشرية، إنهم الأطفال، ولا شيء غيرهم. وليس أدلّ على هذا سوى كلام ممثلة اليونيسيف في سوريا، هناء سنجر، التي أكدت أن "ثمّة أمراً إيجابياً يحدث في المخيمات. الأطفال لم ينكسروا، بل انتصروا. بذهابهم إلى المدارس يتطلعون إلى مستقبل أفضل. ومع هذه الروح، لا يمكن أن يُهزم الشعب السوري". أطفال اكتشفوا أنّ الحياة غير عادلة مذ ماتت أول طفلةٍ رضيعة تجمداً، ولم يهتز ضمير العالم، عندئذ بدا كلّ شيء غامضاً وبلا تفسير. لذا كان لا بدّ للأطفال السوريين أن يشقوا، وبأنفسهم، ابتساماتهم في طينِ الخوف والقهر والفقر ورغماً عن أنف العالم. لذا ليس من الغريب أن يصادفك خبر يخصّ فعالية من قبيل "أولمبياد الخيام"، يشارك فيها (120) طفلاً سورياً، يعيشون في مخيمات إدلب شمال غربي البلاد، لجذب انتباه المجتمع الدولي إلى وضعهم الصعب. رغم هذا ترى الأطفال سعداء وهم يرمون الرمح والقرص، ويقفزون فوق الحواجز، ويتخطون صفوف الخيام للفوز بالميدالية الذهبية. وليس من الغريب أيضاً أن ترى ثلة من الأطفال بثياب رثة وأحذية بلاستيكية مقطعة رغم البرد، يرقصون على أنغام أغنية "قصة حبّ" للمغني رامي عياش، بإحدى مخيمات البقاع، أو ترى آخرين في مخيم الزعتري يرقصون، بدورهم، على أغنية "HAPPY" للمغني "فاريل ويليامز". ولأنهم يؤمنون أنّ السعادة هي الأمنية المشتهاة في أرض البرد والنسيان، يثير هؤلاء الأطفال، وعبر هذه الفيديوهات، ابتسامات العالم الكئيب. دعونا نتفق أنّ أبناء المخيمات وحدهم يفهمون كلّ شيء، وبسياقه الصحيح تماماً، لأنهم عاشوا حياة حافلة بالأحداث التاريخية الكبرى في تلك الأمتار القليلة بين الخِيم المتهالكة. لا يكترثون للجرائم الحمقاء التي اقترفها العالم بحقهم، إنهم فقط يهدمون جدران القهر بابتسامة. وكما لن يصدق أحد، يبقون وحدهم سكاكر الأمل التي تطرّي حلق البلاد، إذ مع كلّ ضحكة طفل سوري لاجئ يتلاشى صوت الرصاص، ومع كلّ قفزة مرحٍ يهوي مجرم، ومع كلّ فتاة، متورّدة الخدين بين الثلوج، ترقص بحماسة يتهاوى قصر من قصور الطاغية المترفة الدافئة.


 في مواجهة زعيم مملكة الكبتاغون السلطانية
في مواجهة زعيم مملكة الكبتاغون السلطانية الثورةُ المضادة والارتدادات الثورية الناعمة
الثورةُ المضادة والارتدادات الثورية الناعمة غواية "حاكمات الظلّ" واستراتيجية السطوة الناعمة
غواية "حاكمات الظلّ" واستراتيجية السطوة الناعمة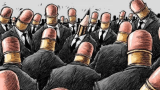 الجاهلية الأسدية والأنبياء الذين لم يُوحَ إليهم..
الجاهلية الأسدية والأنبياء الذين لم يُوحَ إليهم.. القطيعُ السوري المهاجر من وإلى فناء العدم المطلق
القطيعُ السوري المهاجر من وإلى فناء العدم المطلق