يتطابق ما يقوله الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عن أخطاء ارتكبها مع إدارته في سوريا، مع مواقف متعددة للكثير من الشخصيات العاملة في حملة جو بايدن الانتخابية وشخصيات مرشحة لتولي مناصب رسمية خلال ولايته الرئاسية. حاول أوباما تبرئة نفسه من المسؤولية التي يتحمّلها بشكل مباشر من جراء سياسته السورية والتي سمحت للنظام بسحق الثورة، وسمحت لإيران بتوسيع إطار نفوذها على أربع عواصم عربية، فيما هو كان منشغلاً بكيفية تأمين ظروف إيجابية لتوقيع الاتفاق النووي.
وبالعودة إلى أشهر ما قبل توقيع الاتفاق، كانت منطقة الشرق الأوسط تتابع عن كثب تلك المفاوضات السرية والعلنية، المباشرة وغير المباشرة، وفيما كانت طهران تفرض بشكل قاطع أن تشمل المفاوضات انتشارها الواسع في منطقة الشرق الأوسط وكيفية تحجيم نفوذها، معتبرة أن التفاوض يجب أن يقتصر فقط على الملف النووي، فيما النفوذ الإيراني يحتاج إلى مفاوضات منفصلة. كان أوباما قدّ سلّم لإيران بما تريده.
قدّم أوباما نفسه كضحية وشخصية غير مؤثرة على رأس الهرم الأميركي، عندما أشار إلى التضارب بين الأخلاق والمصالح السياسية، كما قدّم الولايات المتحدة الأميركية وكأنها جانب متلقٍ لكل تطورات الأحداث، وليس صانعها، في حين بمحطة أخرى ناقض نفسه بنفسه، سواء من خلال خياره مع الرئيس المصري السابق حسني مبارك وقدرته في الضغط عليه، أو بشأن قراراه بالتدخل العسكري في ليبيا، مؤكداً أنه هو الذي اتخذ قرار التدخل وكان له الدور الأكبر في العمليات، وليس الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أو رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.
في سوريا فقط أوباما لم يقدم على أي قرار، وفي محاولة للتعمية المتجددة، يقول إن أميركا لم تكن قادرة على التأثير هناك. بينما كانت قادرة على التأثير في العراق ومواجهة تنظيم داعش إلى جانب الحشد الشعبي العراقي الموالي لإيران، وكانت هذه أبرز ترجمات التفاهم الأميركي الإيراني وتقاطع المصالح تحت مندرجات مفاوضات النووي.
قدّم أوباما نفسه كضحية وشخصية غير مؤثرة على رأس الهرم الأميركي، عندما أشار إلى التضارب بين الأخلاق والمصالح السياسية
مما لا شك فيه أن أي كتاب مذكرات لأي مسؤول أميركي، تضيء على جوانب ونقاط مهمة في القرارات السياسية خصوصاً بما يتعلق بالسياسة الخارجية، لكن الأهم هو عدم إسقاط مسألة الحرص والحفاظ على السرية التي يلتزم بها كل المسؤولين الأميركيين، ولا يمكن إسقاط احتمال لجوء هؤلاء الرؤساء في مذكراتهم أولاً إلى تبرير مواقفهم، وثانياً إلى تغيير مجريات الأحداث، بما يتلاءم مع المصلحة الإستراتيجية للدولة العميقة، وهذا أكثر ما يتمظهر في كلامه عن انعدام التأثير الأميركي في سوريا. بينما الأصح هو أن السياسة الأميركية العميقة في المنطقة هي التي فرضت تهجير سوريا وسحق ثورتها وتغليب النظام، بما يتلاءم مع مصلحة استراتيجية أميركية إسرائيلية، مستمدة من النموذج العراقي ما بعد صدام حسين، وهذه السياسة نفسها هي التي أدت إلى ذهاب قوى أوسطية كثيرة صاغرة إلى خيارات دونالد ترامب في إبرام صفقة القرن، ولو لم يحصل ما حصل في سوريا لما تمكن ترامب من فرض الصفقة ولا فرض اتفاقيات التطبيع والسلام.
الانسحاب الأميركي من منطقة الشرق الأوسط والذي تحدث عنه دونالد ترامب أكثر من مرّة كان في صلب الحملة الانتخابية الأولى لباراك أوباما، وهذا دليل على أن المسار الإستراتيجي في دولة مثل الولايات المتحدة الأميركية لا يتغير، يعني ذلك أن الانسحاب الأميركي من مناطق الحروب اللانهائية، لن يكون بمقدور أي إدارة أميركية أن تقرر مجددا إعادة نشر الجيوش الأميركية في تلك المناطق، وبحال استكمل الانسحاب الأميركي من العراق وأفغانستان، ستكون هناك وجهة نظر أميركية واضحة بأن هذا الإرهاب بحال عاد وظهر لن يطول الأميركيين وهو بعيد جداً عنهم. فنعود إلى عنوان عريض للسياسة الأميركية بدأ مع أوباما واستكمل مع ترامب وسيستكمله بايدن وهو "أميركا أولاً".
والمقصود بالانسحابات العسكرية ليس الانكفاء الأميركي الكامل عن المنطقة، إنما سحب أكبر قدر من الجنود الأميركيين الموزعين على دول متعددة، مقابل الاكتفاء بنسبة قليلة من القوات والقدرات التي تحمي المصالح الأميركية. كما هو الحال بالنسبة إلى إرسال مدمرة B-52 إلى الخليج العربي، وهو أحد ترجمات الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأميركية، التي تتجلى بسياسات البنتاغون الذي كان رافضاً بشكل قاطع لأي شكل من أشكال الانسحاب الكامل.
يأتي جو بايدن على وقع متغيرات كثيرة على ساحة الشرق الأوسط، بعد عقوبات قاسية وضغوط استثنائية على إيران أدت إلى إضعافها، وبعد سنوات من الشقاق داخل "البيئة السنية" وتحديداً بين دول الخليج فيما بينها، وبينها وبين تركيا مثلاً
يأتي جو بايدن على وقع متغيرات كثيرة على ساحة الشرق الأوسط، بعد عقوبات قاسية وضغوط استثنائية على إيران أدت إلى إضعافها، وبعد سنوات من الشقاق داخل "البيئة السنية" وتحديداً بين دول الخليج فيما بينها، وبينها وبين تركيا مثلاً. ولكن مغادرة ترامب، ستفرض على هذه الدول العودة إلى اتفاقات سابقة، على غرار ما كان الحال أيام باراك أوباما عندما تم التوقيع بين السعودية وتركيا على معاهدات استراتيجية. قد لا تعود العلاقة إلى ما كانت عليه سابقاً، لكن الطرفين سيكونان بحاجة إلى بعضهما البعض، وذلك يتجلى في اتصال الملك سلمان بين عبد العزيز بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإنجاح قمة العشرين، وفي كلام وزير الخارجية السعودي حول البحث عن الخروج من الأزمة الخليجية مع قطر، وتحسين العلاقات مع أنقرة.
وهنا لا بد من تسجيل بعض المتغيرات التي حصلت، أولها أن تركيا خرجت كأقوى الدول من كل هذه التطورات، ترتبط بتحالف مع باكستان الدولة النووية، وأفغانستان التي أصبحت تحت وصاية باكستانية، وهذا سيؤسس إلى تحالف أكبر، يمتد من قرغيزستان إلى باكستان وأفغانستان وتركيا وأذربيجان، وهو سيمتد إلى آسيا الوسطى، يتزامن مع محاولة لرأب الصدع السنّي بين المملكة العربية السعودية وتركيا، لا سيما بعد اتصال الملك سلمان بن عبد العزيز بالرئيس التركي، بحيث تكون المعادلة بين السعودية وتركيا، كالشاطر والمشطور وإيران بينهما.
السؤال الأكبر، هو ما بعد انتهاء الصراع السوري هل سترضى باكستان وأفغانستان ببقاء ميليشيات شيعية في بلادهم؟ هذا أمر لا يمكن أن يكون مقبولاً من قبل الأفغان والباكستانيين، وهي ضربة جديدة لطهران ستكون بعد ضربة ناغورنوي قره باغ، وذلك قابل لتأسيس حالة تقلّص إيرانية في الشرق. لن تكون الولايات المتحدة الأميركية منشغلة بتفاصيل وتطورات المنطقة، حتى وإن أعلن المسؤولون الأميركيون عن سعيهم إلى تصحيح أخطاء أوباما. وذلك سيلقي كثيرا من المسؤوليات على دول المنطقة بين بعضها البعض للبحث عن توفير مصالحها أو مواجهة أي تهديدات تتعرض لها.


 طرفان استضعفا أميركا.. خصم مدّعى وحليف منبوذ
طرفان استضعفا أميركا.. خصم مدّعى وحليف منبوذ إيران ووقف الرحلات المدنية إلى سوريا.. تقويض الممرات في صراع المعابر
إيران ووقف الرحلات المدنية إلى سوريا.. تقويض الممرات في صراع المعابر إيران وترك غزة لوحدها.. الخوف من فتح جبهات أخرى
إيران وترك غزة لوحدها.. الخوف من فتح جبهات أخرى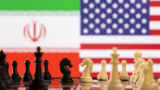 بين طهران وواشنطن.. استراتيجية تغيير الرجالات لترتيب التفاهمات
بين طهران وواشنطن.. استراتيجية تغيير الرجالات لترتيب التفاهمات