منذ أربع سنواتٍ تقريباً، كنا نعمل على رصد مشاعر الأطفال في ظلِّ الحصار، ومدى صلابتهم النفسية في مواجهة القصف والخوف والجوع، كانوا يبدون لنا غير مبالين عموماً بما يحدث، وجوه الأغلبية لا توحي بأيّ انفعال، كما أن عضلات الوجه كانت تتحرك بصعوبة عند الرغبة بالابتسام، فلا تكاد تجد ابتسامة من القلب إلا عند القلّة، وهذا الأمر مازلنا نعاني منه مع أطفال الداخل، إذ يصعب اقتناص ابتسامة ما إلا بعد مشقّة، بل إن فئة منهم لا تعرف ما هو الابتسام ولا كيف تبتسم، لأنها لم ترَ هذا الانفعال على وجوه الآخرين، فلم تجد ما تحاكيه أو تقلّده، ولم يوجد في حياة هؤلاء الصغار من يعتني بهم أو يقدم لهم رفاهية الابتسام وسط أعباء الحياة وضغوطاتها، وانشغال الأهل بمشكلاتهم وأحزانهم.
ارتبطت الابتسامة عندي بالحلم، بطريقةٍ أو بأخرى، لا أعرف ما هو الخيط الذي يصلُ بين ابتسامة ما وحلم، غير كونها تترافق مع الأشياء الجميلة والأفكار الجميلة، وحريّ بالأحلام أن تكون جميلة أيضاً، وإلا، فلماذا نعتبرها أحلاماً مثلاً ولا نعتبرها كوابيس؟
الأمر معقّد قليلاً، وازداد تعقيداً عندما سألنا أولئك الأطفال ما هي أحلامكم؟ فكانت الإجابات مبهمة، أو كان الصّمت هو الجواب الأوحد، لا شيء بالمطلق يمكن للإنسان أن يحلم به، ولا مُستقبل مُنتظر، فلو حلم بعضهم كأيّ أطفال في الدنيا في أن يكبروا ويقوموا بمهنة ما يحبونها، فالأمر صعب تخيله عند أطفال الحرب، فلا يمكن أن يحبّوا مهنة الطب وقد رأوا الطبيب بثياب ملطخة بالدماء، ورأوا الطبيب يكافح لإنقاذ حياة أحدهم، في المشافي الميدانية الكئيبة، والتي تفتقر في أغلب الأحيان للأدوات اللازمة لتخفيف الألم، مما جعل من الصعب أن تغدو الفكرة المشكّلة لدى الأطفال عن الطب أمراً محبباً، ولم تكن الهندسة أوفر حظاً، فالدمار الطاغي على كل الصور والمشاهد حولهم سرق منهم صورة البناء، بات الهدم هو الشائع، وباتت المباني المدمّرة أمراً معقولاً ومستساغاً حتى اللحظة، بل إن فئة كبيرة من الأطفال مازالت تسكن البيوت نصف المدمرة وتبيت تحت أسقف آيلة للانهيار، فأي تصور عن الهندسة قد يتشكّل أكثر من سد فجوة ما في جدار لئلا يتسرب منها البرد والمطر؟
فالأمر صعب تخيله عند أطفال الحرب، فلا يمكن أن يحبّوا مهنة الطب وقد رأوا الطبيب بثياب ملطخة بالدماء، ورأوا الطبيب يكافح لإنقاذ حياة أحدهم، في المشافي الميدانية الكئيبة، والتي تفتقر في أغلب الأحيان للأدوات اللازمة لتخفيف الألم
وإن فكر الطفل في مهنة كالتدريس فهو لم يرَ معلميه كفاية ليتأثّر بهم، ولم يتعامل مع المدرسة إلا ضمن زيارات خاطفة ما بين القصف والقصف، حتى وإن فكر بالمهن اليدوية أو الحِرف فهو ويا للأسف لم يرَها لعدم توفّر الأدوات اللازمة لذلك، فضلاً عن إمكانية الحلم بأشياء قد تبدو سخيفة ومتوفرة بكثرة في كل مكان في العالم كالحدائق أو الحلوى.
دمّر النظام أحلام الصّغار كما دمّر أحلام الكبار، ولم يستطع أحد ترقيع تلك الأحلام بشكل من الأشكال بل تشوهت أكثر، فتحول البيت إلى خيمة، وبقايا الألعاب العادية القديمة استبدلت بسيارات مصنوعة من أغطية البلاستيك وعلب التونة، وأما الدمى فهي عبارة عن رقع قماشية يمكن احتضانها في الليالي القاسية!
فالحلم مرتكز بشكل أساسي على الماضي ومكوناته وأشخاصه وأحداثه، وإعادة الحلم بتفاصيله أمرٌ مستحيل، فالأقارب تفرقوا بين قارّات العالم، واختفى قبل ذلك جزءٌ منهم في السّجون
مُسخت الأحلام أكثر، وباتت الحوارات مع الصغار مقتضبة ومختصرة أكثر، وإن تجرأ بعضهم اليوم وتخطوا حاجز الخجل والخوف وتحدثوا، فإن أحلامهم الوحيدة التي يتحدثون عنها تقتصر على أمر واحد مستحيل، هو العودة إلى الماضي، من المخيّم المقيت إلى البيت القديم المحاط بحقل الرمان ذي المذاق اللذيذ والذي أصبح اليوم محتلاً من عصابات الأسد، ولعل أكبر حلم يراود هؤلاء الصغار هو المغادرة من الخيمة الباردة الخالية من الأحبة، إلى البيت القديم في المدينة أو القرية التي هجّروا منها، البيت الذي له نوافذ وجدران، وفيه جد وجدة وأقارب وجيران، هناك حيث يأمن القلب وتكتمل السعادة باجتماع الأشخاص الذين صنعوها، فالحلم مرتكز بشكل أساسي على الماضي ومكوناته وأشخاصه وأحداثه، وإعادة الحلم بتفاصيله أمرٌ مستحيل، فالأقارب تفرقوا بين قارّات العالم، واختفى قبل ذلك جزءٌ منهم في السّجون، كما شهد الأطفال أنفسهم مشهد رحيل جزء من أحبتهم عن الحياة بسبب القصف أو الوفاة بسبب عدم توفر المشافي أو الدواء، حتى البيوت سوي معظمها بالأرض وباتت النوافذ مجرد فراغات واسعة ومتاحة لعبور الشمس والعصافير والبرد، فالحلم بات تحقيقه محالاً، وإعادة ترميمه أقرب للمعجزة، وأما تحويل عملية التفكير من سجن الماضي إلى بوابة المستقبل فهي الأصعب على الإطلاق، لأنها تمرّ بعوائق نفسية ومادية هائلة، كما أنها لن تتوازن ما لم تستند بشكل أو بآخر إلى بقايا الأسرة، وبقايا المجتمع.
إن من أهم الأسباب لثورتنا هو أن نحمي المستقبل، وأن نجعله أقل بؤساً، ولذلك فنحن مسؤولون أيضاً على أحلام الصّغار، وواجبنا الكفاح لحمايتها ورعايتها لتكون أحلاماً سعيدة مشرقة، لابد من أن يفكر كل سوري ملياً، إلى أي شيء آلت أحلام صغاره، وأن يعمل بكل ما يملك ليسترد ما تبقى منها في ذاكرتهم ويحولها إلى واقع، ولابد من ترميم أحلام ممزقة، وصناعة أخرى بروح جديدة ورؤية متفائلة، فإن استطاع امتلاك حلم متوج بابتسامة، سيمتلك إرادة امتلاكه، وسيقوم بكل ما يستطيع لتحقيقه، وقد تكون الأحلام متواضعة جداً، أو مبالغاً بها كثيراً، وهذا لا يهم، فالقدرة على التعديل والتغيير ستنمو أكثر، سيحب الحياة عندما يحبّ الحلم، وسيمتلك القدرة على المواجهة والتحدي لأجل الحلم، سينمو حرّاً كريماً سويّاً وإن كان نموه في بيئة ذات قدرات شحيحة، سيقوى مع الأيام ويغدو الحلم حقيقة.


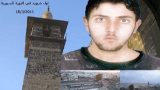 محمود الجوابرة – أول شهداء ثورة الكرامة
محمود الجوابرة – أول شهداء ثورة الكرامة خطيب الضمائر.. حمزة الخطيب
خطيب الضمائر.. حمزة الخطيب المظاهرات النسائية في حمص
المظاهرات النسائية في حمص بوابة الله كل ما ينتظره السوريون في الأضحى
بوابة الله كل ما ينتظره السوريون في الأضحى عن السياسة والقهوة
عن السياسة والقهوة